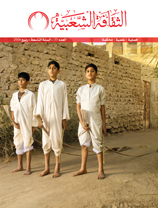القيمة الجمالية والأبعاد الدلالية للنسيج
العدد 63 - ثقافة مادية

تمهيد:
يمارس النسيج فعله الإغوائيّ من خلال أنساق حياكة متنوّعة، تقوم على محاولة خرق البناء التقليدي المهيمن منذ سنوات طويلة، و تأتي هذه الرغبة ردة فعل على فوضى الثقافة وأنساقها، وهيمنة بعض الأنساق، وتهميش صناعة المرأة ومنها الحياكة والنسيج وعدم تصنيفهما ضمن الفنون، بل في الغالب كانت منجزات المرأة الفنيّة تعتبر وظائف منزلية لا ترتقي إلى المستوى الفني أو الجمالي الذي ينتجه الرجل. تسعى المرأة الناسجة جاهدة لإيجاد طريقة تعبير مغايرة تمكنها من خلق نمط خاص بها على غرار الفنون التشكيلية. إلاّ أنّ جلّ المحاولات بقيت مقتصرة على مجهودات فرديّة، تختلف باختلاف مرجعيات صاحباتها. كما أنّ النسيج لا يلقى اهتماما إلاّ لكونه نسيجاً فيه عبق التاريخ أو تقليد لمرجعية مجهولة الهوية، خاصّةً وأنّ ربط النسيج بالصناعات التقليدية يعني نفي التجديد والتطوّر الذي من المأمول أن تحققه المنسوجات عبر التاريخ. هذه الرؤية التي تصادر النسيج جعلتنا نميل لقراءته نصّاً سردياً ملحميّاً كتبته المرأة الناسجة بألوان ورموز خاصة بها1.
وليس الهدف من هذه القراءة إعادة وصف للكون الممثّل نسيجاً ونقشاً و لوناً في المنسوجات بوصفه نصّ سيرة ذاتية، ولن تكون غايتنا الكشف عن معنى جاهز كوجه تجريدي لعالم مشخّص. إنّنا نطمح فقط إلى تتبع الآثار التي تتركها الذات الناسجة التي يفيض عنها النسيج في فعل الحياكة باعتباره حدثاً سرديّاً، تركيبا ودلالة وصياغات للأوضاع التي تشكّل معقولية هذا المنسوج ومشروعيّته.
في ضوء هذه المبادئ العامة، نحاول قراءة النسيج باعتباره سرداً للجسد الإنسانيّ في أوضاعه وحالاته المتنوّعة: لحظة استمتاعه ولحظة توقّده ولحظة ثورته على فعل يمتصّ مجموع انفعالاته.
إنّ النسيج موضوعاً للقصّ، وموضوعاً للوصف وموضوعاً للاستذكار، يخلق لنفسه تركيباً خاصّا لا يدرك إلاّ في علاقته بما يتولّد عن ذات الناسجة من أمل وألم، حيث يصبح للنقوش والرموز دلالات ومعان. وهذا ما نجده في المنسوجات اليدوية النسويّة حيث تتخلّى اللّغة عن تركيبها العادي كي تنخرط في عالم رمزي فالت من عقال الرقابة المشدّدة فتتزيّا بتركيب يخلط بين الرمزيّ والدلاليّ، لتُقرأ المنسوجات انطلاقا من الشروط التي تقدمها الناسجة.
فحركة النسيج تبني نفسها انطلاقاً من عالم الناسجة، تلك المرأة التي تعيش على وقع أجساد المنسوجات وما تحويه من كلمات تخطها المرأة. ويتعلّق الأمر هنا بالسنن الذي يحكم المخيال النسويّ ويحدّد طريقة إنتاجه للمعنى. فمن خلال هذا السنن يبدو الجسد عنصراَ ضمن نسق رمزيّ تُكثف داخله مجموع الاستيهامات التي ولدتها ذكورة قدمت -ولازالت تقدّم نفسها- على أنّها منبع التاريخ ومنتهاه. فكلّ شيء يمرّ عبر وعي مركزيّ يشتغل بوصفه مصفاة ثقافيّة تتحكّم في كلّ المعطيات التي ستوصف في المنسوجات وتحدّد آفاقها. إنّ الوعي المعرفي الكليّ الذي يتحكّم في المنسوجات ينساب من عين أنثى تقيس الأشياء والأوضاع انطلاقاً من قوانين عالمها الخاصّ.
من هذه الزاوية، تتبدى معالم الوقع الإيديولوجي، ومن خلال فعل النسيج وفعل الحياكة، وكذلك من خلال التركيب الخاصّ بالنقوش والرموز يمكن الكشف عن لاشعور نصيّ يختفي في العناصر المؤسسة للنسيج (الرموز والنقوش والألوان)، وكلّ طموحنا هو الوصول، عبر هذا المنظور إلى تحديد الصـورة الـكـليّة التي يظهر من خـلالها المنسوج، و دلالات الخطاب النسوي باعتباره نصّاً منسوجاً بلغة مشفرة في المقـام الأول.
الحياكة فعل كتابة:
من خلال ما تقدّم يمكن اعتبار الحياكة فعل كتابة «في معناها المادي وفي معناها التخييلي، الرابط الذي سيسمح لنا بإبراز أهم الإشكاليات التي تثيرها مختلف العلائق الممكنة بين الحياكة والألم كما هو الأمر بين الكتابة والألم. ذلك إنّ المأساة بوصفها محرضاً للإبداع هي بمثابة «ألم» فهي تعني لغة الوجع»2. وبالنظر إلى موضوع فعل الحياكة، يمكن القول إنّ فعالية المقاربة النفسانية لا تتجلى فقط في كونها تكشف الأمراض والعقد والجراحات، بل هي تتجلى في «كونها مقاربة لا تتعرّف على مريضها إلا من خلال محكيه الخاص، من خلال أسلوبه ولفظه الفريدين، من خلال ما يصاحب هذا أو ذاك من إيقاع وتقطيع وتنغيم وانفعال... وألم»3. فالحياكة فعل ماديّ ملموس، ولكنّه الفعل الذي يؤدّي إضافة إلى هذه الوظيفة الماديّة الأصليّة، وظيفة أخرى رمزية، إذ يمكن التساؤل: ما هي الحاجة الرمزيّة التي لا يمكن أن يسدها القلم؟ ولأنّ هذا الفعل يقع على الخيوط البيضاء4، ألا تتألّم ألماً مضاعفاً بسبب من ذلك: مرّة لأنّ هناك عنصراً خارجيّاً، يخدش جسدها ويستبيحه، و«خلالة» تدق بعنف الفعل سطورا لتنسيقها وترتيبها. ومرّة لأنّ هناك ألوناً متعدّدة تلوّث بياضها الصافي الطاهر؟ ألاّ يتعلّق الأمر هنا بــلذّة لاشعورية تتعلّق بوظائف وقيم رمزية: فعل الحياكة مثل فضّ بكارة جسد أبيض بكر.
ما طبيعة العلاقات التي تقوم بين الناسجة ورطابها الذي يشبه القلم5. وما دامت المرأة تلجأ لمثل هذه الأدوات للتعبير حياكة ونسيجا، فإنّ أفكارها المرسلة رموزا تعتمد على هذه الأدوات لتفلت من عقال المراقبة التي تحظر عليها فعل التعبير كلاماً، بمعنى آخر، المرأة باستعمالها الرطاب الشبيه بالقلم والخلالة التي تضرب بها خيوط الصوف الملونة لتتماسك، تعبّر عن نفسها باستعمالها أدواتها الخاصّة، التي تعلن عبرها عن وجودها وتبثّ أحاسيسها فتصنع عالما خاصاً لا يمكن ولُوجه بيسر وسهولة.
هل يتعلّق الأمر بلذة جنسية6؟ قد يكون ذلك صحيحاً من منظور طريقة الحياكة في جانب من جوانب النسيج والحركات المعتمدة حسب طريقة التقارب حينا والتلاحم أحيانا بين المرأة الناسجة والنول والنص المنسوج، لكن من منظور موضوع الفعل، أي الورقة الخيوط البيضاء، فهذا الفعل الجنسي اغتصاب لجسد بكر، اغتصاب يسبب الكثير من الألم7. فالجسد في بعده الإيروسي هو البؤرة التي تتجلّى فيها وعبرها الذوات والأشياء التي تكوّن عالم النص المنسوج. إنّه الشكل الذي تنطلق منه وتلتقي عنده كلّ الأشكال، وهو أيضاً وأساساً الشكل القار القابل لاستيعاب سلسلة من الأفعال والأوصاف التي تحيل، بهذا الشكلّ أو ذاك، على قيم هي الأساس الذي تقوم عليه ممكنات الكون الدلالي وسبل تحققه.
فالجسد حاضر في كل شيء: «إنه حاضر في الرسوم والنقوش وفي الكلمات وفي الصور والرموز والإشارات وفي الأحلام والأخلاق والسلطة. كل شيء يدور حول الجسد، ولا شيء يوجد خارج ما تثيره الكلمات والأوضاع، أو ترسمه الأفعال من صور «للذة» لا تنتهي عند نقطة بعينها»8. فالحياكة النسوية لا تنتهي لأنّها تستعصي على الضبط المسبق، فهي لا تبني نفسها انطلاقاً من تصوّرات مسبقة قد لا تقود -بشكل آلي- إلى نهاية بعينها، إلاّ أنّها، على الأقلّ، ترسم خطوط مسار سرديّ ودلاليّ أيضاً، قابل لأن يُستوعب وينصهر في نقطة ما، يمكن اعتبارها نهاية. إنّ وقائع المنسوجات، على العكس من ذلك، تخرج من دائرة الكتابة السردية المتداولة بين الناس، وتفلت من نظام اللّغة العاديّة لتصنع لنفسها قانوناً لغويّاً خاصّاً بها في عالم من الرموز والألوان والنقوش لتُشكّل خطابا مشفراً تكتبه المرأة بعد أن فقدت أمل التواصل مع المجتمع الذكوريّ. فالنسيج خطاب الحيل والمراوغة وعدم الاستسلام، بل ربّما منه هو ومن خصائصه وأساليبه المتعدّدة اكتشفت شهرزاد طرائق الكلام وأساليب القصص لتفلت وتنجّي بنات جنسها من التنكيل والتقتيل. وهكذا، فإنّ كلّ المنسوجات قد تشكّل منطلقاً لحكايات جديدة مختلفة عن تلك التي سبقتها في المنسوجات السابقة. فالألوان، هي «ربيع وخريف» في القصص وربيع وخريف في العمر وكذلك في السرد؛ إنّها انتكاسة للسرد وجنوحه إلى الخروج من دائرة المباشرة وولوج عالم الرمز.
من هنا كان الجسد موضوعا للحياكة ومصدراً للسرد، وموضوعا للوصف وموضوعا للّغة، فمنه تخلق لنفسها تركيبا جديدا لا يدرك إلاّ في علاقته بما يتولّد عن هذا الجسد. الذي يتحوّل أثناء فعل الحياكة ببلاغته تلك، «إلى جسد متخيّل، تمتلكه الذاكرة الإنسانيّة واللّغة والرغبة، وتستحضره المخيلة لتعيش فيه باستمرار استيهاماتها الشهوانية والجمالية. إنّه جسد من خلق مخيلة السارد الواصف له. يمنحه من توقعاته وحساسيته كلّ ما ينقصه من الاكتمال والتعالي. وهو صورة أيضا، لأنّه جسد يتمّ تجريده في الكثير من الأحيان من خصائصه الظاهرية، وعزله عن محيطه و إعادة تركيبه في متخيّل اللّغة وفق منظور يسلب منه طابعه الوجودي»9. تبدو الخيوط البيضاء فائضة بالإيحاءات والدلالات عندما تتحوّل من شيء ماديّ إلى حامل لشيء رمزيّ. يمكن اعتبار الخيوط البيضاء تلك المساحة من الجلد اللبني للثدي المغذي الذي يعتبر عند الإنسان أول مدرك حسيّاً. وهذا ما يعني أنّ الخيوط البيضاء الممتدة بين خشبتين عموديتين (المتمثلة في السدأة «النول») هي ذلك الثدي العزيز اللذيذ الذي كان الانفصال عنه مؤلماً، كأنّ الخيوط البيضاء تسمح لنا بعودة رمزية إلى ذلك الفضاء اللبني المفتقد.
الخيوط البيضاء في السدأة (النول) بمثابة استعارية، توجدها وتستبقيها الكتابة، تحيل إلى تجريد، إلى «شيء» محيّر، لأنّه في وقت واحد مجرد ومحسوس مباشر، مضمر وحاضر. البياض هو فراغ. «لا شيء» هو شيء ما، على طريقة الصفر، أوّل الأعداد، الذي يلزم سلسلة (مجموعة) العدّ. وللبياض أساس فيزيولوجي: التوقّف، الوقف الذي يسمح باستعادة النفس ويوقّع اللّفظ والانتظار والصمت. عندما نتكلّم، نسمع البياض الذي يفصل الكلمات دون رؤية؛ ونصغي إلى البياض الذي ينهي الجمل. فيما نرى جميع هذه البياضات على الورقة. يوجد «بياض» عند وجود انقطاع أو توقف النبرة أو تعليق الكلام. ألا توجد «بياضات فوقية»؟ (صيغة شبيهة بعلامة فوقيّة). إنّ الفصاحة والمسرحة والبلاغة تدخل «بياضات فوقية» في القول. فعلى الصفحة المطبوعة، على الصفحة الإعلانية مثلاً، يتكلّم الشاطئ الأبيض (أو الملون). وله فصاحته. ومخرجو الكتب يحسنون استخدام البياضات الفوقية لزيادة قيمة الصور والنصوص.
لا يوجد تمفصل دون بياض. يقوم البياض بدور ضمني بين الحروف. فهو يفصل ملامح الوحدات الصوتية الملائمة. وهو ضروري بين الكلمات (الوحدات الدلالية الأولية). ودوره يتأكد. وغيابه الذي يسمح للعناصر الصرفية (الوحدات الشكلية) بالانضمام إلى الوحدات الدالة (الوحدات المعجمية) لا يقلّ أهميّة عن حضوره. وللبياضات وظيفة بين الجمل وكذلك وظيفة للدلالة على الانفكاك. «عندما ينفصل الدال على المدلول، وحينما تكتمل الجانبية (القيمة) الحرفيّة (الدلالة) يدخل بياض خفي يمكن أن يسمى «هامشيا». ويدلّ عليه تغيّر في مقام الصوت، أو أية ثغرة مدركة في الاطراد»10.
وإذا كانت هذه الدراسة التحليلية للخطاب النسوي في النسيج تهتم بالمرأة التي تنسج الأشكال والرموز والإشارات، هي في واقع الأمر مغامرة رمنا من ورائها السعي إلى الكشف عن أوجاع المرأة الناسجة وآلامها11. في النسيج تعبّر المرأة بمنطوق منسوج برموز لها ترتيبها الخاص الذي لا يرتد إلى الترتيب الصرفي ولا إلى الترتيب المنطقي، فالقول في النسيج ينتظم وفق منطق خاص بالنص المنسوج. ذلك أنّ القول في النسيج له صلة بالأسلوب الذي قد لا يتطابق مع أسلوب غيرها من النساء. ومع أن الأعمال المنسوجة من النسوة المهمشات تتكوّن بشكلّ متقارب إن لم نقل شكلا واحداً، مع أنه ينضم على هذا المستوى إلى المحتوى وأنّ الخطاب كلام تعني صاحبته به ما تقوله، كما يحمل المعنى مشاعر وأحاسيس.
فألوان المنسوجات ونقوشها هي التي تجعل منها فناً متميزاً، وتجعل فهمها عملاً عميقاً على صعيد الفكر والروح معاً، فتساهم بذلك في بناء الإنسان، فالمنسوجات لا تجذب الاهتمام لكونها تتكون من عناصر فنية تتشكّل من نقوش قد تبدو للوهلة الأولى شبيهة بالنقوش القديمة ولا لكونها مزدانة بعناصر طبيعيّة أو تاريخيّة أو اجتماعيّة أو فنيّة فقط، هناك شيء آخر إضافي يجعل من المنسوجات عن طريق عبقرية المرأة واللّغة الخاصّة بها وبواسطة الرموز وحسن الترتيب اللوني والتناسق الجمالي - شيئاً قائماً بحدّ ذاته بوصفه عملاً فنيّا متميّزاً ننظر إليه ونتأمّله ونتعلّق به ونتغنى به روحاً وفكراً، ويصبح في النهاية جزءاً منا12. لكن، ما يلفت الانتباه في المنسوجات اليدويّة أنّها قد لا تركز على الأجواء الحزينة، كما لا تغلب عليها السوداوية المنتظرة في مثل هذه الحالة. بل النقيض تماماً هو المسلك الذي ستسلكه المنسوجات: لقد اختارت الناسجة (الساردة عبر الحياكة) أن تمارس عملاً داخل النفس المتألمة لإثبات الوجود وتحدّي كلّ العوائق المعترضة لكيان المرأة، فالألوان توحي في مفاصل عديدة من المنسوجات لرفع المعنويات ونسيان الألم والإحباط والاكتئاب، والنسيج بوصفه عملاً فنيّاً يمكن أن نطلق عليه تسمية عمل إثبات الذات، وهو عمل خلية النحل، لأنه في أحيان عديدة تقوم بعض النسوة بنسيج جماعي وكلّهن يحملن رؤى جمالية منبعثة من ذواتهن. واللاّفت، أنهن لا يختلفن في الألوان بل ينسجمن دون اتّفاق مسبق، المهم أن تحسن المرأة الناسجة التعامل مع أدواتها المخصّصة للنسيج. فبعد فقدان موضوع الحب (الاحترام)، تختار الذات المتألمة، المحبطة، الاشتغال على الحياكة وإنجاز عمل تقوم من خلاله الذات الساردة (المرأة الناسجة) باستحضار كل الذكريات والأصوات واللّغات التي تربطها بموضوع كلّ ما هو مفقود في حياتها. وهذا الاستحضار هو في العمق عمل من أجل إعادة تثبيت المعنى الحقيقيّ لمفهوم الحياة والإنسانيّة والإنسان.
في المنسوجات كأننا بالآلام تتحوّل إلى حوافز تدفع الناسجة إلى تعزيز الثقة بالذات ومقاومة خطر الإبادة المنهجية التي ستتعرض لها المرأة إن لم تكتشف طريقة تعبير وإعلان الوجود، هذا هو همها في المرحلة الأولى وهو أكثر أهمية، ربّما لأنّه يتعلّق بما تبقى من إمكانية استمرار الحياة عندها وما يمكنّها من وجودها الفعّال. لهذا تعمل الذات الناسجة كل شيء من أجل ألا تنمحي تلك الذاكرة، ذاكرة الأيام، تأريخ لذاكرة موشومة بكل أنواع العذابات والقهر التي لا يمكن أن يغفرها الإنسان عندما يعرف القيمة الفنية للنسيج ولخطابه المليء بالدلالات الحاملة لكلام لم يتسن لها أن تقوله في العلن، فلجأت إلى الرموز دون أن تتخلى عن حقها في القول الذي لا يخرج عن قيم المجتمع، بل وأحاسيس الناس فيه ولا ينفي إنسانيّة الإنسان فيها. ومثل هذه المنسوجات بما يسرده خطابها وبما يذكره من أحداث لا تستدعي فقط استرجاع الذكريات بلغة سرديّة جافّة، بل كثيرا ما تفرض لغة (الناسجة) المرأة العارفة بكل تفاصيل الجغرافيا السرية لمجتمعها، كما أنّها تترجم طبيعة العلاقة بالأب والأخ والزوج والعم والخال والابن. وحدها المرأة (الناسجة) القادرة على تقدير حجم الخسارة التي تعرّضت لها في مجتمع ذكوري لم يرحمها. فالمرأة تنسج مصيرها، وهي وحدها القادرة على إعادة بناء تلك الأجزاء الأُخرى من ذاكرة المجتمع. يمكن اعتبار هذه المنسوجات صرخة لإنسانة تتألّم من فقدانها إنسانيتها، لكنّها بدل أن تأخذنا إلى أجواء الحزن، تدعونا إلى ممارسة التمتّع بالألوان التي ترمز لجمالية الحياة، حتى تساعدنا على نسيان الأوجاع المؤلمة التي تسم تاريخ البشرية منذ آدم. وهذا يُبرز أن المرأة الناسجة كائن متسامح يجعلنا نتحاشى ما يؤلم النفس، ويستحضر الطفولة والذكريات المليئة بالحياة والحب.
ذلك أنّ المنسوجات عمل فنّي لا يمكن أن يقوم على صدق المحاكاة أو تمام المطابقة فحسب، كما أنّه لا يمكن أن يوصف بالجمال إذا كانت كل ميزته هي تمام المحاكاة للطبيعة. إنّها في الواقع تركيب فنّي معادل للمشكلة الاجتماعية أو السياسية أو غيرهما من المشكلات التي تعالجها، أو هي – بعبارة أخرى – إعادة تشكيل لمادتها الأولى التي يعالجها. وهذا التشكيل المعاد يوازي – ولا يعكس- المادة الأولى التي تعالجها،الموازاة تقتضي المغايرة بطبيعة الحال، ويترتب على هذا أن المنسوجات باعتبارها عملاً فنيّاً، كيان قديم متجدّد مستقلّ عن موضوعه، وهذا الكيان المتجدّد بتجدّد ظروفه هو رؤية المرأة الناسجة الخاصّة للموضوع الذي تعالجه، ولا يتمّ تشكيل هذا المنسوج إلا بوسائل فنّية معيّنة تأتي النقوش والرموز على رأسها.
في النسيج المنجز بفعل الحياكة يكون الشكل بما هو كذلك متعالياً. ففي لغة المنسوجات لا يوجد أي معنى ليس متضمناً على نحوٍّ صريح في الرسالة المرسلة وإن كانت مشفرة، وكلّ اختلاف في المعنى يطابقه بالضرورة اختلاف بالشكل، في مكان ما من القطعة المنسوجة والتي تتوجّه بخطاب محدّد لأشخاص تشير إليهم الناسجة ولا تسميهم. فرسالتها مكتوبة بنوع خاصّ من الكتابة وبلغة خاصّة وبأسلوب لا يمكن أن يتمكّن من إبداعه إلا العارفات بمعنى الألم وما ميلها لاستعمال الرموز إلا لكي يوصل معاني خطابها المنسوج وفق بناء دلالي خاص، لا بدّ له من انتظام ما وبطريقة ما، تعرف أسرارها ناسجة الخطاب وساردة الأحداث. المهم في مرسلتها القول ينتظم، والجمل في غاية التنسيق، والأحداث متعاقبة، وحضور الألوان ودقّة الجمالية والتناظر محسوس لمن يفهمون ويدركون معاني الألوان وتركيبها. فلا بياض عفوي في المنسوجات ولا لون بلا وظيفة دالة على معانيه13. القول في المنسوجات له أقسام، يؤلّف حسب المحاور التي تحمل خطابا ولا تفصح عنه، تنعت الأشخاص بصفاتهم ولا تسميهم، وكل ما يعني القول وما يدور في أعماق (الناسجة- الساردة) يخضع لبعض القواعد المنبثقة من عوالم المرأة العارفة بطبائع الأشياء الكبيرة منها والصغيرة.
فعل الحياكة والنسيج والرقم، له صلة بالأسلوب، بل بالأساليب لأنها لا تتطابق على أسلوب واحد. بل تتنوّع بتنوّع الحالات النفسيّة التي تمرّ بها الناسجة التي تحكي لتقودنا إلى مغزى الحكاية أو الحكايات. فنحن عندما نتأمل المنسوجات لا نهجر الشكل، رغم تنوّعه وتعدّده، مع أنّه شكل متنوّع ومتعدّد المستويات يرتقي بنا بشكل تدريجي إلى مستويات المتعة أثناء المشاهدة، فنتيه في عوالمه وتسحرنا ألوانه، فنهمل محتوياته، فتتحوّل الألوان والأشكال المتناظرة من رموز وإشارات إلى معنى محسوس. إنّ عالم النسيج ليس غريباً عن عالم الموسيقى، فالجمل الموسيقية تتميّز بألوانها وبأنغامها، ويوجد فيها قواعد صارمة للتأليف الموسيقي تنظّم تقطيعات الجمل وتعاقباتها. فالنسيج يستخدم المنحنيات اللونية الشبيهة بالمنحنيات اللّحنية والتساوقات وترابط الأنغام والرنات الخاصّة.
النسيج والخطاب المشفر:
عند تأملنا للأعمال المنسوجة من قبل امرأة لا تحسن القراءة والكتابة، بإمكاننا أن نقف عند أمرين هامين من خصائص المكتوب واللّغة وتفاعل القارئ الناظر معهما:
أولاً: إنَّ النسيج يخضع إلى بناء لغويّ يخبر عن ذاته، ويستدعي شهوده ليسرد نفسه على ألسنتهم. وقد تكون حاجته إلى ذلك هي حاجة فاعل أحدث حدثاً، فهو يتطلّب وجود أمناء يشهدون على سياقاته وملابساته. ولكي يكون هذا الأمر ممكناً يلجأ النسيج بوصفه نصّاً إلى استراتيجيات اللّغة المشفرة ونظمها، فتحيل ما فيه من أحداث وأشخاص، وأحلام، وآلام، وأماكن، إلى كائنات لغوية أو كلاميّة.
والقارئ شاهد هنا- إذ يتعامل مع النسيج بوصفه نصّاً، من خلال كينونته اللغوية، يرى فيها ميداناً لنُظم ثقافية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتاريخية، وعلمية، وفلسفية، ودينية متداخلة. فيقرأها على أنها وقائع نصيّة مرجعها لغة مشفّرة تعطيها معانيها الخاصّة داخل النصّ وليس خارجه، ويجعلها جزءاً من إمكان كتابي لا يتناهى.
فالرسومات الموجودة في السجادة التونسية مثل اليد (الخمسة) والعين والقمر والكواكب، والنجوم ليست أشياء مجردة بلا معنى، بل هي الحنان والرقة والأنيس والرفيق والألم الموجع والحب الدفين الصاخب والجسد والملمس، يلمس بالعين إن كانت من الحبيب فهي عين الرأفة والرقة، والحنان. وإن كانت من العدو فهي عين حاسد تتمنى لها المرأة الناسجة العمى، كما يمكن أن تكون العين الخائفة الخائبة المنكسرة أو المتحدية الباحثة عن لحظة انفلات من الرقابة. والقمر ليس كوكبا في السماء بل يحمل في ما يحمل من دلالاته، الحبيب الجميل والسهر والخلوة والمداعبة ولحظة الطيش بين أحضان الحبيب، كما يرمز للخيال وللحظة رومانسية تنتظرها المرأة الناسجة قد تأتي وقد لا تأتي. والأمر نفسه بالنسبة للشمس فهي ليست شمس السماء الساطعة، إنها شمس تنتظر الناسجة بروزها علّها ترى النور في يوم ما أو ربما هي الحياة والنور بعد العتمة في ليل طويل ورأب الصدع بعد انكسارات ومرارة، إنها نظرة المرأة المزارعة في الحقل في النهار والناسجة في الليل وآخر النهار، عباراتها وأمانيها، وآمالها هي.
إنّ النسيج إحساس ومشاعر تعكسها المرأة بخيوط متموّجة، بألوان متداخلة، يصاب قارئ نصها باندهاش لحسن توظيف الألوان والتدرج بها، حيث تنجح المرأة الناسجة –على الرغم من أميتها وعفويتها- في توظيف عالم لونيّ لم يصل إليه عتاة التشكيليين إلاّ بعد دراسات عديدة ومراجعات وتجارب (بروفات) على لوحاتهم ! إنّها موسيقى الحياة، ترسمها المرأة بنبضها وعقلها الباطني؛ إنّه الكلام الذي تبرح به المرأة نظر المجتمع الذكوري المتسلط، الظالم، بكلّ قسوة الصمت، بعفوية المرأة التي لا تفكر في شيء سوى في عالمها هي، وكيف تتصوّره بلا سجونها الثلاثة: «سجن المجتمع، سجن الأسرة، سجن الجسد» وسجون أخرى تتقاسمها مع جلادها الذكر...؟
إنّ اعتماد النسيج بوصفه نصّاً منسوجاً على استراتيجيات اللّغة ونظمها في تحويل ما يتضمن إلى كائنات كلامية، وقراءة القارئ(المتلقي) للنُظم الأخرى على أنّها وقائع نصيّة مرجعها لغة غير مفهومة، بل غير متداولة ليعطي لما يتضمنه النص المنسوج مرجعيته الخاصة التي يدلّ بها على نفسه لا على غيره. ذلك أن الكلام دليل على ما يتضمن وليس دليلا يأخذ مصداقيته من مرجعية تقع خارجه.
إنّ الوقوف على هذا الأمر يعني تحرّر المنسوج من كل سلطة خارجة عنه، تريد أن تمارس الإملاء فيه، بما في ذلك سلطة الناسجة، وسلطة الإيديولوجيا، وسلطة العلم. كما يعني المكتوب –بالنسيج- من هذا المنظور، فاعلا يبرز ذاته وفق مقتضيات سياقية يخلقها، وأنّ كلّ ما يأتي بعده، إنّما هي مفاعيل رمزية يضمّنها في هذا الجنس أو ذاك، ويسجلها فيه14. لذا، كان العلم بالمنسوج هو علم بمواقعه في النفس أولاً، ثمّ هو علم بمواقعه في النسخ ثانياً. ولولا القراءة لمواقع المكتوب في النسيج، لما استنسخ كاتب من مكتوبه شيئاً.
وإزاء كل هذا، فقد صار من غير الممكن في زمن تطوّرت فيه المناهج الأدبية واختلفت المدارس الفكرية أن نرى مفاعيل النصّ المنسوج بأنّها علل تفسّر المكتوب وتقول سبب وجوده، وذلك كما يفعل التفسير السلطوي، والنفسي الإسقاطي، والاجتماعي، واللفظي، والإيديولوجي. فالمنسوجات في تشكّلها يجعلها معلولة لعلل أخرى يبتدعها ويكشف نظامه عنها، بينما يبقى هو علة ذاته، أي «لغة تبني نفسها»، وتتخذّ من القارئ شاهداً عليها.
من خلال ما تقدّم، نرى أنّ حريّة النصّ المنسوج تكمن في بناء نفسه ملازمة لحريّة القارئ في إنتاج ما يرصد. وذلك لأنّ إدراكه ينتج الظاهرة المرصودة ويعددها»15، تماماً مثلما ينتج النص المنسوج في بنائه لنفسه الكم الذي يستنفره ويحشده استعداداً للتأويل، أي للخروج من فرديّته إلى تعدّده، ومن أحاديته إلى دخوله في كل صورة.
وتميّزت المنسوجات بهذه الخصوصية، أي تحررّها من كل السلطات، هي التي تجعلها متمرّدةً على انضوائها سياسياً، وخارجة على المزاج نقدياً، وغير ملتزمة بجنس فنيّ. كما تجعلها محطمةً لكلّ معيار، مخالفةً لكل فكر سابق عليها، بريئةً من كلّ تصنيف. وما كان ذلك ليكون لو لم تكن الحياكة رابطاً بين عناصر مختلفة، شديدة في تنافرها، بعيدة في تماثلها وتجانسها، مفاجئة في ركونها إليه. لذا، كانت الحياكة بتأثيرها وليسس بمعناها. وهذا يقود، إلى تغيير الزوج التصوري: الرسالة/المعنى، ليصبح التأثير/التلقي16.
والمنسوجات حين تقدّم نفسها على هذه الشاكلة، فلأنها إنجاز تعتمد في توليده على «فعل الحياكة» و«عمل دلالي». أمّا فعل الحياكة، باعتباره لغة مشفرة، هو بمثابة لسان حال الناسجة المعبرة عن مقصدها، وتلك الرموز والإشارات بمثابة فعل لسانيّ غير صريح المعاني لكنّه منسجم من حيث المعنى والمبنى. وأمّا الحياكة عملا، فهو الكتابة. والكتابة عمل إبداعي وظيفته إيجاد الطريقة المثلى للتعبير، وخلق المعاني هو تسميتها.
إنّ تصوير الخطاب النسوي في النسيج على أنه فعل لساني وعمل لغوي، ليجعل المنسوجات تعيش صراعاً دامياً في لغتها ذاتها بين دلالة القصد وصيرورة المعنى، وبين كونها قولاً وكونها تأثيراً، وبين مدلولها الذي يرتبط وجوداً بإرادة خارج اللّغة الذي يأبى أن ينصاع لغير إرادتها الذاتية في إنشاء معناها. و إنّ هذا الصراع الدامي الذي يمزّق المعنى أشلاء ويرميه فوق النفايات المعجمية، ويأخذ الدال مسحوراً به ومفتوناً، فيتوه معه في بوادي الارتحال والتغير، ليُخرج اللّغة من مفهومها أداة إلى مفهوم آخر، تصير اللّغة فيه بانية لما تنجزه ومولّدة لما سينجز، وهنا يصبح من الضروري عدم الخلط بين مفهومين للّغة:
الأول، ويتلاءم مع طبيعة لغة الخطاب النفعي، حيث تكون اللّغة فيه أداة للإيصال، كما جرى ذلك في اللّغة التي عرّفها سوسير ومارتينيه وغيرهما والثاني، ويتلاءم مع طبيعة لغة الخطاب الأدبي، حيث تكون اللغة فيه إنجاز أعمال، كما هو الأمر عند بارت، وجاكوبسون، وكريستيفا، وجان كوهين، وغيرهم17. إنّ تصوير القراءة على أنّها عمل لغوي، يُخرج القراءة من كونها استهلاكاً للمكتوب، إلى مفهوم آخر تصير فيه منتجة له وفاعلة فيه. وعلى هذا، يصبح من الضروري أيضاً، الفصل بين مفهومين للقراءة: الأوّل، ويتلاءم مع مفهوم القراءة أداة استقبال لرسالة نفعية استهلاكية، يكون الإيصال فيها هو الهدف الرئيس. والثاني، ويتلاءم مع مفهوم للقراءة تكون القراءة فيه منتجة للرسالة (النصّ) لا أداة لها، ويكون تدشين المعنى فيها، كما ترى أرمينغو، هو الهدف الرئيس وليس الإيصال18.
والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها هي أن هذين المفهومين، للّغة والقراءة، يؤسسان حريّة الأدب، ويسمحان بلقاء النصّ والقارئ في معزل عن أي سلطة من أيّ نوع19. وإنّ هذا ليؤدّي بدراسة النسيج إلى: إزالة كل هيمنة أيديولوجية، أو حكم معياريّ مسبق الصنع وقائم على التصنيف، ولا علاقة له بالإنجاز اللّغوي للنسيج وتشكلاته20.
وليس غريبا أن يكون للمناخ والجغرافية دور كبير في تحديد طبيعة الرموز والإشارات والنقوش والألوان وطاقاتها التعبيرية، ما يقال عن جمالية المنسوجات الفارسية والتبريزية والقيروانية والأندلسية والأمازيغية وميل الناسجات للتعبير عن ذواتهنّ من خلال اللّون والنقش والرسم... وميل تلك الشعوب للتعبير بين اللسان والملفوظ الإيمائي والتعبير بالإشارة. ولهذا الأمر أهميّة خاصّة، فقد أكّدت مجموعة من الأبحاث وجود روابط وثيقة بين اللّسان وبين الملفوظ الإيمائي المرافق له، فنادرا ما نستطيع الفصل بين الإيماءات الصادرة عن ذات اجتماعية ما وبين طبيعة اللسان الذي تستعمله. وهذا يعني أنّ الاستعمال الاجتماعي للسان مرتبط أشدّ الارتباط بالاستعمال الاجتماعي للجسد. فاللّسان الأصليّ المتجذّر في وجدان الفرد له أيضا جسد أصلي يقابله21. وهذا أمر طبيعي أيضاً، فالانتماءات المختلفة لا تتجلّى فقط من خلال الاختلافات اللسانية فـالذين «ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين لا يتكلمون لغتين مختلفتين فحسب، بل يسكنون عوالم حسيّة مختلفة»22. فإذا وقفنا عند حالة من حالات الأعمال المنسوجة التي تقوم بالتمثيل للحضور الإنساني، من خلال نماذجها المتعددة: الألوان والنقوش الرموز المتعددة، نلاحظ أنّ مجمل الدلالات في هذه الأشكال التعبيريّة تتحدّد، حياكة، من خلال الشكل الذي يتخذه الجسد الإنساني داخل هذه المنسوجات. فالأعضاء الجسدية كيانات قابلة للعزل انطلاقا من ارتباطها بدلالات سابقة. فالعضو، كما هو معروف، يندرج ضمن نشاطين: نشاط عملي من طبيعة نفعية، وهو نشاط يوجد خارج أي تسنين لأنه لا يستجيب سوى للحاجات الأولية التي يتطلبها الوجود الإنساني ذاته. وهناك نشاط آخر من طبيعة ثقافية، وينظر إليه دائما باعتباره حصيلة تراكمات ثقافية. إن الفصل بين البعدين شرط أساسيّ من أجل تحديد الدلالات الإيحائيّة غير المرئية من خلال التجلّي المباشر. فلا أهميّة للعضو في بعده النفعي ولا قيمة دلالية له، فالرموز والنقوش في الحياكة ليست هنا للبرهنة على وجود معنى واحد، بل تشتغل بوصفها نصّاً في حدود بنائها لدلالات تتجاوز التمثيل الأوّل. وفي هذه الحالة، تدخل كل العناصر المكونة للنقوش والرموز في تبار لا نظير له من أجل تسليم نفسها لمتاهات دلالية مفترضة من خلال السياقات التي تبنيها كلّ ذات مبصرة على حدة، دلالات الوجه، واليدين، وحالات العين وطبائع النظرة.
وهذا ما يتجلّى بوضوح أكبر في الشكل الآخر لإنتاج الدلالات، ويتعلّق الأمر بقدرة الألوان والنقوش على الإحالة على معان بعينها من خلال شكل تحققها. فالألوان والنقوش المرسومة في المنسوجات تقيم علاقة مباشرة بالعين والوجه والموقف من المشاهد. وهذا معناه أن النقوش والألوان لا تكتسب دلالاتها إلاّ من خلال وجود ذات مبصرة. ذلك أنّ علاقة المتلقي بالمنسوج محكومة بقدرته على تحديد الخطاب المحمّل داخل الرموز والنقوش والألوان وفكّ شفرته وغاياته. استنادا إلى هذا تصنّف النقوش وكلّ الألوان الموجودة في النسيج عادة في أشكال تختلف باختلاف حالة الناسجة وما تريد قوله من خلال هذه النقوش والرموز والألوان، ولكلّ نقش أو لون دلالات بعينها عند الناسجة. ربّما تكون هذه النقوش والرموز والألوان ضمائر مخاطبة واستغاثة قد تريد منها الناسجة الدعوة إلى المشاركة أو التوسل أو الاستغاثة، كما قد تثير عند المتفرج شعورا بالتحدّي والمجابهة. وفي هذه الحالات توضع الرموز بين مرسِل ومرسل إليه (المتلقي) لهذه النصوص المنسوجة والناظر لهذه الرموز والنقوش والإشارات ضمن الخطاب المنسوج يحيل على عالمين مختلفين، من حيث القيم والمصير، أو على العكس مدعوين إلى التطابق، كما هو الشأن في كل الحالات التي تقدمها الحياكة. فوظيفة الرموز المرسومة/ أو المرقومة غايتها إشراك للمتلقي لجمالية الحياكة، فهي دعوة صريحة إلى تبني القيم التي يمثلها المنسوج المعروض للتداول.
وقد تكون هذه الرموز بمثابة نظرة تجاهل للمتفرج كما هو الشأن مع الحالة النفسية الداخلية للمرأة الناسجة حيث تنفر من جلادها ومن يشاركه التجنّي عليها فتتحدّى المقصود الصريح بالخطاب المشفّر، مثل الأب والعمّ والأخ والزوج والحبيب الخائن... فالخطاب في هذه الحالة يتمحور خارج مدار المتلقي، وهنا يكون الخطاب المحمّل للمنسوجات ينساب ضمن فضاء آخر غير فضاء بناء دلالات جديدة ومنفتحة على تغيّرها، تنتقل فيها العلاقة بين النص والقارئ، والكلمة ومدلولها، والإشارة ومرجعها، والرمز من علاقة رتابة وسكون واستقرار إلى علاقة في الصيرورة، ينتفي معها المألوف، والمحتوم، والمكرّر.
فالمتلقي المعجب بحرفية المرأة الناسجة يجد نفسه أمام مشهد مقطعي من طبيعة سردية. إذ تضع الحياكة كلّ من يحمل صفة المتلقي في مواجهة «هو» المستبد الظالم، الذي لا يلتفت إلى القيمة الفنّية للنسيج ولا ينتبه إليها. «وربما توجد بعض الرموز في الحياكة تحكي حكايات لا أحد يعلمها وفكّ رموزها صعب وقد تحيلنا تلك الرموز، على دلالات من طبيعة خاصة»23. وقد تحمل الحياكة في مثل هذه الرموز مدونة اعترافات بأسرار، لو عُرفت أو فُكت ألغازها ما كان لناسجتها أن ترى اليوم التالي، فهذه الرموز قد ارتبطت دائما بنهاية مسار، أو نهاية قصّة، أو نهاية مغامرة. نهاية يعقبها بداية ألم ومعاناة مريرة، كما قد تدلّ في سياقات أخرى، على التخلّي والابتعاد عن المواجهة، أو هي من منظور آخر تشير إلى حرقة الوحدة والمواجهة الفردية للمصير. وفي كل هذه المواقف الإنسانية تظلّ الحياكة، باعتبارها خروجا من الفيزيقي البيولوجي ومعانقة للإنساني الثقافي، هي الأساس في تشكّل المعاني، «فهي التي تؤسس وتنظم ما هو موضوع للرؤية، إنّ الأمر يتعلّق بمنظور يحدّد الحقل البصري ويبسطه أمامنا، إنّه الموقع الذي ننطلق منه لتحديد ما يقع تحت طائلة الأعين»24.
من خلال ما تقدّم، يمكن القول إنّ كلّ التأويلات الممكنة للمنسوجات ورموزها وما يمكن أن يكون من خطاب مسكوت عنه يجب أن تستند إلى هذه المعرفة الخاصة بالحضور الإنساني داخل الكون من خلال مجمل لغاته، وعلى رأسها لغة جسده25. ففهم المنسوجات وقراءتها مرتبطان بقدرة المتلقي على القيام بالتنسيق بين مجمل العناصر المشكّلة لنصّ المنسوجات، وهو تنسيق لا يستند إلى ما تعطيه المنسوجات، بل يستند إلى معاني هذه العناصر خارج النسيج وضمن سياقات الفعل الإنسانيّ المتنوّعة.
وبعبارة أخرى، فإنّ تأويل المنسوجات بما تحمله من رموز ومعانٍ متنوّعة بتنوّع الألوان والنقوش، مثل كلّ تأويل، يحتاج إلى بناء السياقات المفترضة من خلال ما يعطى بشكل مباشر، ولا يمكن لهذا التأويل أن يتمّ دون استعادة المعاني الأولية للعناصر المكوّنة للمنسوجات، وضبط العلاقات التي تنسج بينها ضمن نصّ منسوج.
وفي جميع الحالات، يتعلّق الأمر باستحضار التمثّلات الثقافية الكبرى التي لها علاقة بـ «الأنا» و«الآخر»، ولها علاقة بإكراهات الزمان و المكان، ولها أيضا علاقة بمجمل الروابط الإنسانية وما تفرزه من قيم وأحكام وتصوّرات يتمّ إيداعها داخل عضوٍ أو داخل نظرة أو موضوع من الموضوعات المؤثّثة للمحيط الإنساني، لتصبح هذه العناصر دالّة خارج إطارها النفعيّ.
ومع ذلك، لا يمكن القول إنّ العلاقات التي تنسجها العلامة الموجودة في النسيج كافية للحديث عن كلّ دلالي. فالحياكة ليست محاكاة لعالم غفل، وليست تمثيلاً خالصاً للموضوعات، إنّها تستعيد مجمل معطياتها ضمن أشكال ومواقع وألوان. ولهذا نحتاج، من أجل بناء مجمل دلالات النسيج، إلى مساءلة جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب الأيقوني، ونقصد بذلك ما تقدمه العلامة التشكيلية باعتبارها عنصراً يشتغل كأهم مكوّن داخل عالم الإبلاغ البصري. لذلك فللألوان والأشكال والخطوط والتأطير والتركيب أهميّة كبرى في بناء معاني النسيج. «فهذه العناصر هي وحدات داخل لغة منسوجة لها قواعدها التركيبية والدلالية وليست مجرد متغيّرات أسلوبية، كما كان يُنظر إلى ذلك في مرحلة سابقة في تاريخ التحليل السميائي»26.
خاتمة
ما دام النسيج خطابا حاضرا، ونصا شاهدا، فقد انفتح المنسوج على وجوده، وصارت الحياكة به حضور الوعي لا غيابه، وانبثاق الذات لا الأداة. لقد صارت الحياكة بحضور خطابها، وشهادة نصها وعياً حاضراً، و ذاتاً فاعلة، وأساليب متعدّدة. فاستولت بذلك على مصائرها، ودخلت دوائر كان المحال يقف من دونها معاً، والغياب يقوم إزاءها وناسجتها حاجباً. أمّا صفاتها، وقد تجلّت ذاتاً متلفظة، لا أداة، فقد صار يرسمها تضادها مع التقنين، ونفورها من التحديد، وتمرّدها على المألوف، وصراعها مع السجون المانعة لوجودها.
ومن خلال منح النسيج صفة الكتابة، أصبحت المنسوجات تعيش تحرّرها ضمن الممكن الذي يظلّ ممكناً. وغدت، من ثمّ، تأبى كلّ وصاية مهما كانت: قاعدية، وإيديولوجية، وتأطيريّة. وعاذت بذاتها درءاً لكلّ تصنيف. وصار القارئ المتلقي يرى فيها امتداد الزمان، وتداخل الشعوب، وتعايش الفرديات، وتلاقح الحضارات: تفاعلاً وتناصّاً.
لقد اكتسبت الحياكة النسيجية إذن شروط وجودها. فانحازت إلى نفسها غاية، وصارت إنجازاً لا ينتهي. إلاّ أنّ أهم سمة اكتسبتها هي الممكن الذي يولد المنسوج فيه متعدداً. وبهذا، فقد صارت الحياكة بشكل عام كائناً لا يصحّ فيه «التشيؤ»، لأنّها في توالد دائم، ولا يجوز فيها «التصنُّم»، لأنّها خلق مستمر. ولا تحكمها الأحادية، لأنّها مفرد متعدّد، قابل لكلّ صورة.
أما عن حضورها بالذات، فيمكن القول عنه إنّه كان، منذ أن كانت تمثيلاً لا جوهرياً، ومجازاً لا حقيقة، وتشبيهاً لا هوية. وهي تخلق ثوابتها ثم تلغيها لتصير أخرى، تكشف لعبة الوجود وقوانينه. ولذا كان التمثيل، والتخييل، والمجاز، والتشبيه، والاستعارة، والكناية أدوات قراءتها التي لا تنتهي.