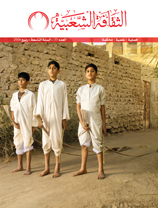نحو هوية مستدامة للمدينة العربية: رؤية فكرية عابرة للتخصصات
العدد 56 - ثقافة مادية

مقدمة:
كانت المدينة العربية على الدوام منارة للعلم والحضارة والأمان، تحيطها الأسوار المنيعة، وتشقها الأنهار الجارية، ويحتضن مركزُها المسجدَ الجامع، حيث تتعانق رمزية الروحي بالمعرفي. وهذه المعاني الجليلة يدركها ويشتَمُّ عبَقها كل من تجول في إحدى المدن العربية القديمة وجاب أزقتها وشوارعها، سواء في عمان، أو فاس، أو القاهرة، أو دمشق...
لكن الواقع يصدمنا بمفارقة قاسية، فالمدينة التي شيدت في الأصل لتوفير الأمان والحماية لسكانها، أصبحت الآن مصدرا للإزعاج والتهديد لقاطنيها؛ ففي كل المدن العربية حارات وأزقة ينصح بتجنبها؛ ومدارات طرقية مزدحمة ترهن مرتاديها، لذا يحرص الميسورون على اقتناء منازل في الإقامات المحروسة، حيث الطمأنينة والأمن وكاميرات المراقبة، فـ «لقد زاد عامل الخوف، ويظهر ذلك في زيادة السيارات المقفلة، وأبواب المنازل المقفلة، والأنظمة الأمنية، والشعبية المتزايدة لما يسمى الأحياء السكنية المغلقة والآمنة، والمراقبة المتزايدة للفضاءات العامة، ناهيك عما تبثه وسائل الإعلام من تقارير لا نهائية عن الخطر»(1).
فما الذي حدث للمدينة العربية؟ وكيف تحولت من مدينة الجمال والجلال، إلى مدينة عادية يتعكر جلالها بالعنف والازدحام، ويتشوه جمالها بالعشوائيات والفوضى؟
للإجابة على هذا السؤال، سننطلق من تعريف مركب لهوية المدينة، يجمع بين العناصر الثقافية والقيمية وبين تجسدها المادي العمراني في الفضاء؛ لنبين أن الحفاظ على هوية المدينة العربية لا يتحقق بالاقتصار على التدخلات ذات التوجه العمراني فقط، مثل عمليات ترميم الأسوار القديمة أو تصميم واجهات المباني على النمط العمراني الإسلامي؛ بل يتطلب الأمر عمليات مركبة توازي بين التدخلات العمرانية وبين إعادة إحياء القيم العربية الأصيلة والحفاظ عليها.
أولا- ما الذي يشكل هوية المدينة العربية؟
رغم الخصوصيات الثقافية المحلية، فإن الحواضر العربية الكبرى تتشابه في كثير من السمات، لعل أبرزها المزج الجميل حينا والفظ أحيانا بين مظاهر الحداثة والأصالة في أشكالها العمرانية، بالإضافة إلى وجود المدينة القديمة «التقليدية» حيث البناء الإسلامي بخصائصه المعمارية الجميلة، تنمو على تخومها مدينة عصرية حديثة حيث الشوارع الواسعة والبنايات الشاهقة والأسواق الكبرى.
لكن ما الذي يشكل هوية مدينة؟ هل هوية المدينة عمرانية فقط؟ تقوم على الأشكال العمرانية الموجودة بها بالإضافة إلى نمط التصميم الحضري السائد؟ أم أن هوية المدينة أكبر من ذلك؟
إننا نُعجب في الغالب بالمدينة العربية القديمة، ونمدح ما تعكسه من قيم حضارية، وتوجهات جمالية وفنية... لكن هذا التقييم «الفني» لقطعة فنية تاريخية كبيرة (المدينة القديمة) هو تقييم لاحق على مرحلة البناء والتشكل الحضري، وهو بالأحرى حكم قيمة جمالي في الغالب وأخلاقي أحيانا؛ لذا فهو يغفل سياقات التشكل، بل ويوقعنا في مفارقات الفهم المجتزئ للعلاقة بين المدينة العربية القديمة والقيم العربية الأصلية.
إذ نتحدث في الغالب بقدر كبير من العاطفية ونحن نتذكر أبواب البيوت وواجهات المنازل في مدينة تطوان المغربية القديمة(2)، وكيف كانت موحدة لا تعكس فروقات المستوى الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، إذ كانت مظاهر الغنى شأنا داخليا خاصا وليس مدعاة للتفاخر الاجتماعي؛ كما نتحدث بتقدير عن النوافذ الخشبية لبيوت القاهرة القديمة في مصر، حيث تستطيع نساء البيت مراقبة الشارع وأحواله، دون أن يُكشف سترهن بفضل الزخرفة الخشبية البديعة للنوافذ، التي كانت تدمج بين الجمال والحشمة بشكل متقن؛ كما نتذكر بقدر كبير من الحنين غرف الضيوف في كل المنازل القديمة في العالم العربي، وكيف كانت دائما أجمل غرفة وأكبر غرفة.. وهي غرفة محرمة على الأطفال وعبثهم، ومجهزة دوما لاستقبال الأهل والمعارف وإكرامهم... وقد نشعر ببعض الحزن ونحن نقارنها ببنية الشقق العصرية المشيدة بكفاءة وظيفية عصرية تستثني الكرم!
إن مراعاة مشاعر الجيران الفقراء أو الحشمة والحياء أو الكرم والحفاوة بالضيف أو غيرها من القيم العربية الأصيلة، كانت دوما في عمق ثقافتنا العربية الأصيلة، وشكلت موجها ثقافيا للنشاط الإنساني؛ وبالتالي فإنها استندت دوما إلى مجموعة قيم موجهة للسلوك الإنساني عامة بكل مستوياته وتجلياته. لذا فإن الإنسان العربي الذي كان يتبنى الذوق والحشمة والكرم في سلوكه اليومي، كان مدفوعا بشكل تلقائي لتجسيد هذه القيم الأصيلة في نمطه المعيشي عبر تشكيلات عمرانية وعلاقات اجتماعية.
بمعنى أن التجسيد العمراني لهذه القيم لم يكن من قبيل التكلف والتصنع، بل كان عملا عفويا وتلقائيا لتوفير فضاء عمراني يحتضن المعيش اليومي بطقوسه القائمة. لذا لا ينبغي أن يقتصر فهمنا لهوية المدينة العربية على النمط العمراني فقط، بل ينبغي أن يتسع الفهم ليشمل التصميم العمراني والقيم الكامنة فيه، وهي القيم نفسها المشكلة لأنماط العلاقات الاجتماعية القائمة وأسس المعيش اليومي وتصوراتنا عن العالم وأدوارنا فيه، ومعاييرنا الجمالية والوظيفية للوجود في الفضاء، فالعمارة تجسد فكرتنا عن الفضاء بتعبير فيليب بودون(3).
حينما نبني المدينة، فنحن لا نبني فقط جدرانا ومنازل، بل نبني «الطبائع، نبني الشخصية، نبني الأخلاق، ولذلك فإن بناء المدينة ليس بالأمر الهين الذي بمستطاعنا أن نقوم به بكل سهولة، إن تخطيط المدينة لا يعني عملا عشوائيا مرتجلا يحتاج لأسبوع، أو لشهر أو لسنة، ولكنه عمل يحتاج لدراسة مستقبل الأيام»(4).
فالقيم نفسها التي تظهر في تحية وابتسامة، تجدها في طقوس احتفال، كما تجدها في مطلع قصيدة شعرية، وفي تصميم بيت أو زقاق.. فلكل مدينة هويتها المتفردة، وهي حاصل تفاعل القيم والثقافة والأخلاق الاجتماعية والتفضيلات الجمالية، والبُنى العمرانية: «كل مدينة في حد ذاتها فريدة، فالثقافات والوظائف والتاريخ، مجتمعة مع بعضها هي ما يمنحها فرادتها وهويتها»(5).
يقول إدريس مقبول: «كان للمدينة العربية (بغداد وفاس والقاهرة والقيروان وغيرها) في التاريخ الوسيط طابع عمراني وهوية عمرانية تعكس فلسفة الوجود والإنسان ورؤيته النسبية المنسجمة لقيم الجمال والآخر والأخلاق، ولتنظيم مركب لقطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة وغيرها، بالإضافة إلى انسجام ذلك مع مناخ الجغرافيا العربية»(6).
وتقودنا المقارنة إلى ملاحظة الفارق الواضح بين مركزي المدينة الحديثة والقديمة: ففي المدينة القديمة، كان المسجد «الجامع» دوما قلب المدينة ومركزها(7)، ومنه تتفرع الشوارع الرئيسة. (صورة 2: الرباط- المدينة القديمة) ومركزية المسجد هي مركزية عمرانية وثقافية أيضا، في مجتمعات تقدس روحية المسجد الدينية وتستمد منها السلطةُ مشروعيتها. ولا يتعلق الأمر فقط بمركزية الديني، بل هي أيضا مركزية العلم والمعرفة في النسق الحضاري الإسلامي، حيث زاوج المسجد دوما بين الدورين الديني والعلمي، ففيه كانت تقام الصلوات وتلقى الدروس والمحاضرات.
أما مركز المدينة الحديثة فيمثل هذه المرة قيم السوق والاستهلاك: فـ«وسط البلد» هو مركز التسوق، حيث المحلات التجارية والأسواق الكبرى والشوارع الواسعة والمطاعم والمقاهي. إن مجتمع الاستهلاك الحديث يؤسس مركزيته العمرانية بشكل مختلف: إنها مركزية الاستهلاك والترفيه. وحيثما يحل السوق بقيمه الاستهلاكية، فإن المآسي الاجتماعية تتفاقم وتتضاعف، وتصبح حياة الإنسان الحضري متاحة للبيع والشراء والاستغلال البشع للاقتصاد الرأسمالي(8).
ولا ينبغي أن ننسى أن التأسيس الأول للمدينة القديمة، كان محل إجماع مجتمعي وكان تنظيما عمرانيا واعيا بالقيم التي يعبر عنها ويمثلها؛ مقابل توجه عمراني تسويقي في المدينة الحديثة، هو في الغالب نتيجة لاجتهاد تراكمي للأسواق والمتاجر في التموقع المربح أكثر من كونه توجها مجتمعيا واعيا أو مؤسسيا يهدف إلى توطين «بنايات» الاستهلاك والترفيه في قلب المدينة؛ ولعل هذا ما يعبر عنه أغلب الباحثين بالفوضى في المدن الحديثة التي نمت بشكل عشوائي يصعب أن يحتويه تخطيط منطقي(9).
لهذا يصف بعض الباحثين ساكن المدينة القديمة وبانيها بالكائن الثقافي، فيقول مقارنا بين المدينتين القديمة والحديثة: «كم كان الناسُ معنيين بلوحة المدينة...! كم كان كل منهم مثقفاً طبيعياً...! كان في المهندس (كائن ثقافي) وكان في القاضي (كائن ثقافي).. وفي البَنَّاء ومُشَذِّب الحجارة ونجار النوافذ الخشبية ومنفذ التهوية الذاتية ومصمم القساطل وقنواتها.. في هذا الجَمْعِ كلِهِ تشكَّلَ هذا الكائنُ وإلا ما خرجتْ المدينةُ مفعمةً بالأرواح والأزمان.. فكانتْ المدينةُ بالنسبة إليهم كلها عمارة.. وكل ما ينضافُ إليه الفن فهو عمارة..
وما ليس فيه فن فهو مجرد (غُرَف ومنافع وموزع) وجيش من المكاتب العقارية والمشتغلين بها وحولها!! في هذه المكاتب التي تشكل بورصات وبازارات السكن في المدينة العربية (الحديثة) يعمل المدرسون والتجار وأصحاب رؤوس أموال من مستويات مدهشة في التباين والاختلاف.. هذا الجيش الفوضوي ليس له أن يضيفَ شيئاً.. وليس له من الأمر شيء.. وليس فيه أو لديه شيء.. نقاط متشابهة سوداء تصطاد في الفراغ عبثَ التردي والوهم.. وتزيدُ تعاسةَ العمارة الحزينة»(10).
ولعله الرأي نفسه الذي يذهب إليه كاتب مصري آخر، حينما يعتبر أنه حتى وإن سلمنا بأن المدينة القديمة في القاهرة مثلا تعج بالفوضى، فإن المدينة الجديدة المجاورة لها هي قطعا أكثر فوضوية(11).
ويلخص ادريس مقبول المقارنة بين النمطين العمرانيين المتجاورين في المدن العربية: المدينة القديمة والحديثة بقوله: «وعلى قدر وفاء العمارة بالشروط الفنية والحاجات الأصيلة لصانعي الحضارة والثقافة ينعكس ذلك على« المتجلي» عمرانيًا ولسانيًا في الفضاء الهندسي والتواصلي، وفي المقابل تعكس الاستعارات المعمارية «غير الواعية» وغير المدروسة خارج سياقها تدهورًا واضحًا في الذوق والفكر والتخطيط، وهو ما تعانيه اليوم جميع المدن العربية تقريبًا من أزمة عمارة بسبب دخول فن العمارة الغربية عليها»(12).
نخلص هنا إلى أن هوية المدينة العربية هي هوية مركبة، تجسد علاقة متداخلة ومتبادلة بين العمران من جهة، وبين قيم المجتمع وثقافته من جهة ثانية؛ وكل رؤية تحصر هوية المدينة في طبيعة البنايات وتخطيطها، فإنها نظرة اختزالية تجانب الصواب. فالمدينة العربية نتاج للقيم العربية الأصيلة، وهي في نفس الوقت ضامن لاستمرار تلك القيم والحفاظ عليها. لذا فإن «مدى استلهام النموذج الحضاري والثقافي للهندسة المعمارية كان المؤشر على أصالة الهوية المعمارية وتماسكها أو تفككها، في إطار من تقويم النظرية المعمارية في ضوء الخصائص البيئية والحضارية المحلية»(13).
ثانيا - هوية المدينة العربية: الواقع والتحديات
خلصنا فيما سبق إلى أنه لا يمكن النظر إلى هوية المدينة بمعزل عن قيم أهلها؛ بحيث نشأت بين هوية المدينة وقيم أهلها علاقة دائرية لتأثير متبادل يصعب تحديد بدايته: فالمدينة ببناياتها وتخطيطها الحضري تجسيد فضائي للقيم التي يؤمن بها سكانها؛ حيث تم تشييد المدينة وفق قيم وقناعات أخلاقية وجمالية ووفق رؤية معينة للحياة والوجود.
لكن في المقابل؛ فإن المدينة أيضا تصبح حامية لقيم الجماعة وضامنة لاستمرارها من خلال آليتين: الآلية الأولى هي تعزيز قيم الجماعة من خلال كون فضاءات المدينة محضنا ضامنا لاستمرار القيم الاجتماعية والحفاظ عليها عبر توجيه أنماط العيش ومختلف أشكال التواصل الاجتماعي بما ينسجم حصرا مع قيم الجماعة؛ والآلية الثانية هي إدماج الأفراد الجدد في المجتمع، سواء الأطفال أو الوافدين على المدينة، في قيم الجماعة الحضرية من خلال تكريس النمط العمراني لتوجيهات معينة للسلوك الاجتماعي وفق القيم الجماعية.
بهذا المعنى، فالقيم تشكل المدينة وتشيدها، والمدينة تحافظ على القيم وتضمن استمرارها، وتستمر بها.
لكن ما الذي تغير في هذه العلاقة القديمة المستمرة، بحيث صارت المدينة العربية الأصيلة ذكرى جميلة نستعيدها بنشوة وحسرة؟
يتحدث الجميع عن المدينة العربية بشكل تغلب عليه السلبية والسوداوية، خصوصا وأن مشاكل المدن العربية واحدة تقريبا، تشمل الاكتظاظ والازدحام والتخطيط العشوائي وتنامي البطالة وارتفاع معدلات الجريمة والعنف... لدرجة أن «التقابل بين الحضارة والبربرية قد انعكس؛ فحياة المدينة تتحول إلى حياة الطبيعة التي تتسم بسطوة الرعب وهيمنة الخوف»(14).
ويعود ذلك إلى تغيير مزدوج أصاب طرفي العلاقة الإثنين: قيم الجماعة، وبنية المدينة... لهذا فإن ضريبة التغيير ومضاعفاته كانت كبيرة جدا ومتسارعة. فعلى مستوى بنية المدينة، تضم أغلب المدن العربية الكبرى مدينتين ضمن المدينة الواحدة: «المدينة القديمة» بأسوارها الحامية وأزقتها الضيقة وأسواقها الجميلة ومنازلها القديمة، بالإضافة إلى «المدينة الجديدة» ذات النمط العمراني الغربي الحديث، حيث الشوارع الواسعة والعمارات الشاهقة والأسواق الكبرى. ويربط الباحثون بدايات هذه الازدواجية بفترة الاستعمار الذي طال أغلب البلاد العربية، وأدخل معه أنماطه العمرانية الوافدة.
إن نمطي العمارة المتقابلين، يعكسان أيضا نمطين متقابلين من القيم، حيث أن النمط العمراني الجديد للمدينة الحديثة، جلب معه قيمه الخاصة؛ فليس من الممكن مثلا إقامة مناسبة اجتماعية في شقة صغيرة في عمارة سكنية؛ لذا يلجأ الأفراد في الغالب إلى قاعة أفراح وحفلات، حيث يجري الحفل وفق طقوس جديدة: فزمن الاجتماع العائلي هو نفسه زمن الحفل تحديدا، بحيث ينفَضُّ الجمع بانتهاء الحفل، وتختفي بذلك طقوس اجتماعية من الكرم والتلاحم العائلي كانت تظهر في استقبال أفراد العائلة أياما قبل الحفل، والتعاون في الإعداد له، والتعاون في تنظيمه، ثم التعاون على تنظيف البيت بعده... بحيث تشكل هذه الطقوس مؤسسة لحفظ التماسك العائلي، والاجتماعي عبره، وكرم الضيافة ونقلها إلى الأطفال. كما أن بنية قاعة الأفراح تفرض جلسة موحدة للنساء والرجال، مما يفوت طقوس الحفل «المزدوج» حين كان للنساء طقوسهن المختلفة عن طقوس الرجال، بحيث كان الحفل يمتد في عدة مسارات متوازية.
ومن عيوب استخدام قاعات الأفراح بدل البيت، تعطيل إرادة الخير الجماعية وتعميم البركة، حيث كان ذلك يتم في المغرب(15) من خلال اختتام الوليمة ببعض الآيات القرآنية والدعاء لأهل البيت. وهو الدعاء الذي كان جميع الحاضرين يؤمنون عليه، حيث كان يشمل صاحب البيت، والمحتفى به في الوليمة (العريسين، أو المولود الجديد...) كما يشمل النسوة اللواتي طبخن الطعام وكل الذين ساعدوا بالتنظيم، ثم يُختم بالدعاء لجميع الحاضرين الذين يعبر عنهم في صيغة الدعاء بلفظ «الجماعة».
إن هذا الطقس الاجتماعي يرمز إلى وحدة الجماعة، وتعبيرها الصريح عن تضامنها ومشاركتها الفعلية في الأفراح والأحزان، كما يعبر أيضا عن مسألة مهمة وهي الإرادة الرمزية الجماعية والطوعية وغير المشروطة لتعميم الخير.. غير أن كل هذه المعاني تختفي -مع الأسف- بمجرد تغيير الفضاء الحاضن.
من جهة أخرى، فقد عرفت أغلب البلاد العربية تنامي الهجرة نحو المدن، نتيجة لأسباب عدة، من أهمها توالي سنوات الجفاف وقلة الأمطار في البوادي والأرياف، مما جعل الحياة أكثر صعوبة، ودفع القرويين إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن عمل. غير أن أفواج المهاجرين الحالمين بنعيم المدينة قد استقروا في تجمعات سكنية عشوائية على أطراف المدينة، نظرا لظروفهم المادية المتعسرة، التي تمنعهم من الاستقرار في منازل لائقة، لذا سرعان ما برز نمط عمراني ثالث إضافة إلى النمطين السابقين: المدينة القديمة، والمدينة الحديثة؛ وهو ما يعرف بالعشوائيات(16): هو نمط عمراني مشوه، نما بشكل فطري، دون تخطيط، ويفتقر إلى مقومات السكن اللائق سواء من حيث غياب التجهيزات الأساسية التي تشمل الربط بالكهرباء ومياه الشرب وقنوات الصرف الصحي، أو من حيث غياب التصميم الحضري الحديث، فتتراكب البيوت وتضيق الأزقة وتنعدم التهوية الملائمة وتغيب أشعة الشمس أو تكاد.. بالإضافة إلى البيوت التي بنيت جدرانها وسقوفها يدويا من الطين أو غيره من المواد «البدائية».
إن الهجرة القروية غير المدروسة، والاتساع العشوائي للمدن، أحدثتا تشوهات عدة على مستوى بنية المدينة العربية وعلاقاتها، حيث أفرزت «غيتوهات» طوعية في أطراف المدينة وهوامشها تعيش مكانها الخاص وزمنها المستقل، خارج التطور العمراني الحاصل في المدينة؛ كما شملت أيضا ظواهر اجتماعية مقلقة، مثل الازدحام في المواصلات العامة، وتنامي البطالة وما ينتج عنها من مظاهر الإجرام والتسول.. بل إن العشوائيات التي حُجبت نسبيا عن النظر بفعل بعد المسافة عن مركز المدينة وظلت مشكلة مؤجلة إلى حين، قد أصبحت تدريجيا مشكلة مُلحة نظرا للتوسع العمراني للمدينة التي التقت بناياتها الحديثة بأكواخ العشوائيات البئيسة لتشكل نشازا بصريا غريبا لم تسلم منه معظم المدن العربية الكبرى.
وهذا ما ضاعف على السلطات المسيرة لشؤون المدينة أعباء التخلص من هذا النشاز، والتفكير في هدم العشوائيات وحث سكانها على الانتقال إلى مناطق سكنية مجهزة... وهي جهود محمودة، نجحت إلى حد كبير في إزالة العشوائيات، لكنها لم توفق إلى حد الآن في نزع «العشوائية» من عقول السكان المهجَّرين، الذين يأخذون معهم عاداتهم ومشاكلهم إلى الأحياء الجديدة.
يطلق الباحثون على مشاكل المدينة وصف «أعراض مرض التمدن»، التي يُفصِّلها إدريس مقبول بقوله: «ذلك أن المشكلات اليومية والمصيرية التي أضحت سمة بارزة للمدينة العربية في المشرق العربي كما في المغرب العربي بجميع رهاناتها الهائلة، هي في النهاية محصلة فوضى عارمة، ومدنية معتقلة داخل الإسمنت، ومواطنون يعانون «المدنية»، حيث أصبح المواطن في بناها فاعلا وضحية في آن معا(17)، حيث أعراض التمدن تمتد من التناقضات العمرانية الصارخة(18) إلى نقص المياه والشروط الصحية، إلى استغلال الأطفال والنساء، إلى برامج التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات، إلى تراجيديا التلوث البيئي وإلى جميع سوءات المدينة»(19).
وتنضاف إلى مرض التمدن إشكالات أخرى ذات طبيعة عولمية، تعاني منها المدن العربية كما تعاني منها معظم حواضر العالم. وهي ترتد إلى إشكال رئيس وتتناسل عنه، وهو ضعف البنيات الاجتماعية المشكلة لقيم الجماعة والضامنة للتضامن الاجتماعي، وهو ما يعتبره زيغمونت باومان نتيجة لتحولات جوهرية خلقت وضعا جديدا لطرق الحياة الفردية: «هو انتقال الحداثة من مرحلة «الصلابة» إلى مرحلة «السيولة»؛ فالأشكال الاجتماعية، بمعنى الأبنية التي تحدد الاختيارات الفردية، والمؤسسات التي تضمن دوام العادات وأنماط السلوك المقبول، لم تعد قادرة (ولا أمل بأن تكون قادرة) على الاحتفاظ بشكلها زمنا طويلا؛ إنها تتحلل وتنصهر بسرعة تفوق الزمن اللازم لتشكلها، وليس من المتوقع أن تنعم تلك الأشكال القائمة أو المرتقبة بوقت كاف يساعدها على الانتقال إلى الحالة الصلبة، وليس بوسعها أن تصبح أطرا مرجعية لأفعال البشر والاستراتيجيات الاجتماعية طويلة المدى بسبب عمرها القصير؛ فعمرها أقصر من الزمن المطلوب لاستحداث استراتيجية متسقة ومتماسكة، بل وأقصر مما يتطلبه تحقيق «مشروع حياة»»(20).
وأمام تسارع التغييرات وما تفرزه من تحديات، فإنه من الصعب جدا تحديد البدايات؛ فنتيجة لما عرفه العالم العربي في نهايات القرن الماضي من انفتاح للمجتمعات العربية، ومن تنامٍ للهجرة نحو المدن وتوسع للحواضر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، فقد بدأت الأسرة الممتدة التي تشمل الأبوين والجدين والأبناء من مختلف الأعمار (وبعضهم متزوجون) في التراجع تدريجيا، أمام تصاعد الأسر النووية التي تتشكل فقط من الأبوين وأطفالهما.
والمؤسسة الاجتماعية الأساسية التي تحفظ التضامن الاجتماعي وتحرص على الالتزام بتقاليد الأجداد وقيم الجماعة هي الأسرة الممتدة باعتبارها عائلة صغيرة؛ حيث كانت الأسرة الممتدة والعائلة تمتصان كل أشكال العجز والعسر المادي والمشاكل التي قد تصيب أفرادها بفضل التضامن والتكافل الذي كان دوما تلقائيا، ويقدمه الأفراد بشكل عفوي نظرا لطبيعة التربية والتنشئة الاجتماعية التي خضعوا لها. فالعائلة مسؤولة تلقائيا عن التكفل بالأرملة التي مات زوجها وعن تربية أبنائها؛ بل وفي أسر مغربية كثيرة (وعربية على الأرجح)، كان الشاب يتزوج تلقائيا أرملة أخيه التي قد تكبره سنا لحمايتها والتكفل بأبنائها؛ كما كان العامل الوحيد في الأسرة مسؤولا عن إعالة والديه وتعليم إخوته وتزويج أخواته والإنفاق على أخيه العاطل، خصوصا وأنه (أو زوجته على الأقل) يقيم رفقة والديه.
إن البنية الديموغرافية للمدينة تُغَلِّب الأسر النووية، لأسباب عدة، سواء تعلقت بالوافدين من البوادي، أو المتزوجين حديثا الذي انفصلوا عن منزل آبائهم طوعا أو مجبرين لصغر مساحات الشقق، أو الموظفين الجدد الذين حلوا بالمدينة استجابة لتعييناتهم. فغلاء أسعار العقار، والطابع الوظيفي للسكن الحضري، يفرض الشقق العملية صغيرة المساحة.. إن العنصر الدال في مختلف هذه الحالات هو أن الأفراد وجدوا أنفسهم مجبرين على العيش بعيدا عن العائلة، سواء لوحدهم أو رفقة أسرهم الصغرى..
ولا يتعلق الأمر فقط بالبعد المكاني عن العائلة، بل هو أيضا بعد إجباري عن التضامن والالتزام تجاه العائلة، فكلفة العيش في الزمن المعاصر كبيرة جدا، تدفع الأفراد إلى اللهاث وراء لقمة العيش بشكل مستمر، وبالكاد يستطيعون تأمين حاجياتهم الأساسية ناهيك عن تقديم العون إلى آخرين. ولعلها الملاحظة نفسها التي يشير إليها جورج زيمل حينما يعتبر أن هوية المدينة الحديثة أثّرت بعمق في العلاقات الاجتماعية، وجعلت الفرد أكثر وعيًا بذاته وبفردانيته بفعل عاملي «المسافة» و«الاستقلالية»، لكنها جعلته في الوقت نفسه أضعف من ناحية العلاقة بالآخر(21).
إن تفكك البنى الاجتماعية الحاضنة لقيم الجماعة عملية بطيئة وحثيثة، تفضي إلى تقويض القيم الجماعية وإعلاء مصلحة الفرد.. وفي المقابل، فإن سيادة النزعة الفردية تهدم ما تبقى من حصون القيم الجماعية. وما نخسره نتيجة تفكك الروابط الاجتماعية وانكماش كل الأشكال التقليدية والأصيلة للتضامن الاجتماعي هو باهض الكلفة ويرهن المستقبل للمجهول ولفقدان الأمان.
فالمشكلات التي تواجه الحياة المعاصرة تصبح دولية يوما بعد يوم، وبذلك من الصعب التعامل معها وابتداع حلول سريعة وفعالة لها: فنقص المياه، ونضوب الموارد، وتنامي الاستهلاك، وانخفاض مستوى التعليم، وغلاء المعيشة... هي مشاكل معولمة، وتراجع شبكات التضامن الاجتماعي وقيم الجماعة يضاعفان آثارها السلبية بشكل مهول: فالحكومات المحلية تعمل جاهدة على حل هذه الإشكالات وتجاهد للتقدم في مسار التنمية؛ لكن كانت العديد من الحالات لتكتشف وتعالج محليا وتلقائيا بفضل آليات التضامن التقليدية: العائلة والجيران والمعارف؛ لكن مع تراجع هذه الأخيرة، فإن الأفراد يجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة إشكالات أكبر من طاقتهم على الفعل والمقاومة، بل هي إشكالات أكبر حتى من المؤسسات المسيِّرة لشؤون المدينة؛ فقد «صارت السياسة المحلية، لا سيما السياسة الحضرية، محملة بأحمال ثقيلة للغاية، بما يفوق طاقتها الاستيعابية وقدرتها على الأداء»(22).
وقد اعتبر اللقاء الأول لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، أن التحديات الأساسية التي يواجهها العالم العربي تشمل الأزمة المتنامية التي تعرفها الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية، واحتدام العجز المالي الذي يميزها، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو أنظمة التقاعد أو غيرها من المجالات... كما تشمل زعزعة الأنظمة التقليدية والأصلية للتضامن الاجتماعي من جراء التفكك المتنامي للنسيج الأسري والقبائلي والإثني(23).
وأمام هذه الوضعية، يبقى الرهان على السياسات العمومية وحدها غير كافٍ، إذ لابد من تكاثف الجهود، وإعادة إحياء كل أشكال التضامن الاجتماعي الشعبية، التي تساهم في التخفيف من بعض المشاكل الاجتماعية أو في حلها؛ كما تعمل على الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية، كما ينبغي إعادة الاعتبار إلى أسبقية الجماعة على الفرد، وتقليم النزعة الفردية، التي «تعوق إمكانية الأمن الوجودي الذي يقوم على الأسس الجمعية، ولا تحض على أفعال التضامن، بل تحث على الاهتمام بالبقاء الفردي وفق مبدأ «نفسي نفسي»، في عالم بلغ من التشظي والتشرذم منتهاه حتى صار شديد التقلب وسريع التغيير»(24) وذلك في مدينة حديثة أصبحت فيها «الروابط الإنسانية فضفاضة تماما، ولهذا السبب نفسه لا يمكن الوثوق بها بتاتا، كما أن التكافل تصعب ممارسته لأن فوائده، بل وفضائله، يصعب فهمها»(25) في هذا السياق المحموم الذي يغلب المصلحة الفردية العاجلة.
وأمام تراجع التكافل الاجتماعي وانعزال الأفراد المدافعين بشراسة عن أنانيتهم الفردية في مجتمعات السوق المفتوحة على كل التقلبات، فإن «انعدام أمن الحاضر وعدم ضمان المستقبل يولدان أبشع مخاوفنا وأشدها؛ ففقدان الأمان في الحاضر وعدم ضمان المستقبل، يصدران بدورهما عن شعور بالعجز، ويبدو أننا لم نعد نسيطر على مجرى الأمور، سواء على المستوى الفردي أو الجمعي»(26).
ولعل تطور تكنولوجيا الاتصال ساهم كثيرا في الإجهاز على ما بقي من مقاومة للتكافل الاجتماعي والقيم الجماعية، رغم أن أننا في الغالب لا ندرك هذا التأثير نتيجة انبهارنا المتكرر بتكنولوجيا الاتصال وافتتاننا بإمكاناتها(27)؛ حيث نغفل عن تأثيراتها التي تُبَنيِنُ الحياة الاجتماعية، وتعيد ترتيب القيم والعلاقات الاجتماعية والتوازنات داخل المجتمع؛ فتكنولوجيا الاتصال ليست مجرد أداة «بل هي تقنية منظِمة للبنيات. فهي تحاول أن تغير تشكل الزمان والمكان الاجتماعيين، والحياة اليومية، تبعا للتوازنات الجيوبوليتكية»(28).
ولا أحد يجادل في الفائدة الكبيرة التي أصبحت تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي للحملات التضامنية؛ إذ أصبح من السهل عرض الحالات التي تحتاج إلى الدعم والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلان بيانات الاتصال، لتتدفق المساعدات المادية والعينية. وهذه الطريقة أبانت عن نجاحها في حالات اجتماعية كثيرة مثل التكفل بمصاريف العلاج والاستشفاء، أو جمع تبرعات لتوفير مسكن لمحتاج أو غيرها من الحاجيات المختلفة.
ومن المعلوم أن تمثل الفرد للهوية ودوائر انتمائه أساسي في إنتاج السلوك التضامني وتحديد دائرته، إذ أننا نتضامن في العادة مع الأفراد الذين نتشارك معهم الهوية والانتماء: فنتضامن مثلا مع أفراد الأسرة لأننا ننتمي معهم إلى نفس الأسرة، ونتضامن مع الجيران لأننا ننتمي معهم إلى نفس الحي، ونتضامن مع زميلنا لأننا ننتمي معه إلى نفس مؤسسة العمل.
لكن تكنولوجيا الاتصال وإن قدمت «مساعدة تقنية» يفترض بها تعزيز الهويات القائمة من خلال تمكين أعضائها من التواصل فيما بينهم وتقوية الروابط العاطفية التي تجمعهم؛ فإنها في المقابل، قد رفعت سقف «الترف الهوياتي» بحيث صار الأفراد متطلبين جدا وهم يتجاوزون الهويات الأصلية (المجتمع، الدين، الثقافة...) وينغمسون في هويات صغرى أكثر إعلاءً للمشترك والتماثل: فبفضل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، صار من السهل البحث عن مجموعات هوياتية صغرى أفرادها يشبهوننا أكثر، في الأذواق والهوايات والأفكار، والتماهي معهم بسهولة أكثر من الجيران أو الأقارب أو «العرب» أو «المسلمين» أو أبناء الوطن، الذين يشاركوننا الانتماء لكنهم يختلفون عنا أكثر مما يشبهوننا؛ إن الهويات الرقمية مغرية: هي ممتعة بما تتيحه من ترفيه وتسلية رقمية، وهي مريحة بما تقدمه من عضوية مجانية لا تترتب عنها أي أعباء اجتماعية ولا التزامات، وهي دافئة بما تقوم عليه من مشترك واسع بين أعضائها.
في المقابل فإن الهويات الفعلية متعبة: يتعين عليك إثبات انتمائك من حين إلى آخر عبر سلوكات وأفعال جسدية ومادية ومعنوية، إذ تحتاج إلى بذل المساعدة، والتنقل لحضور المناسبات السعيدة أو الحزينة، وتقديم التهنئة أو التعزية، وإقراض المال لأفراد قد يماطلون في أحسن الأحوال ويؤجلون السداد، وتحمل أقرباء مزعجين لا تحبهم فرضتهم القرابة عليك، والدخول في سياقات اجتماعية عديدة... فظاهر الهويات الفعلية تعب دائم والتزام فعلي لإثبات الانتماء؛ مقابل متعة بلا التزام مع الهويات الرقمية.. فأيهما يختار المرء؟!
ولعل الواقع الاجتماعي يسعفنا بإجابة فعلية عن ذلك السؤال: والمثال بالجوار؛ حيث ساهم التغيير العمراني والاتجاه نحو البناء العمودي في المدن، في إنتاج مجموعة من القيم التعاقدية التي عوضت القيم التراحمية للجوار، فتجد الشخص لا يكاد يعرف جاره في العمارة التي يقطنها، ولا يتجاوز تواصله معه ابتسامة مجاملة سطحية حينما يلتقيان في المصعد أو في مدخل العمارة، لكنه في المقابل يدخل في دوائر انتماء متعددة ومجموعات تواصل اجتماعي تجمعه بأشخاص يشتركون معه في اهتمامات معينة، لكن تفصلهم مئات أو آلاف الكيلومترات، إن الهوية المشتركة في الإعلام الاجتماعي جد غريبة: قد تضيق ولا تتقبل الجار القريب الذي يشاركك الدين والثقافة واللغة والوطن والسكن؛ لكنها تتسع لتحتضن آخرين من بلاد بعيدة! أما الصداقة باعتبارها إحدى محاضن التضامن الاجتماعي الأصيل، فقد اخترقتها تكنولوجيا الاتصال أيضا؛ فشتان بين الصديق بمعناه التقليدي، الذي يلازمك ويؤنسك وتحرص على لقائه بشكل دوري؛ والصديق المسلي أو المرح في موقع التواصل الاجتماعي: فالثاني قد يؤنسك بل ويفيدك في أحيان كثيرة، لكنه أبدا لا يدعوك لبيته لمشاركته في وجبة غذاء، كما أنك لن تجده إلى جانبك في محنة أو مصيبة: يزورك في مرضك، ويقرضك في أزمتك المالية.
إن الصديق «الافتراضي» في الإعلام الاجتماعي، هو النقطة الأخيرة ربما، التي تغلق دائرة تحول قيم التضامن الاجتماعي من صيغه المألوفة المستمدة من الدين والتقاليد الثقافية العربية الأصيلة، إلى أشكال تضامنية جديدة ومعاصرة؛ فحينما يغطي التأمين على المرض وعلى الوفاة كل عسر مادي محتمل بسبب مرض مفاجئ أو وفاة معيل الأسرة، وحينما توفر القروض البنكية الاستهلاكية خدماتها بسرعة قياسية، تستلم فيها القرض في نفس اليوم أحيانا، وحينما يمكنك إحضار جزار متخصص لذبح أضحيتك وإعدادها بدل الاستعانة بجارك، وحينما يوفر لك موقع إلكتروني كل أخبار العالم ومعينا لا ينضب من التسلية... حينها، يبدو الصديق الافتراضي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من كاف!
كيف ندعم هوية المدينة العربية ونحافظ عليها؟
خلصنا فيما سبق إلى أن هوية المدينة العربية أكبر من أن تحصر في أشكال عمرانية وتصاميم حضرية، إنها مزيج من أشكال العمران وقيم الجماعة؛ حيث بُني العمران باعتباره تجسيدا فضائيا لقيم الجماعة، وموجها عمليا لكل أشكال الحياة الاجتماعية بما ينسجم وقيمَ الجماعة. وفي نفس الوقت، أصبح العمران أيضا وسيلة لحفظ قيم الجماعة واستمرارها واستمدادها في اليومي.
لذا فإن كل الجهود التي تسعى إلى الحفاظ على هوية المدينة العربية من خلال ترميم بناياتها، وإعادة إحياء التصاميم العمرانية الأصيلة ومحاكاتها في البنايات الجديد والتخطيط الحضري الحديث، هي جهود مهمة وأساسية للحفاظ على هوية المدينة العربية ولا بد من الاستمرار فيها؛ لكنها غير كافية إذا لم ترافقها عمليات «ترميم» القيم العربية وإحيائها؛ فبدون أفراد يتمثَّلون القيم العربية الأصيلة ويحيون بها، فإن كل التدخلات والجهود العمرانية ستفرز بنايات بدون روح؛ لن تفلح في مقاومة المد الاستهلاكي الذي يقوض كل جماليات الحضارة.
وعليه، فإن تعزيز هوية المدينة العربية واستدامتها يتحقق فقط بالمزاوجة بين الحفاظ على الأشكال العمرانية الأصيلة وإحيائها؛ وبين دعم الهوية الجماعية وقيمها في المجتمعات العربية، وذلك من خلال تعزيز البنيات المجتمعية المحافظة على القيم الجماعية والجماليات الأصيلة والمؤسسة لتقاليدها وأعرافها الحامية. فكيف يتحقق ذلك؟
1) استلهام الأنماط العمرانية التقليدية والتصاميم الأصيلة في المدينة العربية:
إن المدينة العربية الحديثة تشكل خليطا غير منسجم بين بنيات عمرانية تقليدية صيغت وفق قيم أصيلة هي في تراجع الآن، وبنايات حديثة تقوم على قيم حداثية وظيفية قد لا تكون سائدة اجتماعيا بشكل فاعل، وبنايات عشوائية نمت تدريجيا دون تخطيط ولا رؤية استراتيجية.
لذلك، ينبغي الانتباه إلى أن كل شكل عمراني يتجاوز تعينه المادي باعتباره فضاءً إسمنتيا، ليعكس قيما وتصورا معينا للعلاقات والوجود واختيارات جمالية، وعلى رأي جان بودريار « فإن العمارة تُترجِم عالَمًا بأكمله»(29). فنمط العمارة الغربي، ينسجم تماما مع القيم الغربية التي نمت تدريجيا في حضن المجتمع، وكان يعكس دوما وما يزال هوية المجتمعات الغربية، لذا فبالموازاة مع الأدبيات المبشرة بما بعد الحداثة في السياق الغربي، ظهرت منذ الستينيات من القرن الماضي تصاميم هندسية وإبداعات فنية ما بعد حداثية، تستلهم روح وقيم ما بعد الحداثة(30)، حيث «يخلص جيمسون(31) من تحليله للطراز المعماري للفندق [يقصد فندق بونافنتور « Bonaventura hotel» ذو التصميم ما بعد الحداثي] إلى أنه يُجسِّد «التجلِّي المعماري لمفهوم سقوط سلطة الإنسان وهيمنتِه على الوجود؛ إذ لم يَعُد هو محور الحياة ومركزها.» وقد كرَّس المعماريُّون ذلك المعنى عن طريق عمل واجهات زجاجية مرآوية عاكسة ضخمة، بحيث يَقف الرائي عند مدخل البناية فيرى انعكاس العالم والأبنية المُقابلة للمبنى، ويرى صورته كذلك فيجد نفسه ضئيلًا موغلًا في التقزُّم والتشظِّي وسط العالم والضجيج المنعكس أمامه. وبحسب جيمسون، فإن واجهات الزجاج العاكس للفندق إنما تهدف إلى «طرد المدينة خارجيًّا»؛ لإبقاء الرائي بعيدًا من أن يرى، وجعل صلة الفندق بالجوار أقرب إلى «القطيعة الخاصة من دون مكان» (وهو طردٌ تُماثله النظارات الشمسية العاكسة التي تجعل من المُستحيل على محدثك رؤية عينيك، مما يَمنحك أفضلية وسلطة عليه)»(32).
لذا فحينما يتم تقليد هذا النمط في المدينة العربية، فإنه يجلب معه إطارا موجها ناعما، يفرض قيمه وتفضيلاته الجمالية.. هذا الإطار الموجه يعمل ببطء إضافة إلى عوامل أخرى، على إحلال قيم البناية الحديثة في منظومة القيم المجتمعية؛ وهذا ما مثلت له سابقا بصغر الشقق التي تمنعنا قسرا من استضافة عدد كبير من أفراد العائلة، وما يترتب عن ذلك من ممارسات تفضي إلى تراجع قيم الكرم، والإيثار، والتعاون، والتكافل، وروح الجماعة...
لذا فنحن «في حاجة ماسة إلى أن نفيد في تخطيط مدننا من استلهام الروح العربية في الصياغة والتشكيل، لأن لكل أمة روحها، منها الروح الموسيقية والشعرية في تناسقها، مع الاعتماد أيضًا على ما يفترضه المستقبل من حاجات مستجدة يدفع في اتجاهها العصر والتطور، ذلك أنه لا يمكننا أن ننفصل عن العالم، بيد أن اتصالنا به يجب أن يكون من موقع واعٍ وحي»(33).
2) تعزيز القيم الاجتماعية والجمالية العربية:
ينبهنا كل من رتشارد ثالر وكاس سنشتاين إلى أننا نتعرض يوميا إلى كثير من التوجيهات الخفية خصوصا من الشركات التجارية، والتي تدفعنا دون أن نشعر إلى اتخاذ قرارات معينة والقيام بتفضيلات قد لا تخدم مصلحتنا في الغالب، وقد وسع الباحثان دراستهما لتحليل كل التوجيهات الكامنة في تصميم الخيارات المختلفة، وفي تصميم البنايات والأبواب والأدوات؛ وأوضحا كيف يمكن لطريقة عرض الخيارات أن تكون موجهة لنا - دون أن نشعر- نحو اختيارات بعينها.
وفيما يتعلق بالعمران تحديدا، يقول الباحثان: «وكما يعلم المعماريون البارعون، يكون للقرارات الاعتباطية في الظاهر، كتحديد مكان وجود الحمامات، تأثير دقيق على كيفية تفاعل من يستخدمون المبنى. فكل زيارة للحمام تتيح الالتقاء بصديق (سواء أكان ذلك جيدا أم سيئا). المبنى الجيد لا يكون جذابا فحسب، وإنما يحدث تفاعلا أيضا. إن التفاصيل الصغيرة وغير المهمة في الظاهر قد تكون ذات تأثيرات كبيرة في سلوك الناس. والقاعدة العملية الجيدة هي أن نفترض أن «كل شيء يهم». وفي كثير من الحالات، تتأتى قوة هذه التفاصيل الصغيرة من تركيز اهتمام المستخدمين في اتجاه معين»(34).
وقد كانت استراتيجيات التنبيه التي اقترحها الباحثان ملهمة للعديد من السياسيين عبر العالم؛ ونحن نقترح الإفادة منها في تصميم الخيارات عموما والبنايات خصوصا بشكل يستلهم القيم العربية الأصيلة، ويعززها من خلال توجيه الأفراد نحو الالتزام بها. فالحفاظ على هوية المدينة العربية، يتطلب أيضا الحفاظ على القيم المشكلة لهذه الهوية. لذا نقترح على المسؤولين اعتماد تصاميم عمرانية وتصاميم خيارات وإجراءات موجهة للأفراد نحو السلوكات النابعة من القيم العربية الأصلية.
ونحن نقترح أن تقوم الجهات الوصية والمسيرة لشؤون المدينة بتحديد القيم العربية الأصيلة والتوجهات الجمالية التي تعكسها المدينة العربية التقليدية وتقوم عليها، (مثل: التوازن بين الجمال والوظيفة، والنظام، والتناسق، وأسبقية الجماعة على الفرد، والتواصل الإنساني، والاحترام، والتضامن، وترشيد الموارد...) ثم تحاول أن تبدع في تجسيدها من خلال تصاميم عمرانية وتخطيطات حضرية تستلهمها؛ لأن تعزيز هذه القيم يضمن للمدينة العربية روحها واستمرارها.
ويمكن اعتماد مجموعة تصاميم عمرانية تحاكي النمط العمراني العربي الأصيل، وإلزام الأفراد الذين يشيدون منازلهم الفردية بالاختيار حصرا من بينها؛ وبناء وتصميم جميع بنايات الدولة ومؤسساتها وفق النمط العربي الأصيل. مع الحرص على تشجيع الامتداد الأفقي في البناء من خلال استصلاح البلديات للأراضي وتسويتها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البناء الأفقي من خلال اعتماد التصاميم العربية، وذلك لأن البناء الأفقي يحفظ قيم الجوار عكس البناء العمودي.
وذلك بالموازاة مع الاهتمام بتعزيز المكون الأخلاقي والقيمي في المناهج التعليمية؛ واعتماد حملات للتسويق الاجتماعية، لتعزيز القيم العربية والسلوك المتحضر بين الأفراد؛ والإكثار من الحدائق العامة والمنتزهات، وتصميمها بشكل يحث على اللقاء والتواصل، مع تجنب تزويدها بخدمات الوايفاي (عكس التوجه السائد حاليا) التي تؤدي إلى انفصال الناس عن بعضهم وانعزالهم وعدم تمتعهم بجمال الحدائق؛
كانت هذه بعض الأمثلة لما تستطيع السلطات المحلية القيام به دعما للقيم العربية الأصيلة، والتي كلما كانت حاضرة أكثر في الفضاء الاجتماعي للمدينة العربية، إلا وكانت هوية المدينة العربية أكثر تماسكا وأكثر قربا من نموذجها النقي والأصيل.
خاتمة
إننا نبتعد يوما بعد يوم عن قيمنا العربية الأصيلة ونمط عيشنا التقليدي؛ مفتونين بغواية الحياة المعاصرة، ومشدوهين أمام رسائل وسائل الاتصال المعولمة؛ في حين يثبت الواقع يوميا، أن قيمنا العربية الأصيلة ونمط عيشنا التقليدي هما الكفيلان فقط بتدبير أمثل للموارد الطبيعية والحياة الكريمة.. وكما تتحدث الأدبيات الاقتصادية عن التنمية المستدامة باعتبارها تنمية تضمن للأجيال الحالية العيش الكريم، وتحفظ للأجيال المقبلة حقهم في موارد طبيعية متوافرة وسليمة؛ فإنني أدعو أيضا إلى استدامة هوية المدينة العربية، باعتبارها ضامنا لحق الأجيال المقبلة في العيش الكريم في فضاءات عمرانية جميلة؛ ولحقهم في حياة اجتماعية تكافلية تخفف صعوبة الحياة المعاصرة وتمتص الكثير من أزماتها.
فرقعة الفقر تتسع يوميا، والطبقة المتوسطة تزداد هشاشة، والمشاكل لم تعد محلية فقط، بل عالمية تتضاعف بشكل يفوق قدرة الدولة على احتوائها؛ لذا فالحاجة ملحة أكثر إلى تماسك المجتمع وتضامنه؛ لأن كيانات الدفاع الجمعي وحدها تستطيع صناعة الفارق.
وكما بدأت هذه الدراسة بالحديث عن انعدام الأمان في المدينة وتحولها إلى ساحة للعنف والخوف، فإنني أختمها بنفس الموضوع لكن على نحو مختلف: كنت محظوظا بزيارة مدينة الكرك جنوب الأردن للمشاركة في مؤتمر علمي في جامعة مؤتة في نهاية عام 2019؛ وأثناء جولتي المسائية في المدينة فوجئت بالسيارات المركونة في الشوارع بزجاج نوافذها المفتوح دون حارس ولا رقيب، وحينها تعلمت درسا بليغا؛ إذ تعلمت أن التحصينات والأسوار وكاميرات المراقبة ورجال الأمن الخاص، هي إجراءات قد تضمن للأفراد السلامة؛ لكنها أبدا لا تمنحهم الإحساس بالأمان ونعيم الطمأنينة؛ إن الأمان والطمأنينة لا ينبعان إلا من مجتمع متماسك ومعتز بانتمائه وقيمه، ومتمسك بهويته؛ تلك هي الهوية العربية التي نرجو استدامتها لتشكل فضاء مدينة عربية آمنة تسكنها الطمأنينة ويؤثثها الجمال.
الهوامش :
1. Nan Ellin, “Shelter from the Storm or Form Follows Fear and Vice Versa,” in Architecture of Fear, ed. Nan Ellin , New York: Princeton Architectural Press, 1997, pp 13 & 26.
2. ليست مدينة تطوان المغربية القديمة وحدها التي عملت على إلغاء التمييز الطبقي بين الفقراء والأغنياء من حيث التجلي العمراني الخارجي لمظاهر الثراء، بل يمكننا أن نعتبر ذلك سمة عامة للمدينة العربية، حيث أشارت جانيت أبو لغد إلى أن المدينة العربية القديمة حرصت على إخفاء التمييز الطبقي قد الإمكان. أنظر:
- Janet Abu Lughud, "Varieties of Urban Experience: Contrast, co- experience and Calescence in Cairo", in: Middle Esstern Cities, ed. By ar. M. Lapidus, Los Angeles 1959.p.183
3. Philippe Boudon, Sur l’espace architectural : Essai d’épistémologie de l’architecture, Collection Eupalinos. Série architecture et urbanisme, Marseille: Editions Parentheses, 2003, p. 10.
- بوساطة عن: إدريس مقبول، المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض التمدن، دورية عمران للعلوم الاجتماعية، فصلية محكمة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 16، ديسمبر 2016، ص 50.
4. عبد الهادي التازي، تصميم المدينة من خلال المصادر العربية والأجنبية، المدينة في تاريخ المغرب العربي، أشغال الندوة المنظمة ما بين 24 و26 نونبر 1988، الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك، 1988، ص 17.
5. George Nicholson, "The Rebirth of Community Planning " in: Andy Thornley, ed., The Crisis of London, London; New York: Routledge, 2005, p. 94.
6. إدريس مقبول، المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض التمدن، ص 53.
7. أنظر: سابا جورج شبر، العلم وتنظيم المدن العربية، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، 1964.
8. James T. Bennett and Thomas J. DiLorenzo, From Pathology to Politics: Public Health in America, New Brunswisk, NJ: Transaction Publishers, 2008, p. 67.
9. أنظر: أحمد منصور، ثقافة الفوضى: مصر والعالم العربي اليوم، دار الشروق، القاهرة، 2009.
10. نبيل طعمة، التشكيل والحِس الثقافي في تكوينات المدينة العربية، مجلة الأزمنة، الافتتاحية. العدد 25 -تموز 2009. دمشق، سورية.
11. سالم معروف المعوش، المدينة العربية بين عولمتين، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 2006.
12. إدريس مقبول، المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض التمدن، ص: 53.
13. إدريس مقبول، المرجع نفسه، ص: 53.
14. Bulent Diken and Carsten Bagge Laustsen, Zones of indistinction: Security, terror, and bare life, Space and culture. Volume: 5 issue: 3, August 2002. pp 290-307.
15. وعلى الأرجح في عموم الدول العربية مع الطابع المحلي للأمثلة والنماذج.
16. حسين عبد الحميد رشوان، مشكلات المدينة: دراسة في علم الاجتماع الحضري، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، ط2، 1984، ص 5.
17. Peter J. Taylor, Extraordinary Cities: Millennia of Moral Syndromes, World-systems and City/State Relations, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013, p. 297.
18. Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, New York: Museum of Modern Art in association with the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, 2002, p. 20.
19. إدريس مقبول، المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض التمدن، ص: 51.
20. زيغمونت باومان، الأزمنة السائلة: العيش في زمن اللايقين. ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان. ط 1، 2017. ص 25.
21. Georg Simmel, La Parure et autres essais, trad. et présentation de Michel Collomb, Philippe Marty et Florence Vinas, Philia. Paris: Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 20.
22. زيغمونت باومان، الأزمنة السائلة: العيش في زمن اللايقين. ص 101.
23. إدريس لكراوي، إشراف، الحماية الاجتماعية في العالم العربي، سياسات مقارنة، شبكة المغرب للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، ط1، 2012، ص: 19.
24. زيغمونت باومان، الأزمنة السائلة: العيش في زمن اللايقين. ص 37.
25. المرجع نفسه، ص 46.
26. نفسه، ص 48.
27. لمزيد من الأمثلة والنماذج المفصلة عن التأثيرات الاجتماعية لتكنولوجيا الاتصال في حياتنا، أنظر:
- هشام المكي، الإعلام الجديد وتحديات القيم، طوب بريس، الرباط، المغرب، ط 1، ديسمبر 2014.
28. بيير ليفي، ميتولوجيا، سلسلة ضفاف، سلسة تعريبات يشرف عليها الدكتور محمد سبيلا. الكتاب الخامس عشر: إشكاليات الفكر المعاصر، ترجمة محمد سبيلا، ط1، 2009، ص: 217.
29. جان بودريار وجان نوفيل، الأشياء الفريدة: العمارة والفلسفة. ترجمة: راوية صادق. دار شرقيات، القاهرة، 2003، ص 12.
30. للاطلاع على صور ونماذج متعددة لبنايات وتصاميم عمرانية ما بعد حداثية، بالإضافة إلى تحاليل تبرز المقولات الفلسفية التي تعكسها، أنظر الفصل الثالث "التجربة الجمالية ما بعد الحداثية" من كتاب:
- بدر الدين مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط 1، 2018. ص ص: 67- 132.
31. Buchanan, Ian. Practical Deleuzism and Postmodern Space. in Martin Fuglsang and Bent Meier Sørensen(eds) Deleuze and the Social, London: Edinburgh University Press, 2006. p. 140
32. بدر الدين مصطفى، دروب ما بعد الحداثة. ص 99.
33. إدريس مقبول، المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض التمدن، ص 72.
34. رتشارد ه. ثالر وكاس ر. سنشتاين، التنبيه: تحسين القرارات بشأن الصحة والثروة والسعادة، ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 1، 2016، ص 12.
الصور:
- من الكاتبة.
- - تنويه: الصور العمودية الواردة في الدراسة هي بعدسة الباحث، بينما الصور الأفقية، هي من تصوير وإهداء الصديق والمصور الفوتوغرافي بوعياد إمناشن. (bouayad1959@gmail.com)