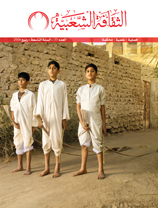الثقافة الشعبية النسق، والوظيفة، والخطاب
العدد 28 - آفاق

لا يمكن التفكير في قضية الثقافة بمعناها العام وقضية الثقافة الشعبية بمعناها الخاص دون الانفتاح على أسئلة متشابكة يتداخل فيها المعطى الثقافي بالمعطى التاريخي والسياسي والخطابي، لأن الثقافة ظاهرة مركبة بطبيعتها وتستضمر هذه الأبعاد مجتمعة. ولما كانت “الثقافة ظاهرة مركبة تستجمع مجالات عديدة(1)”، فإنها لا يمكن أن تكون موضوعا للدراسة دون مقاربة مركبة بدورها.
وفي مجال العلوم الإنسانية هناك العديد من المواضيع التي تستعصي على التحليل المِطْواع، وتطرح مشاكل عديدة على مستوى التعريف والمنهج والاصطلاح، ولعل الثقافة الشعبية أحد هذه المواضيع، وذلك لأن “مفهوم الثقافة الشعبية يغطي مجالا واسعا جدا يتقاطع مع مجال الثقافة الجماهيرية culture de masse. العديد من الحقول المعرفية أقبلت على تحليل وتقويم الثقافة الشعبية ودراسة علاقاتها بالثقافة الجماهيرية، ومن بين هذه الحقول: علم الاجتماع والتاريخ واللسانيات والتحليل النفسي والدراسات الأدبية. وكل واحدة من النظريات المتولدة عن تداخل هذه الحقول أنتجت -في ضوء منطلقاتها النظرية الخاصة- تعريفا خاصا للثقافة الشعبية، وهكذا حصلنا على تعريف بنيوي، وآخر سيميولوجي، وآخر ماركسي، وآخر نسوي، وآخر ما بعد حداثي، وآخر حواري، الخ(2)».
ومن الحصيف أن نشير –على سبيل تسجيل بعض المعطيات النظرية الأولية- إلى أمرين في غاية الأهمية:
1 - التفكير في قضية الثقافة الشعبية يعتبر بدوره قضية وممارسة ثقافيتين، أي مكونا من مكونات اشتغال التأمل الثقافي في مجتمع معين، ومحتوى من محتوياته، ورهانا ذا علاقة وطيدة بقضية الهوية.
2 - لا يمكن التفكير في الثقافة الشعبية بمعزل عن الحمولة الثقافية التي يصدر عنها الدارس، فكما لا يمكن للإنسان أن يفكر في العقل إلا بالعقل، فكذلك ليس بإمكانه التفكير في الثقافة إلا بالثقافة، وبذلك تصبح الثقافة دراسة وموضوعا للدرس في الآن نفسه.
3 - هناك اختلاف في فهم الثقافة الشعبية بحسب المرجعية الحضارية المعتمدة، فـ«الأدب الفرانكفوني يصف الثقافة الشعبية أحيانا كثقافة عمالية، وثقافة جماهيرية وثقافة بدوية، أو بكل بساطة ثقافة مرتكزة على (التقاليد الشعبية)، أما في المرجعية الأنغلوفونية فالثقافة الشعبية ظاهرة حديثة، إنها ثقافة المدينة أو ثقافة الضواحي، وقد ولدت في سياق الحركة الاجتماعية والثقافية الهادرة المقترنة بحركة التصنيع الأمريكي والتطورات والأزمات التي خلفت آثارها في عالم ما بعد الحربين العالميتين(3)”. لكن في الكثير من الحالات يستعمل مفهوم الثقافة الشعبية بطريقة موسعة تستوحي كلتا المرجعيتين.
وفي كل الحالات لا يفكر الإنسان في قضايا الهوية والثقافة والدين والتاريخ واللغة إلا حين تعتريه لحظة وعي مفاجئ أو مستعاد بأن هذه القضايا جزء منه بقدر ما هو جزء منها، لكن هناك من يفسر انتعاش التفكير الثقافي بعامل آخر كما هو الأمر عند جيرار لونكلود الذي يقول: “ إن التفكير الثقافي ينتشر حيثما غابت البداهة، وحيثما شاع اللايقين، وهذا المجال من التجربة الذي يغطي جانبا كبيرا من الأسئلة (الفلسفية) التقليدية هو الذي يُظهِر فيه الناس –بأكبر قدر من الذكاء والإبداع- ما يميزهم عن بعضهم(4)”، لأن الثقافات مجال الاختلاف بامتياز.
في ضوء هذا المعطى الأولي، يمكن القول إن الثقافة الشعبية جزء من النص الثقافي العام للمجتمع، وموضوع ممكن من مواضيع التأمل الثقافي في الآن نفسه. يمكن طبعا أن نفكر في الثقافة الشعبية من منطلقات نظرية مختلفة وبترتيبات تحليلية وإجرائية متباينة، لكن المحتوى الثقافي للثقافة الشعبية يفرض نفسه في نهاية المطاف، ويتطلب بالتالي الانفتاح على التحليل الثقافي للثقافة الشعبية لكن بتكامل مع التحليل السياسي والاجتماعي والأنتربولوجي، بل وحتى الإيديولوجي لأن “المعرفة التي تُبْنَى بخصوص هذه القضية ليست أبدا مستقلة عن الشروط الاجتماعية والتاريخية المتحكمة في إنتاجها(5)”.
وهذا المدى النظري المفتوح هو ما نقترح ملامسة بعض جوانبه في هذا المقال مسترشدين بالأسئلة التوجيهية التالية: ما الثقافة الشعبية؟ ما هي وظائفها الثقافية والتاريخية؟ ما هي أوجه خطابيتها بوصفها تعبيرًا عن هويةٍ وتَجْلِيَةً رمزية لخصوصية مفترضة؟ ما علاقتها بالنسق الثقافي العام؟ هل هي نسق قائم بذاته أم هي نسق ملحق وبنية مستضمرة؟ ثم كيف يمكن للثقافة الشعبية أن تكون موضوعا للدراسات الثقافية؟
مدار التعريف: ما الهوية الثقافية؟
يؤكد فيكتور ثيبودو أن “التعريف خطاب، ويتمثل موضوعه تحديدا في تفسير جوهر شيء معين(6)”، ومعنى هذا أن صياغة تعريف معين لا ينفصل عن نوع الخطاب الذي نبنيه ونصدر عنه، ولا شك أن الخطاب حول الثقافة الشعبية ينطوي على رهانات تتجاوز المعطى الثقافي إلى ما هو سياسي واجتماعي وإنساني. وهو أمر سنتوقف عنده لاحقا، لكن في ما يخص تعريف الثقافة الشعبية، لم يكن الأمر محسوما أبدا على الوجه الذي يتيح توفير تعريف جامع مانع ومتفق عليه، مما يعني أنه من نمط التعريفات الإشكالية، والدليل على ذلك أن “تعريف الثقافة الشعبية (أو الثقافات الشعبية) كان على الدوام موضوعا للأخذ والرد، فمنذ بداية القرن التاسع عشر كان هذا المفهوم يُستعمل بدلالات فضفاضة تتراوح بين تعريف ضيق وآخر واسع جدا، فالبعض يفهمونه بمعنى الثقافة البدوية والعمالية، وثقافة الطبقات الشعبية بل وحتى الثقافة البروليتارية، أما البعض الآخر فيفهمون الثقافة الشعبية بمعنى الثقافة الوطنية(7)”.
إن اختلاف التصورات بشأن الثقافة الشعبية، وربطها تارة بثقافة الطبقات الشعبية أو العمالية، وبالثقافة الوطنية تارة أخرى قد يعني ضمن ما يعنيه أن الثقافة الشعبية لا تُعَرَّفُ بذاتها بل بعلاقتها القائمة أو المفترضة بينها وبين الطبقات الاجتماعية أو الوطن. ومن الواضح طبعا أن هذا الأمر لا يلقي الضوء على جوهر الثقافة الشعبية من حيث هي ماهية في ذاتها، ولا يعرفها بما هي عليه أي بحقيقتها المفترضة. وتلك مسألة متعلقة إشكاليا بكون مفهوم “الثقافة الشعبية” نفسه ينطوي على “تناقضات..لأنه فضفاض وغامض ومبهم ومحمل بالتباسات وسوء فهم، لذلك هناك –في الكثير من الأحيان-تركيز كبير على التذكير بالصعوبة الفعلية التي تحول دون تحديد ملامح هذه الظاهرة، والآثار متعددة الأشكال المتعلقة بها، وغالبا ما يقود ذلك بسهولة إلى الشك في وجود ظواهر الثقافة الشعبية نفسها (8)”.
ما يمكن أن نفهمه من هذه المعطيات هو أن تعريف الثقافة الشعبية ليس أمرا سهلا، إنه من نمط التعريفات الإشكالية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وهو أمر يؤكده ريمي طورانجو(9). بل إن فالديفيا يذهب إلى “أن مفهوم الثقافة الشعبية من أكثر المفاهيم خضوعا للمناقشة والسجال، بل إن بعض الدارسين يعتبرونه مفهوما فارغا an empty concept يملؤه أشخاص مختلفون في أزمان مختلفة بأغراض مختلفة(10)”.
ويتصادى هذا الرأي عند دارسين آخرين بتلوينات متقاربة، لكنها تؤكد في مجملها أن مفهوم الثقافة الشعبية لا يحظى بالإجماع، ولا يعتبر في كل الحالات من المفاهيم التي ارتقت إلى مستوى الوضع الاعتباري المحسوم والبديهي، والدليل على ذلك أن طوني بينيط مثلا يتحدث عن هذا المفهوم حديثَ رفضٍ ومُصادَرةٍ قائلا: “من الناحية العملية، يعتبر مفهوم الثقافة الشعبية عديم الفائدة، إنه خليط من الدلالات الملتبسة والمتناقضة التي من شأنها تضليل البحث وحشره في مسارات نظرية مختلفة(11)”.
والأمر العجيب فعلا هو أن رغم هذا التشكيك المتواتر في جدوى مفهوم الثقافة الشعبية وصعوبة تعريفه، هناك اهتمام كبير جدا بهذا الحقل المعرفي على المستوى العالمي، والسبب في هذا الاهتمام هو “الوعي بأهمية الثقافة الشعبية من حيث هي عامل تماسك اجتماعي وحركية اقتصادية(12)”.
ويرجع أنتيغون موشطوري صعوبة تعريف الثقافة الشعبية إلى ثلاثة عوامل، يقول: “إن صعوبة تعريف هذا الحقل ترتبط بثلاثة عوامل جوهرية:
- إنه يغطي وقائع عديدة،
- يستند إلى فرضيات إبستيمولوجية،
- ينتمي للحقل السياسي، والإيديولوجي، والسوسيو-أنتربولوجي(13)”.
إنه مفهوم يقع إذن في مفترق العديد من الحقول، ويدل على أشياء عديدة، ويخضع لتوظيفات تتداخل فيها الرهانات السياسية والإيديولوجية والاجتماعية والأنتربولوجية. ومن الواضح طبعا أن المفاهيم التي تكون على هذا النحو من التعقيد والتعالق تطرح صعوبة كبيرة على مستوى التعريف، لأن “أبعاد المفاهيم المركبة تكون دائما مستعصية على التحديد الدقيق (14)”.
لكن هذا النوع من الوعي الإشكالي بمفهوم الثقافة الشعبية، لم يقف أمام الرغبة المحمومة في تعريفها، لأن رغبة التعريف تنطوي لدى الإنسان على الرغبة في ممارسة سلطة العقل على الأشياء، وبهذا المعنى فـ “التعريفات..ليست مواضعات لغوية ورموز اعتباطية، بل هي التعبير الصارم عن الحدس المباشر الذي يميز الكائنات الواقعية(15)”.
و على سبيل الاستئناس والتقريب نقترح بعض التعريفات التي تم اقتراحها بخصوص الثقافة الشعبية معتمدين في ذلك على منظورات مختلفة:
- منظور رسمي: وفي هذا الإطار يمكن أن نستحضر التعريف الذي ورد في القانون الفلاماني المنظِّم لشروط تموين المنظمات المهتمة بالثقافة الشعبية، وهو قانون صادر عن البرلمان الفلاماني بتاريخ 27 أكتوبر 1998م. وقد ورد في بنده الأول المندرج تحت الفصل الثاني ما يلي: «الثقافة الشعبية هي كل التعبيرات الجماعية، التقليدية أو غير التقليدية الخاصة بالحياة الفولكلورية(16)».
- منظور سوسيولوجي: وهو من أكثر المنظورات المعتمدة في مقاربة الثقافة الشعبية وتعريفها، ويمكن أن نستحضر في هذا الإطار التعريف الذي أورده عالم الاجتماع الفرنسي جوفر دومازوديي الذي قال: «الثقافة الشعبية بمعناها الضيق هي مجموع الدلالات الثقافية المتمازجة مع أوقات الفراغ الشعبية(17)».
أما ريشارد مونيك فيعرفها من خلال مكوناتها فيقول: «تتكون الثقافة الشعبية من مجموعة من الاصطناعات التي تُنْتَجُ من أجل وبواسطة مستعملين نوعيين، وتترافق هذه الاصطناعات بممارسات اجتماعية(18)».
ما يلاحظ في هذه التعريفات أنها لا تتطابق على مستوى التصور أو المصطلحات المستعملة في التعريف، فالتعريف الأول ينظر إلى الثقافة الشعبية بوصفها «تعبيرات جماعية ذات صلة بالحياة الفولكلورية»، أما التعريف الثاني فينظر إليها بوصفها « دلالات ثقافية متمازجة مع أوقات الفراغ الشعبية»، أما التعريف الثالث فينظر للثقافة الشعبية بوصفها «اصطناعات تترافق بممارسات اجتماعية».
ويمكن إدراج هذه المعطيات في جدول توضيحي ومقارن كالتالي:
| منظور سوسيولوجي | منظور سوسيولوجي | منظور رسمي |
| الثقافة الشعبية “اصطناعات تترافق بممارسات اجتماعية” | الثقافة الشعبية “دلالات ثقافية متمازجة مع أوقات الفراغ الشعبية” | الثقافة الشعبية “تعبيرات جماعية ذات صلة بالحياة الفولكلورية” |
| الثقافة الشعبية اصطناع | الثقافة الشعبية دلالة | الثقافة الشعبية تعبير |
في ضوء هذه المنظورات الثلاث، تبدو الثقافة الشعبية تعبيرا أو محتوى التعبير (دلالة) أو اصطناع. وهي ثلاث أمور لا تعني بالضرورة نفس الشيء، لكنها قد تتدامج بهذا القدر أو ذاك في أي تعريف ممكن للثقافة الشعبية التي تعتبر تعبيرا ودلالة واصطناعا في الوقت نفسه.
لكن ما نلاحظه في هذه التعريفات هو أنها لا تعرف الثقافة الشعبية بما هي عليه، بل بما تتضمنه من اصطناعات. وهو نوع من الالتفاف على إشكالية التعريف، ويمكن أن ننظر إلى ذلك بوصفه مؤشرا ضمنيا على أن الثقافة الشعبية تستعصي على تعريف الماهية، وهي لهذا السبب تعرف إما بمضمونها كما هو الأمر في التعريفات التي أوردناها أعلاه، أو تعرف بعلاقاتها وتقابلاتها مع الثقافة العالمة la culture savante أو الثقافة البدوية la culture paysanne ، أو الثقافة الحضرية urbaine la culture أو الثقافة العمالية la culture ouvrière، أو الثقافة الجماهيرية التي يقول عنها دومينيك ستريناتي إنها ظهرت “في عصر السينما والراديو والإنتاج والاستهلاك الواسعين للثقافة، وصعود الفاشية ونضج الديمقراطيات الليبرالية في بعض المجتمعات الغربية(19)”.
وفي كل الحالات فإن وجود مفهوم الثقافة الشعبية ضمن هذه الشبكة الواسعة من المفاهيم المجاورة هو أحد الأسباب التي قادت عالم الأنتربولوجيا الأرجنتيني نيسطور غارسيا كانكليني إلى المطالبة بـ «إعادة تعريف الثقافة الشعبية..التي لا يمكن أن نفكر فيها ببساطة من خلال تقابلها مع الثقافة البورجوازية، وهو تقابل أغرقتها فيه الحداثة، ولا يمكن كذلك أن نفكر فيها من خلال التقابل مع الثقافة العمالية، أو الجمع بينها وبين (ثقافة الطبقات الشعبية)(20)».
ومن الجدير التنبيه إلى أن تعريف الثقافة الشعبية عند الغربيين أمر صعب بالفعل، والسبب في ذلك مرتبط نسقيا بالواقع الثقافي والحضاري الغربي نفسه لأن الممارسات الثقافية والتمثيلات الرمزية في الغرب انتظمت وفق الهيكل الاجتماعي الغربي الذي تحددت فيه ملامح الطبقات الاجتماعية بأقصى درجة من الوعي السياسي والاجتماعي، وهو أمر لم يحدث بعد في المجتمعات ذات البنية التقليدية أو شبه التقليدية كما هو الحال مثلا في الواقع العربي الذي ما زالت فيه الطبقات الشعبية -بمعناها الإثنولوجي والأنتربولوجي- تمثل جانبا كبيرا جدا من محتوى الوعي الاجتماعي والثقافي، مما يجعل الحديث عن ثقافة شعبية –في الواقع العربي مثلا- حديثا ممكنا وواردا لأنه مفهوم يملك معادلاته وتمثيلاته الواقعية المرئية والقابلة للملاحظة والتصنيف. بل إن مفهوم الثقافة البدوية أيضا يسهل إجراؤه على الواقع العربي الذي ما زالت الكثير من بنياته بدوية الطابع، بينما لا نجد البداوة مكونا اجتماعيا مهيمنا في التنظيم الاجتماعي الغربي، ولذلك «من الواقعية القول إن الثقافة البدوية قد ماتت منذ أن ماتت المجتمعات البدوية في الغرب(21)».
إن ما يميز الفضاء الغربي إذن أن نضج “الثقافة البورجوازية” حولها إلى ثقافة مهيمنة بسبب تحكم الطبقة البورجوازية في أدوات الإنتاج الصناعي وملحقاته الإعلامية والسياسية والحزبية والمؤسسية، بما فيها المؤسسات الثقافية أو مؤسسات “الإنتاج الخطابي للمعنى(22)” بتعبير كارول لوفاسور.كما أن «الثقافة العمالية» فرضت نفسها بوصفها ثقافة الرد أو ثقافة مضادة contre-culture، وتحولت إلى نسق ثقافي قائم بذاته لأنها عبرت عن طبقة تحققت لها تاريخيا شروط الوعي بذاتها وبموقعها الاجتماعي وطموحاتها السياسية. ومن جهة أخرى أتاح التنظيم الاجتماعي الغربي تقليص مدى الثقافة الشعبية، وشجع ظهور مفاهيم جديدة مثل «الثقافة الحضرية» بحكم تقلص جغرافية البداوة في البلدان الغربية وتوسع مدار المعنى الثقافي المديني. وهذا أحد أكبر التحولات التي أعادت توزيع المواقع الثقافية في الغرب، خاصة إن علمنا أن «الثقافة الشعبية رغم أنها تتلقى وتستهلك وتقوم بتعديل التقاليد التي لا تنبع دوما من الشعب، إلا أن النواة الصلبة التي تمنحها انسجامها وديناميتها تأتي فعلا من الجماهير، وخاصة من عالم البادية الذي كان يمثل 90 في المائة من السكان في فرنسا في سنة 1550م».
وبموازاة مع ذلك ظهر مفهوم آخر هو «الثقافة الجماهيرية» la culture de masse التي يعرفها جان بول غابيليي بأنها «كل ما تنتجه الصناعة الثقافية(23)»، مع العلم أن الصناعة الثقافية هي تلك الآلة من الإنتاج التي تتحكم فيها الطبقات الممسكة بالسلطة، ونقصد بها الطبقات البورجوازية. وفي هذه الحالة تكون الثقافة الشعبية – كما وصفها أنطونيو غرامشي-هي ثقافة الطبقات المُهَيْمَنِ عليها في المجتمع، أو هي المجال الذي تَحْدُثُ فيه المواجهة بين الطبقات المهيمَن عليها والطبقات المهيمِنة.
معنى هذا أن المفاهيم الغربية التي تستعمل بوصفها مقابلات للثقافة الشعبية أو معادلات لها أو متوازيات معها تدل نسقيا على تنظيم اجتماعي له خصوصيته، وهي خصوصية تجعل مفهوم «الشعبي» نفسه مفهوما لا يعني نفس الشيء الذي نفهمه منه في واقعنا العربي مثلا. إن مدى الثقافة الشعبية في الغرب ضاق إلى أقصى حد، وذابت ملامحه إما في الثقافة البورجوازية أو الثقافة المهيمنة أو الثقافة العمالية أو الثقافة الحضرية أو الثقافة الجماهيرية، وتناوبته مجالات أخرى أكثر امتلاء، ولعل هذا هو ما أدى ببعض الدارسين إلى اعتبار مفهوم الثقافة الشعبية «مفهوما فارغا» كما أشرنا إلى ذلك من قبل لأنه لا يدل في الواقع الغربي على ظاهرة قابلة للملاحظة والقياس بنفس الدرجة التي هي عليها في مجتمعات أخرى ذات تنظيم اجتماعي تقليدي، ولهذا السبب نجد أن الثقافة الشعبية في الدراسات الغربية –وخاصة الأمريكية- تتداخل بشكل كبير جدا مع الثقافة الجماهيرية mass culture التي يربطها دومينيك ستريناتي بعملية «الأمركة(24)». «إن المدلول الاجتماعي للثقافة الشعبية في العصر الحديث يمكن أن يُملأ بحسب الطريقة التي تمت به مطابقتها مع الثقافة الجماهيرية(25)».
وعلى هذا الأساس ربما كانت إحدى المشكلات الكبرى التي تلقي بعض الظلال على مفهوم الثقافة الشعبية هي ما تتعرض له من مزاحمة من المفاهيم الأخرى التي تتقاطع معها أو تتوازى معها أو تطرح نفسها بوصفها بديلا عنها. ولعل هذا الأمر هو الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الشك حتى في جدوى مفهوم الثقافة الشعبية نفسه. وفي هذا الإطار تقول مارتين سيغالين وهي باحثة فرنسية في مجال الإثنولوجيا وعلم الاجتماع، ومتخصصة في قضايا الأسرة والثقافة: “على عكس الثقافة العالمة التي تملك شرعيتها الخاصة، ليس للثقافة الشعبية من وجود إلا في ضوء النظرة التي نلقيها عليها، لكن هذه النظرة ملتبسة: لأن الثقافة الشعبية تكون أحيانا موضوع إنكار ورفض، وأحيانا أخرى موضوع اكتشاف فتكتسي فجأة وضعا اعتباريا بوصفها (فنا) أو (معرفة)، أو حتى بوصفها (علما)(26)”.
وتعلق مارتين سيغالين على قضية إنكار الثقافة الشعبية في الثقافة الغربية بقولها: «إن إنكار الثقافة الشعبية يترافق بقدر كبير من الاحتقار(27)» لأن النظر إلى الثقافة المهيمنة -بوصفها الثقافة المتنفذة الدالة نسقيا على توجهات الطبقة الممسكة بمقاليد السلطة والمؤسسات المنتجة للفكر والمروجة للقيم- على أنها الثقافة الممثلة لحقيقة المجتمع، يقود إلى استصغار الثقافة الشعبية وركنها في الزاوية الأنتربولوجية التي تدرس القيم والتمثيلات التي تسربت إليها تجاعيد التقادم. إن الثقافة المهيمنة « هي تلك التي تنجح في فرض معاييرها وأفكارها على الممارسات الثقافية في المجتمع، وعلى مجال أنشطة الحياة اليومية وكذلك على مجال الإبداع الفني. إن الثقافة المهيمنة تنبع إذن من الطبقة المهيمنة، لكنها ليست مقتصرة على هذه الطبقة(28)».
إن ما يهمنا من هذه المعطيات التي سقناها في هذا المستوى من التحليل هو لفت الانتباه إلى أن قضية تعريف الثقافة الشعبية تطرح إشكالا كبيرا، وترتبط بمشاريع تعريف متباينة المرجعيات ومختلفة الغايات والأهداف، أو مشاريع تعريف نسقية شديدة الخصوصية الاجتماعية كما هو الحال في الثقافة الغربية، لكنها في كل الحالات مشاريع تستمد مسوغاتها من أهمية الظاهرة الثقافية نفسها بوصفها ظاهرة مركبة مقترنة بالإنسان ومعبرة عنه ومشروطة به. ولا شك أن ما يعتبر اليوم ثقافة شعبية في الغرب يختلف كثيرا عما يعتبر ثقافة شعبية في إفريقيا مثلا أو في العالم العربي أو حتى في الشرق الأقصى، مما يعني أن ليس بالإمكان – من الناحية النظرية والمنهجية- إسقاط التعريفات الغربية للثقافة الشعبية على واقع ثقافي غير غربي. والمسألة هنا لا تتعلق حصرا بمبدأ الخصوصية الثقافية بمعناها الأنتربولوجي الضيق، بل يتعلق نسقيا بخصوصية التنظيم الطبقي والاجتماعي الذي يتحكم في توزيع المواقع الثقافية وصياغة المضمون الثقافي المعبر جوهريا عن درجة معينة من الوعي التاريخي والانتماء الاجتماعي.
2 - مستوى الوظيفة
يؤكد أنطوان كومبانيون أن “الثقافة معطى اختلافي لأنها توحد الجماعة وتفصلها عن الجماعات الأخرى(29)”، أي أنها تحقق للجماعة جانبا من هويتها الدالة عليها. وهي في هذه الحالة ترتبط بأحد أهم الوظائف ذات الصلة بالوعي الجمعي داخل جماعة معينة، لأن هذا «الوعي الجمعي هو أساس الثقافة الشعبية(30)» في نهاية المطاف.
إن ما يمنح للأشياء معناها الرمزي ودلالتها التاريخية والإنسانية هو ما تقوم به من وظائف وما تضطلع به من أدوار وتمثيلات رمزية قابلة للاستقراء والكشف والتأويل والتحليل. ولعل ما يميز الثقافة عموما هو أنها تجمع بين المعطى التمثيلي والمعطى الرمزي والمعطى الوظيفي، وهي بهذا المعنى محتوى تاريخي وأداة قراءة للتاريخ؛ إنها فعالية انكشافية ينكشف من خلالها الإنسان لنفسه ولغيره، وهي في الوقت ذاته فعالية استكشافية لأنها قد تتحول إلى أداة للكشف والتحليل والتصنيف والمساءلة.
وإذا كان الأمر على هذا النحو من الافتراض والنظر، فإن الثقافة بمعناها العام ترتبط نسقيا بمنظومة من الوظائف، لكن ما يهمنا في حدود الموضوع الذي نخوض فيه هو محاولة تحديد وظائف الثقافة الشعبية.
وسنعتمد في هذا الإطار على ريشار مونيك الذي يتحدث عن الثقافة الشعبية في علاقتها بوظائفها قائلا: «إنها تؤدي وظائف عديدة تشمل عدة أبعاد(31)». ويحصر هذه الوظائف في: الوظيفة اللَّعِبِيَة la fonction ludique، والوظيفة النقدية، والوظيفة الاقتصادية، والوظيفة الاجتماعية، والوظيفة الإيديولوجية، والوظيفة الجمالية، والوظيفة الفنية، لكنه يتوقف عند ثلاث وظائف فقط هي: الوظيفة اللعبية، والوظيفة النقدية والوظيفة النفعية، وهي التي سنتوقف عندها بتركيز كالتالي:
فالوظيفة اللَّعِبِيَة ترتبط بالممارسات ذات الصلة بالثقافة الشعبية، ويمكن «اعتبار البعد اللَّعِبِي بمثابة سلوك مُرافِق للعب، أي أنه نشاط مَجَّاني يُمارَس على سبيل الاستمتاع فقط، ورغم أنه زائد وغير مرتبط بغرض محدد إلا أنه (نشاط إرادي)..يستجيب لحاجة جوهرية لدى الإنسان، ويمثل أيضا (نشاطا بَانِيًا للهوية)..إن اللعب يتيح للشباب تملكا شخصيا واجتماعيا لهويتهم عبر استخدام وتبادل وإنتاج الأشياء أو الخيرات الثقافية(32)».
أما الوظيفة النقدية فيتحدث عنها ريشار مونيك قائلا: “يمكن أن نعتبر هذا البعد النقدي بمثابة قدرة على تفكير الشخص في أعماله ومعارفه، وتفحص مواضيعه وتحليلها وتثمينها وتقويمها(33)”.
أما الوظيفة النفعية فيحددها ريشارر مونيك كالتالي: “إن الوظيفة النفعية للثقافة الشعبية تنطوي على الفحص العميق لإنتاج الممارسات وفحص الموارد الكفيلة بتحقق هذه الممارسات وتأويلها. ومن زاوية نظر المادية الثقافية، ينبغي التنبيه إلى أهمية دراسة الشروط الاجتماعية لطريقة استغلال الوقت، والتدريب، والرأسمال الضروري لإنتاج واستهلاك الأشكال الثقافية(34)”.
ومن الجدير بالذكر أن وظائف الثقافة الشعبية تختلف باختلاف الدارسين واختلاف زوايا النظر التي يصدرون عنها، فهناك من يتحدث عن الوظيفة التاريخية، أو الوظيفة السيكواوجية أو الوظيفة القيمية، أو الوظيفة المعيارية، وغيرها من الوظائف. ولربما كانت الثقافة الشعبية تحتمل كل هذه الوظائف مجتمعة وبدرجات متفاوتة، ومثال ذلك أن بعض الثقافات الشعبية الإفريقية تجعل من الوظيفة الاحتفالية ملمحا طاغيا فيها، بحيث يتحول أي حدث مهما كان صغيرا إلى فرصة لممارسة الطقوس الراقصة سواء تعلق الأمر بحفل زواج أو مأتم أو حملة انتخابية، بينما لا نجد ذلك في ثقافات شعبية أخرى.
3 - مستوى الخطاب
يمكن أن ننطلق –في هذا المستوى من التحليل- من المعطى النظري التالي: «الثقافةممارسة خطابية يُفهَم فيها المعنى من خلال علاقته بالثقافة وفي ضوء السياقات الفردية (لأن الأفراد يستعملون اللغة من أجل بناء تأويلهم الخاص للواقع). والفضل في هذا المنظور يعود إلى فيتغنشتاين الذي يرى أن المعنى لا يوجد في العالم فقط: من خلال اللغة يعطي الأفراد معنى للأشياء التي يعيشونها، واللغة عنصر من الثقافة التي تقوم على أساس قواعد مستمدة من تجانس ثقافي عميق. وهذا التجانس الثقافي هو الذي يخلق السياق الذي تكتسب فيه الجمل معناها(35)».
وإذا كانت الثقافة تحدد ملامح الخطاب من خلال تعزيز بعده المرجعي وتزويد بنيته اللغوية بالمعنى وبالقابلية للتناقل والتأويل،فلأن «الإنسان يبني العالم من خلال الرموز(36)» سواء كانت رموزا لغوية أو ثقافية.
ولا شك أن الثقافة الشعبية –من حيث هي تمثل للعالم وتمثيل له- تحضر بوصفها خطابا وشرطا للخطاب في الآن نفسه، فهي تنتج الإنسان بقدر ما ينتجها، وتشرطه وتشترط به، وتحرره وتصادره في الآن نفسه. وهي تفعل ذلك لأنها سلطة، أي حالة نظام قائم –مثله مثل أي نظام- على قدر معين من التقييد والإكراه. وإذا كانت الثقافة الشعبية تنتج الإنسان سلوكيا وقيميا ووجدانيا وذهنيا، فإن الإنسان يملك القدرة على إنتاج الثقافة الشعبية خطابيا، أي تحويلها إلى موضوع لاشتغال ثنائية اللغة والسياق، والرمز والمرجع، والمعنى والقصد، والدلالة والتأويل.
إن الثقافة بمعناها الواسع لا تكف عن إنتاج خطاباتها، وهي ليست دوما خطابات محرِّرة ونقدية ومناضلة بالمعنى الفكري للكلمة، بل قد تكون بدورها خطابات ترويض ورقابة. ويبدو أن في كل ثقافة شعبية هناك بنيات ترويض ورقابة، وهي بنيات مرتبطة جوهريا بخطاب الهوية من حيث هي إطار انتماء وشرط امتثال.
وفي هذه الحالة يمكن رصد الأبعاد الخطابية للثقافة الشعبية من زاويتين: زاوية البناء الخطابي للهوية، وزاوية «الخطاب المناهض للثقافة الشعبية(37)».
3 - 1 الثقافة الشعبية والبناء الخطابي للهوية: الوظيفة والتوظيف
يقول دجيفري بينهايم: «إن إحدى سخريات الثقافة الشعبية هي أننا في الوقت الذين نحن محاطين بأدواتها العديدة ( الإشهار، البرامج التلفزيونية، الأفلام والموسيقى، الخ) يظن أكثر الناس أنهم لا يتأثرون بهذه الأدوات..لكن خطاب الثقافة الشعبية يوجد حولنا في كل حين(38)».وإذا سلمنا بهذا الأمر، فمعنى ذلك أن الثقافة الشعبية لها وجهها الخطابي المرافق لتجلياتها المادية الحاضرة في حياتنا اليومية. وخطاب الثقافة الشعبية في هذه الحالة سيكون من نمط «الخطابات البانية للهوية(39)»، تلك الهوية الدينامية التي تتدخل في بنائها وإعادة بنائها أدواتُ ترويجِ المعنى واصطناع الأذواق واختلاق عادات جديدة للإنتاج والاستهلاك والسلوك والترميز.
والثقافة الشعبية من حيث هي خطاب “تزكي قدرة شعب أو طبقة اجتماعية أو فئة خاصة من السكان على التعبير عن الذات من خلال الممارسات الرمزية المشتركة بين كل الأفراد، وهذه الممارسات تقوي الإحساس بالانتماء للجماعة وتمنحها خصوصيتها(40)” أي هويتها.
إن اشتغال الثقافة الشعبية من خلال الفنون التقليدية مثلا يعتبر أداء استعاديا مسترسلا في الزمن الاجتماعي من أجل ربط الحاضر بالماضي، وإعادة إنتاجٍ طقوسيٍ للممارسات التي تنكشف من خلالها الهوية بوصفها حصيلة تجربة اجتماعية وروحية مسافرة عبر الزمان ومُتَنَاقَلَة بين الأجيال. لكن قنوات تعميم وتنشيط الثقافة الشعبية في المجتمع تحصل كذلك عبر وسائل مستحدثة مثل التلفاز والراديو والإشهار والمقهى العمومي والجريدة وغيرها من الوسائل ذات الوظيفة التواصلية والاجتماعية والتوجيهية والدعائية. وفي كل وسيلة من هذه الوسائل توجد ممارسة خطابية معزِّزة للهوية الجماعية لكن على النحو الذي يراد لهذه الهوية أن تكون عليه أو تصير إليه (كأن تُبَرْمَجَ في القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية مسلسلات تُسَرِّبُ بين الفينة والأخرى لقطات حميمية مُخَفَّفَة ظاهريا مثل العناق أو الملامسة، ثم تغدو هذه اللقطات –بفعل التواتر- مقبولة ثقافيا واجتماعيا، وتتحول الجلسة الأسرية لمشاهدة المسلسلات المفضلة موضوع اشتغال مبرمج من أجل إحداث مفعول التطبيع الثقافي الأسري مع قيم غريبة عن الثقافة الشعبية وقيم الأسرة التقليدية، مما يتيح –على المدى المتوسط أو البعيد- تكييف الهوية وإعادة صياغة بعض مقوماتها التقليدية عبر إعادة بناء سُلَّمِ القيم الأسرية والاجتماعية، وإعادة ضبط مدارات وحدود قيم الحياء والحشمة في الوعي الاجتماعي).
معنى هذا أن الثقافة الشعبية التي يفترض أنها تنتج خطابها الخاص حول الهوية بوصفه خطاب تعزيز وتثبيت، تتحول بدورها –على هذا النحو أو ذلك من التوظيف- إلى وسيلة من أجل تمرير خطاب كامن، وهو –مرجعيا- خطاب مُوَجَّه ومضمر في وسائل تناقل الثقافة الشعبية حتى حين تبدو هذه الثقافة الشعبية مسالِـمَة ومحايدة وغير مُؤَدْلْـجَة، لأن كل أشكال التدخل الاجتماعي (بما فيه التعليم والإعلام ومؤسسات إنتاج المعنى، أو قنوات اصطناع الرغبات والاحتياجات الحقيقية والوهمية، أي الإشهار، الخ..) تتم بالضبط في ذلك المجال من الوعي الاجتماعي الساذج والغافل الذي نسميه الثقافة الشعبية. ولهذا السبب يمكن القول إن « الثقافة الشعبية ليست فقط ذلك المجال الذي نتحدث فيه عن الهيمنة، بل هي أيضا ذلك المجال الذي يمكن أن يحصل فيه التفاوض بشأن الهويات(41)».
3 - 2 الخطاب المناهض للثقافة الشعبية: النقض والإلغاء
بقدر ما تنتج الثقافة الشعبية خطابها، بقدر ما تتحول هي بدورها إلى موضوع للخطاب. وما يهمنا في هذا المستوى من التحليل هو تبين بعض ملامح الخطاب المناهض للثقافة الشعبية وربطه بتبريراته الخاصة، وربما كذلك بإيديولوجيته المخاتلة. إن ما يميز “الثقافة بمعناها العام هو أنها مجال إنتاج المعنى(42)” وإضفاء الدلالة على الأفعال والأشياء والأفكار. لكن لا يوجد المعنى ولا يؤسس مشروعيته في الوعي الفردي والوعي الجماعي إلا بالتعارض مع معنى آخر أو مع فئة من المعاني في إطار هرمية من الدلالات المبنية تاريخيا واجتماعيا وثقافيا. ولما كان المعنى لا ينكشف إلا بوصفه معطى يُبْنى ويُسْتَبْنَى من خلال ممارسة خطابية، فإن الحديث عن الخطاب المناهض للثقافة الشعبية هو بالضرورة حديث عن إنتاج المعنى المضاد، أي إنتاج شكل من أشكال تشغيل سيرورة النقض والإلغاء.
وفي هذا الإطار يمكن أن ننطلق من التشخيص الحدادي الذي ورد في المجلة الفرنسية للسوسيولوجيا:“لقد ماتت الثقافة الشعبية منذ أن عرفت البورجوازية كيف تفرض ثقافتها من خلال المنظومة التعليمية ووسائل الإعلام(43)”.
إن خطاب الموت عادة خطاب تأبيني قائم على إحداث الوعي بحصول حالة انقطاع بين موضوع التأبين وبين العالم. وحالة الانقطاع هذه تعبر عن أن الموت يحيل الميت إلى جثة، فيفرغه من الحركة، و لا يعترف له بأي وظيفة ممكنة أو أي تأثير لاحق في الناس والأشياء. موت الثقافة الشعبية إذن يعني ضمن ما يعنيه انتصار خطاب المصادرة الذي تنتجه المؤسسة الاجتماعية الظافرة والمنتصرة. انتصار الثقافة البورجوازية يعني اندحار الثقافة الشعبية وموت التمثيلات الرمزية المعبرة عن طبقة اجتماعية كاملة غير قادرة على حماية ثقافتها من الانقراض.
إن إنتاج خطاب الموت في ما يتعلق بالثقافة الشعبية يتم عبر وسائط الثقافة الغالبة والمنتصرة، وهي وسائط الثقافة الجديدة أو الثقافة الجماهيرية ذات السند الإعلامي الجامح. ويبدو أن موت الثقافة الشعبية يحصل بالتوازي مع التغير الذي يحصل على مستوى الهيكل الاجتماعي، وظهور ملامح انتظامات طبقية جديدة، بحيث تتآكل طبقة اجتماعية معينة ويتعزز الوجود الاجتماعي لطبقة ناهضة أو مهيمنة، فيتوازى ذلك مع انحدار نسق ثقافي معين وانتعاش نسق ثقافي بديل، وهو الأمر الذي حصل للثقافة البورجوازية على حساب الثقافة الشعبية : “الثقافة الشعبية ماتت، والطبقة المتوسطة لم تعد مكونة في غالبيتها من أصحاب المحلات التجارية والحرفيين والمستخدمين، بل من الأُطُر..مما أدى إلى اختفاء تلك العوالم الحضارية التي كانت تحتضن كل حياةِ وشخصيةِ وطموحاتِ أعضائها(44)”.
ومن الحصيف أن نشير إلى أن الكامن في هذا الخطاب هو أن موت الثقافة الشعبية يعني موت الجماعة التي تولت تاريخيا إنتاج هذا النوع من الثقافة. وبدل القيم الجماعية التي كانت متوافقة نسقيا مع الإبدالات الثقافية الشعبية ظهرت إلى الوجود القيم الفردانية المعبرة نسقيا عن الإبدال الثقافي البورجوازي. إن “الفردانية قيمة مركزية في المجتمعات الحديثة، وقد تطورت بالموازاة مع الانهيار النسبي للمرجعيات التقليدية..إن انتشار الفردانية زكى ظهور نسق جديد من القيم الذي يمكن اختزاله في عبارة (الليبرالية الثقافية) التي تتميز بمجموعة من القيم المناهضة للهيمنة والمتمحورة حول الحرية والتفتح الفردي(45)”.
جزء كبير من التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمعات الغربية كان مقترنا بتحولات ثقافية، كما أن التحولات الثقافية كانت –بنفس القدر- مدعاة لتدشين تحولات اجتماعية، لذلك “يعتبر المحيط الثقافي عاملا مؤثرا ومتضمنا لِحَرَكِيَةٍ تُزَكِّي التحولاتِ الاجتماعية(46)”.
تبدو حالة التلازم بين التحولات الاجتماعية والتحولات الثقافية معطى تأويليا وربما أيضا تفسيرا إيديولوجيا بمعنى من المعاني، لكن لا أحد يمكنه إنكار تلك العلاقة الملتبسة وغير المرئية الموجودة بين نوع النظام الاجتماعي القائم وبين تمثيلاته الثقافية الدالة عليه والمشروطة به. ومن المثير فعلا أن نلاحظ مثلا أن العودة إلى اكتشاف الثقافة الشعبية التقليدية في البلدان الغربية أصبحت عودة أركيولوجية شبيهة بالرغبة في إعادة الأشياء التي ماتت إلى الحياة، لأن ملامح هذه الثقافة لم تعد حاضرة بشكل مرئي في الواقع الغربي، وتوارت تمثيلاتها ونسق تمثلاتها بسبب ظهور ثقافة جديدة ذات ملامح جماهيرية قائمة على خلق الكائن الاجتماعي النمطي والثقافة الشعبية المصطنعة والمُعَلَّبَة. و“باختصار، ماتت الثقافة الشعبية التقليدية وليست هناك إمكانية لإعادة الارتباط بها إلا عبر الأشياء التزيينية(47)”،.
اعتماد خطاب الموت في الحديث عن الثقافة الشعبية يوحي في المقابل بانبعاث ثقافة جديدة، لكن –في مجال الثقافة بمعناها العام-هل هناك فعلا ثقافة جديدة، أي قطيعة ثقافية مع إبدال ثقافي استنفد وظيفته التاريخية وفسح المجال لبديل ثقافي جديد ومغاير؟ أليست الثقافة حصيلة مسارِ تراكمٍ حَثيثٍ ومتواصل؟ إن التفكير في المدى الثقافي الممتد بمقولات تصنيفية ضيقة وقطاعية مثل: الثقافة الشعبية، الثقافة الجماهيرية، الثقافة الحضرية، الثقافة العمالية، الثقافة البورجوازية..الخ، يوحي بوجود نسق من التعيينات المفتعلة التي تُسْقِطُ التصنيفات الاجتماعية والطبقية على المجال الثقافي.
لكن من الناحية الإجرائية البحتة يمكن طبعا الحديث عن وجود كارطوغرافيا ثقافية على مستوى كل مجتمع بعينه، وكذلك على مستوى المجتمعات عموما، وهي كارطوغرافيا موازية للتنظيم الاجتماعي القائم ولدرجة تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية، ودرجة البداوة أو التمدن في المجتمع، ودرجة النشاط الثقافي الذي تنتجه النخبة في إطار ما يسمى “الثقافة العالمة” التي تمثل “خندق الطبقة الممسكة بزمان السلطة(48)”، الخ.
إن هذا الوضع الذي سمته إيوا بوغالسكا مارتان “التنضيد الثقافي(49)” يمكن فهمه “بوصفه نتيجة لتضافر عوامل عديدة مترتبة عن وقائع اجتماعية مختلفة وأهمها:
- تمزق –إن لم نقل اختفاء- الثقافة الشعبية مع سندها الاجتماعي المتمثل في الطبقة العاملة.
- بروز فئة الشباب بوصفها فئة اجتماعية، ووجودها –جزئيا- في حالة تهميش اجتماعي واقتصادي.
- حركية جغرافية متزايدة شجعتها المعاهدات الدولية حول حرية تنقل الأشخاص.
- عولمة بعض أشكال التعبير الثقافي التي انتعشت بفعل استخدام التكنولوجيات الحديثة(50)”.
ولعل هذه العوامل مجتمعة هي التي قادت إلى حدوث حالة ثقافية إشكالية ومستعصية على التحليل والمساءلة، وهي “اختفاء الثقافة الشعبية” بتعبير إيوا بوغالسكا مارتان. وإذا كانت الثقافة الشعبية في نظر هذه الباحثة ترتبط جوهريا بسند اجتماعي هو الطبقة العاملة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: أليس خطاب موت الثقافة الشعبية اصطناع ثقافي معبر مرجعيا عن منطق إيديولوجي بورجوازي؟ ألا يمكن أن نقرأ هذا الأمر بوصفه رغبة مُقَنَّعَة في تصفية الحساب مع الطبقة العاملة نفسها؟ خاصة إن نحن علمنا أن موت الثقافة أو الحضارة يعني موت ما سماه أرنولد جوزيف توينبي بـ“الاستجابة الخَلاَّقة” creative response.
إن مجال الثقافة حقل تنازع ومنافسة، لأنه حقل خيرات، لكنها خيرات ثقافية biens culturels. وحيثما وجدت الخيرات بمعناها المادي والرمزي توجد بالضرورة دواعي الصراع والمجابهة وتصفية الحسابات. ولعل شيئا من هذه المجابهة يوجد بشكل سافر أو مضمر في حقل الثقافة الحديثة، وهو الذي ينتج أحيانا خطاب الموت والتأبين، وخطاب النقض والإلغاء حين يتعلق الأمر بالثقافة الشعبية. و“كما عبر عن ذلك الفيلسوف بول ريكور فـ(المجتمع من حيث هو شبكة من المؤسسات يتمثل قبل كل شيء في نسق واسع لتوزيع الخيرات). وهو يعني بذلك الخيرات السلعية لكن أيضا الخيرات غير السلعية وغير المادية. ويمكن تطبيق هذا التصور على السوق الخاص والعام للثقافة(51)”، تلك الثقافة التي تحولت –بفعل العولمة ونشوء فاعلين اقتصاديين يسميهم فرانسوا كولبير “ مديري الأعمال الثقافية(52)” –managers culturels إلى مجال للماركتينغ بحيث “عوض البحث عن معرفة احتياجات المستهلكين ومنحهم منتوجا قمينا بإشباع احتياجاتهم يقوم مدير الأعمال الثقافية بالبحث في السوق عن المستهلكين الذين قد يبدون اهتمام بالمنتوج الثقافي(53)”.
4 - الثقافة الشعبية ومستوى النسق: النسق المهيمن والنسق المُلْحَق
يمكن الانطلاق في هذا المستوى من التحليل من المعطى النظري التالي:“مفهوم الثقافة مطالب في أكثر الحالات بتوفير الأساس التفسيري للظواهر التي يتولى تنظيمها(54)”، لكن السؤال الذي تستدعيه هذه الفكرة هو: كيف يمكن لمفهوم الثقافة أن يملك هذه القدرة التفسيرية والتنظيمية؟ هل الثقافة هي التي تفسر وتنظم أم أن التوظيف الإنساني للثقافة هو الذي يسقط على العالم نظامه المفترض وقابليته المزعومة للتفسير والانتظام في إطار رؤية للعالم؟ وبمعنى آخر كيف يمكن للثقافة من حيث هي نسق مصطنع ومبني تاريخيا واجتماعيا أن يفسر النسق الطبيعي (العالم) الذي يعتبر سابقا وجوديا على كل نسق؟
هذه قضية فكرية تتعلق بجدلية الوظيفة والتوظيف، وثنائية النسق الطبيعي والنسق الثقافي. وقد يكون التأمل في هذه القضية تمرينا فكريا منفتحا على مآلات واسعة جدا ومتداخلة، وربما أيضا غير مجدية، لكن غايتنا من إثارة هذه القضية هي تسويغ التفكير في الثقافة الشعبية بوصفها نسقا معبرا عن رؤية للعالم.
وفي إطار هذا التسويغ يتبين أن “المجتمع نسق للفعل un système d’action، وهو مثل كل نسق للفعل يتكون من أربعة أبعاد وظيفية هي أبعاد التكيف، وملاحقة الأهداف، والاندماج، وأخيرا يتميز بأنه يتكون من معايير وقيم يتناقلها الناس في المجتمع(55)”.
وإذا كان الأمر كذلك، هل الثقافة الشعبية جزء من المجتمع من حيث هو نسق للفعل أم أنها هي نفسها نسق للفعل قائم بذاته وخاضع لمنطقه الخاص؟ خاصة إن علمنا أن المجتمع – أي مجتمع كيفما كان- ليس مجالا للتجانس النسقي الخالص، بل ينطوي على العناصر المقاوِمة للنسق، وهي عناصر تشويش وتوتر وصراع بين الذين يحتلون النسق ويمسكون بزمام السلطة فيه، وبين الذين يعتبرون جزءا من النسق ومُهَمَّشِيهِ في الآن نفسه.
ويؤكد إدغار مونان أنه“ لا بد من النظر إلى الثقافة بوصفها نسقا ينقل –بطريقة جدلية- تجربة وجودية ومعرفة مُسْتَبْنَاة..فمن جهة يَستخرِج النسق الثقافي من الوجود التجربةَ ويتيح إمكانية استيعابها وتخزينها، ومن جهة أخرى يوفر للوجود الأطر والبنيات التي تضمن –من خلال الجمع بين الممارسة والمُتخيَّل- إما السلوك العَمَلِياتِي أو المشاركة والاستمتاع والنشوة(56)”.ولعل تصور الثقافة بوصفها نسقا هو الذي يتيح الكشف عن شبكة انتظاماتها وتعالقاتها مع باقي الأنساق غير الثقافية ونقصد بها النسق الاجتماعي والسياسي تحديدا خاصة إن نحن وضعنا في الاعتبار أن “ما نعنيه بالثقافة الشعبية هو النسق الثقافي الخاص بالتجمعات الواقعية التي تحتل وضعية التبعية أو الخضوع للهيمنة في المجتمع الكوني الشامل(57)”.
وفي هذا الإطار من التصور والمقاربة، يمكن القول إن المجتمعات تصطنع –عادة- أنساقها الثقافية التي على شاكلتها، أي الأنساق الدالة على الصورة التي يرى بها المجتمع نفسه على الوجه الذي تتحقق به هويته ووعيه بالهوية، لذلك لا تبدو الثقافة أبدا معطى مطلقا ولاتاريخيا، إن “الثقافة هي روح الشعب” كما قال فرانز فانون، وهو تعبير سبق أن استعمله الفيلسوف والشاعر الألماني يوهان غوتفريد هيردر (1744م-1803م)، ثم استعاده هيغل الذي اعتبر الأشكال الغنائية والحكايات الشعبية الوطنية معبرة جوهريا عن روح الشعب.
لكن كلمة “روح” هنا لا تعبر عن حالة ثبات ميتافيزيقي، بل هي لفظ استعاري دال على أن الثقافة مكون جوهري من مكونات أي شعب. إن “كلمة الشعب تنطوي على معنى ديناميكي، إنها تتضمن حالة توتر شامل، وتعتبر بمثابة طريق متجه نحو المستقبل(58)”.ومعنى هذا أن الشعب طاقة تجدد دائب، إنه حركة ذاتية ومفعول لكل حركة خارجة عنه وفاعلة فيه أو متفاعلة معه. ولما كان الأمر على هذا النحو فإن الثقافة التي يصطنعها الشعب لنفسه لا بد أن تكون بدورها حركة أو مفعولا للحركة. وكلما تغيرت بنية المجتمع ونسقه العام تتغير الثقافة لكي تساير حركة المجتمع وتعبر عن روحه المتجددة الناهضة دوما باتجاه المستقبل، وفي هذه الحالة “تعتبر بنية المجتمع نفسها، أي نسقه التنظيمي، بمثابة قضية ثقافية(59)”.
يبدو إذن أن الحلول التبادلي للنسق الثقافي في النسق الاجتماعي أو العكس هو الذي يجعل من التمثيل الرمزي لأشكال التجربة الاجتماعية أمرا ممكنا وقابلا للتناقل وموضوعا لقياس درجة توافق المجتمع مع الصورة التي يريدها لنفسه ولأفراده. ولا شك أن جزءا وازنا من محتوى هذه الصورة قابل للاستقراء من خلال “الثقافة الشعبية للمجتمع التي تمثل نسقا من الأفعال وأنماط السلوك والمعتقدات والتقاليد والأذواق التي تحدد خصوصية الشعب في أي مجتمع؛ الثقافة الشعبية هي التسلية واللهو والأيقونات والطقوس والأفعال التي تشكل الحياة اليومية للمجتمع؛ إنها ما نفعله حين نكون في حالة يقظة، وما نفكر فيه، والكيفية التي نقارب بها الأفكار، وهي ما نحلم به حين نكون في حالة نوم، إن الثقافة الشعبية هي طريقة الحياة التي نتوارثها ونمارسها ونطورها وننقلها إلى أبنائنا(60)”.
هذا التعريف الذي يقدمه راي برودوس براون (وهو كاتب أمريكي، وأحد مؤسسي الدراسات الأكاديمية المهتمة بالثقافة الشعبية الأمريكية) يقدم الثقافة الشعبية بوصفها نسقا يتفاعل فيه نسق التجربة الاجتماعية اليومية مع أنساق الأفعال والسلوك والتسلية والأذواق والمعتقدات والتقاليد والأفكار واليقظة والحلم والتوارث. ويستنتج راي برودوس براون من هذا التعريف الفكرة التالية: “إن الثقافة الشعبية هي البعد المألوف والناضج من ثقافة الناس، أي ثقافة الشعب(61)”.
وإذا كانت هذه المعطيات التي أوردناها تكشف أن الدارسين للثقافة الشعبية قد نظروا إليها بوصفها نسقا، فإن ربط هذه المعطيات بمحور التحليل الذي نحن بصدد الخوض فيه، يقودنا إلى طرح السؤال التالي: إذا كانت الثقافة الشعبية نسقا بالفعل، فما هو موقع هذا النسق في تراتبية الأنساق التي تضبط حياة الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي وثقافي وسياسي؟ خاصة إن سلمنا أن الثقافة الشعبية هي أيضا “نسق العلاقات القائمة بين طبقات المجتمع(62)”.
إن العلاقات القائمة بين طبقات المجتمع تقترن غالبا بدرجة معينة من التوتر الاجتماعي المحرك لكل أشكال التدافعات المغذية للتطورات أو الاندحارات التي تصنع ملامح التجربة الاجتماعية وانعكاساتها على الأفراد. وما عبرنا عنه بكلمة “التدافع” هو ما روجته الثقافة الغربية تحت مسمى “الصراع” الذي تعرفه ميشيل لوبارون (وهي خبيرة دولية في مجال حل النزاعات) بأنه “اختلاف له جدواه(63)”.
ومن المفيد أن نشير إلى أن الثقافة الشعبية تصطنع خطابها ونسقها بوصفهما شكلا من أشكال الصراع والمواجهة مع الأنساق الثقافية المنافسة. ولا يحصل هذا الصراع بطريقة مكشوفة وواعية، لكنه يحصل بدوره بترتيبات ثقافية تتبناها الدولة ومؤسساتها وجمعياتها وأعضاؤها وكل الفاعلين الاجتماعيين. ومن هذه الزاوية، يمكن الاستئناس بما قالته فاليري دوكورفيل نيكول (وهي أستاذة في شعبة السوسيولوجيا والأنتربولوجيا في جامعة كونكورديا في مونريال بكندا): “في التقليد الإنْسِي تتكون الثقافة من المنتوجات العليا للفكر والإبداع الإنسانيين مثل الأعمال الفنية الكبرى. ومن هذه الزاوية يُنظر إلى الثقافة الشعبية بوصفها شكلا فكريا ثانويا ومنحطا ومشوها أو رديئا، تغيب فيه الإبداعية(64)”. إن حكم قيمة من هذا النوع تصوغه غالبا الفعاليات الثقافية التي تنتسب مرجعيا لما يسمى “الثقافة العليا”، أي تلك السلطة الثقافية التي تتولى إنتاج نسق الأفكار والأحكام والتقويمات التي تحظى بالتثمين والمفاضلة والترويج والتناقل عبر النظام التعليمي ودور النشر والمجلات والندوات الخ. وفي كل الحالات فإن الكامن خلف هذه الأفكار والأحكام والتقويمات هو أنها لا تعبر عن موقع ثقافي فقط بل تعبر أيضا –وربما حصرا- عن موقع اجتماعي ورؤية سياسية وتصنيف إيديولوجي.
ومن المثير فعلا ملاحظة أن أفراد المجتمع يصدرون –في مواقفهم وأفعالهم وردود أفعالهم- عن نوع من الانتماء اللاواعي لنسق ثقافي معين، بحيث يمكن القول إن الكثير مما نعتبره سلوكا فرديا وإراديا ليس سوى حصيلة تفاعل سمات النسق الفردي وسمات النسق الثقافي الذي يغذي سلوك الفرد ويمنحه تقويماته الخاصة المبررة لما يقوله أو يفعله أو لما لا يقوله أو لا يفعله. ومعنى هذا أن النسق الثقافي سلطة توجيه وفرز، وهي لهذا السبب بالذات توفر ممكنات الصراع بين المتغايرات الثقافية، وبذلك يتحول الصراع الثقافي بدوره إلى جزء من الثقافة، وربما هو الجزء الفاعل فيها أكثر من العوامل الأخرى. وقد يحق لنا أن نتساءل: ما الذي يبرر حدوث حالة الصراع في مجال يفترض فيه أنه قائم على التوافق والتواضع والاشتراك في تقاسم الإرث المشترك؟
إن أسباب الصراع في حقل الثقافة ترتبط بأنها حقل مفتوح تسكنه الحقول الأخرى وتتساكن معه، وتوظفه بحسب غاياتها وأهدافها، ربما لأن الثقافة معطى وظيفي بطبيعته، ووظيفيته هي التي تجعل منه ما هو عليه: أداة صراع وموضوع صراع في الوقت نفسه. لكن في ما يخص الثقافة الشعبية يمكن القول إنها تظل في نهاية المطاف نسقا من بين أنساق ثقافية أخرى تجاوره أو تخترقه أو تحاوره. ولعل أحد هذه الأنساق هو ما يسمى الثقافة العالمة أو الثقافة النخبوية، بالإضافة إلى نسق آخر لا يقل أهمية وهو “الثقافة الوطنية التي غالبا ما يكون محتواها خاضعا لمراقبة النخب، ولمراقبة الدولة تحديدا(65)”.
إن الفاعل في الثقافة الشعبية هو الشعب، أما الثقافة العالمة فالفاعل فيها هو النخبة، أما الثقافة الوطنية فترتبط نسقيا وتدبيريا بفاعل رسمي هو الدولة. إن ثالوث الشعب والنخبة والدولة ليس ثالوثا متجانسا على أي وجه من الوجوه، إنه ثاثوث التعارض بامتياز، وهو بالإضافة إلى ذلك مجال لعبة الصراع والاستقطاب. والمدخل الأبدي في هذا الصراع يتمثل في المبدأ التالي: كل نسق من هذه الأنساق الثلاثة يقترح نفسه بوصفه نسقا أصليا ومعياريا ومعبرا عن حقيقة المجتمع. وكلما نجح أي من هذه الأنساق في رفع درجة تمثيليته وشرعيته في المجتمع يرتقي بفعل ذلك إلى نسق مهيمن أو “ثقافة عليا” la haute culture، وتتراجع الأنساق الأخرى إلى وضع اعتباري أدنى وتصنف بوصفها أنساقا ملحقة ودنيا cultures d’en bas. مع العلم أن «النسق بناء فكري حتى حين يحيل إلى تعالقات بين المكونات الإنسانية والمادية والإخبارية informationnelles القابلة للتعيين داخل تنظيم معين(66).
وبما أن الأنساق الفكرية تتضح ملامحها –بوصفها وعيا ومفعولا للوعي- في أوساط الفاعلين الاجتماعيين الممثلين لما يسمى “النخبة”، فإن أحد منتجي المنافسة بين الأنساق الثقافية وأكثرهم ادعاء للحياد هو الدراسات الأكاديمية التي تتولاها النخبة تحديدا، والتي تجعل من الثقافة الشعبية موضوعا للتحليل والتنظير والمساءلة. وفي هذه الحالة تتولى الثقافة العالمة التفكير في الثقافة الشعبية، فنجد أنفسنا أمام حالة من اشتغال النسق على النسق شبيه باشتغال المتن على المتن.
إن نسق الثقافة العالمة لا ينفصل في نهاية المطاف عن نسق الثقافة التي تَسْتَبْنِيهَا الدولة من خلال نظامها التعليمي والإعلامي والمؤسسيوالحزبي، مما يجعل نسق الثقافة العالمة جزءا من نسق مهيمن هو نسق الثقافة التي تنتجها الدولة. إن “النسق الثقافي المهيمن الذي ينتشر من خلال المجتمع المهيمن ينطوي على دوافع دقيقة للترقي الاجتماعي، ويوفر في الآن نفسه –من خلال مرتكزه الاقتصادي- المعايير الخارجية للجاه الاجتماعي. وهكذا لا ينجح النسق السوسيو-اقتصادي المهيمن في خلق الانتظارات فقط بل ينجح أيضا في خلق سلوكات تتطابق أكثر مع انتظارات وسلوكات الطبقات المحظوظة أو المهيمنة، وتتطابق أيضا مع انتظارات وسلوكات الطبقات التي ينتمي إليها المحرومون أنفسهم. وهكذا يقوم البعد الثقافي بدور مركزي في استدامة وإنتاج نسق التبعية الذي يميز العلاقات العبر-وطنية والدولية(67)”.
ومن المفيد القول إن استضمار النسق الثقافي المهيمن لممكنات الترقي الاجتماعي هو الذي يجعله نسقا ثقافيا مرغوبا، فتبدو الثقافة الشعبية إزاءه مجردة من جدواها ومفرغة من وظيفتها ذات الصلة بمعايير الجاه والسلطة والنفوذ وسحر المناصب ودوخة الكراسي. بل الأكثر من ذلك يتحول التموقع ثقافيا ضمن رقعة النسق الثقافي العام للمجتمع أحد الأولويات التي تعزز التنافس الاجتماعي في أوساط النخبة، ولعل هذا هو ما دفع بورديو إلى التأكيد على أن الأجدى في دراسة الثقافة هو أن نباشرها من فوق، وفي هذا الإطار يقول دومينيك باسكيي: “من الواضح بالنسبة لـ(بورديو)..أنه ينبغي تحليل الثقافة من الأعلى، أي انطلاقا من ممارسات النخبة التي تعزز موقعها الاجتماعي من خلال مواقعها الثقافية(68)”.
ويبدو أن ما يسميه كلود مولار بـ“الهندسة الثقافية” (وهو مصطلح اصطنعه هذا الأخير سنة 1986م) يدل فعلا على أن الثقافة الشعبية أصبحت مجالا للبرمجة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحولت إلى سوق بتعبيرريشار مونيك(69)، وهو يقصد بـ“الهندسة الثقافية”: “القدرة على توفير حلول على مستوى الجودة، وتوفير أثمان وآجال الطلبات التي يعبر عنها شركاء الحياة الثقافية، من أجل تحديد أهداف وصياغة برامج وتوفير التموين والإنجاز التقني للمشاريع(70)”.
وفي هذه الحالة لا يمكن التعامل مع الثقافة بوصفها نسقا منفصلا ومستقلا، بل أضحت مجالا للسمسرة الاقتصادية بحكم “أهميتها الاقتصادية كقطاع مُوَلِّدٍ للثروة وفرص العمل(71)”، وهو ما سمته كوليط ماكسيمان “تسليع الثقافة الشعبية، مما يؤدي إلى تغيير بنيتها الداخلية(72)”.
5 - مستوى المنهج
يمكن الانطلاق في هذا المستوى من التحليل من المعطى النظري التالي: “المنهج هو قانون التطور الذي يتيح الوصول إلى معرفة النظام(73)”. لكن في ما يخص الثقافة الشعبية ما هو هذا المنهج الذي يتيح مقاربتها من حيث هي نظام؟ وإذا كان الموضوع يحدد جزئيا منهجه الخاص، فكيف يمكن تحديد منهج دراسة الثقافة الشعبية؟ أو بمعنى أكثر تحديدا: ما هو هذا المنهج الذي تفترض فيه شروط المقاربة العلمية الوجيهة لموضوع الثقافة الشعبية؟
قد يبدو هذا السؤال مفتعلا بالنظر إلى أنه لا توجد علاقة استلزام ضروري بين الموضوع ومنهج مقاربته، إذ يمكن إجراء أي منهج على الثقافة الشعبية، وبإمكان أي منهج أن يثبت جدواه ويحقق مردوديته في هذا المجال من الدراسة إن توفرت فيه متطلبات الكفاية الإجرائية المناسبة والمقبولة، لكن الإشكال الذي يلفت الانتباه في موضوع الثقافة الشعبية هو التشكيك غالبا في جدوى دراستها، وفي هذا الإطار يقول مايكل شودسون وشاندرا موكيرجي: “ هناك سؤال تقليدي يوجه غالبا للثقافة الشعبية أكثر مما يوجه لمواضيع الدراسات الأخرى، وهو سؤال متعلق بمعرفة ما إذا كانت الثقافة الشعبية تستحق أي اهتمام، لكن خلال العقدين الأخيرين ظهر اهتمام بالغ بالثقافة الشعبية في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويأتي جانب من هذا الاهتمام من الاقتناع المتزايد –في أوساط الباحثين الماركسيين- بأن الثقافة الشعبية تقوم بدور كبير في مجال ظواهر التعبئة السياسية، وجزء آخر من هذا الاهتمام يأتي بسبب تطور التقنيات الجديدة الخاصة بتفسير معنى الأشكال الشعبية(74)”.
إن الأشياء والأفكار لا تتحول عادة إلى مواضيع للدراسة إلا حين تحصل على وضعها الاعتباري بوصفها ظواهر أو قضايا، ولا تحصل الأشياء على هذا الوضع الاعتباري إلا حين تصبح مرئية للفكر أي واقعة ضمن مدار التأمل، وهي لا تصبح كذلك إلا حين يكون لها أثر أو تأثير في واقع الناس ومواقعهم، أي حين تصبح موضوع تنافس وصراع واستقطاب. ولعل الاهتمام بالثقافة الشعبية جاء نتيجة هذه السلسة من التداعيات التي منحتها في نهاية المطاف أحقيتها في أن تصبح حقلا للدراسة، أي موضوعا لاشتغال المناهج وتشغيل لعبة التفسير والتأويل. ونقرأ في موسوعة لاروس أن “ الثقافة الشعبية لم يعترف بها فعلا بوصفها موضوعا لحقل معرفي مستقل إلا في سنة 1937م، وذلك خلال إحداث المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية في باريس(75)”. ومعنى هذا أن الاعتراف بالثقافة الشعبية حديث العهد رغم أنها كانت دوما جزءا من واقع الناس وتجربتهم الاجتماعية المشتركة.
ويمكن لفت الانتباه إلى أن الثقافة الشعبية خضعت لمقاربات منهجية عديدة: مقاربات أنتربولوجية وإثنولوجية وسوسيولوجية وتاريخية وسيميوطيقية، وأخيرا أصبحت الثقافة الشعبية موضوعا للدراسات الثقافية، و“النتيجة أن حقل الدراسات المهتمة بالثقافة الشعبية ليست له حدود دقيقة..إن دراسة الثقافة الشعبية تخترق الحقول المعرفية، ومن المستحيل صياغة سوسيولوجيا الثقافة الشعبية دون أن نأخد بعين الاعتبار التاريخ والأنتربولوجيا أو الفولكلور(76)”.
ولعل هذا السبب هو الذي يجعل الثقافة الشعبية مجالا مفتوحا أمام كل المناهج والمقاربات، بل يمكن القول إن الثقافة الشعبية أضحت مجالا لتجريب الكفاءة التحليلية للمناهج التي توفرها العلوم الإنسانية، وتلك مسألة تتعلق بطبيعة الثقافة الشعبية نفسها التي تستضمر البعد الاجتماعي والبعد الأنتربولوجي بل وحتى البعد السياسي وغيره من الأبعاد التي تميز عادة الظواهر التاريخية المركبة والمفتوحة.
فمن الزاوية ذات الصلة بالدراسة الأنتربولوجية للثقافة الشعبية يمكن القول إن “المقاربة المتعددة لدراسة المجتمعات الإنسانية التي تقترحها الأنتربولوجيا سمحت بتحويل الثقافة الشعبية إلى موضوع دراسة معترف به، خاصة منذ اللحظة التي قام فيها الأنتربولوجيون بدراسة الثقافة الشعبية في المجتمعات الصناعية والمجتمعات القَبِيلِيَة على حد سواء. وهكذا ظهر على الأقل تيارات مؤثران وُلِدا من رحم الأنتربولوجيا: تيار بنيوي مستوحى من الأدوات المفهومية التي وفرتها اللسانيات وأعمال كلود ليفي ستراوس، وتيار تفسيري يحتوي مقاربات متباينة مرتكزة حول أهمية المكون الرمزي والجماعي في المجتمع. وهذا التيار التفسيري يعيد مراجعة مفهوم “الأشكال الأولية” عند دوركهايم، ويؤكد بالتالي أهمية دراسة الاحتفالات الطقوسية والتمجيدية، والأشكال الفُرْجَوِيَة والطقوس الأخرى في إطار أشكالها التقليدية (الدينية) أو الحديثة (وسائل الإعلام الجماهيرية، الرياضة الاحترافية، الخ)(77)”.
أما في ما يتعلق بالمقاربة السوسيولوجية للثقافة الشعبية فقد مثلت بموازاة المقاربة الأنتربولوجية أحد أهم المناهج التي أظهرت كفاءة كبيرة في دراسة الثقافة الشعبية، واصطنعت متنا غنيا من المصطلحات ذات الصلة بطبيعة هذا الموضوع وخصوصيته. ويمكن القول إن اهتمام السوسيولوجيا بالثقافة الشعبية جاء في إطار ما يسمى بـ“المنعطف السوسيولوجي” الذي تتحدث عنه فاليري دوكورفيل نيكول قائلة: “ إن (المنعطف السوسيولوجي) يُطَوِّر من جانبه فهما للقيم الثقافية بوصفها مُسْتَبْنَيَاتٍ اجتماعية لا بد من وضعها في سياق علاقاتها بالسلطة(78)”. ولعل قيمة المقاربة السوسيولوجية –خاصة في تحققاتها النظرية الفرنسية- تتمثل في أنها تدرج الثقافة الشعبية في مجال الكشف عن علاقاتها المضمرة برهانات الصراع المحتدم في وعي ولا وعي الفاعلين الاجتماعيين الذين يتقاسمون الانتماء للمجتمع نفسه لكنهم يعبرون عن وعي اجتماعي مختلف باختلاف مواقعهم أو تموقعاتهم الاجتماعية. وبما أن الثقافة الشعبية منتوج اجتماعي فمضمرات الصراع فيها ومن خلالها تتقاطع شئنا أم أبينا مع الرهانات والشروط الاجتماعية التي تسمح بتفسير نسق التفاعلات التي تحرك لاوعي الأفراد والطبقات في المجتمع.
وفي هذا الإطار يقول مايكل شودسون وشاندرا موكيرجي: “إن توفير نماذج نظرية تدمج دراسة الثقافة في فهم شامل للحياة الاجتماعية يمثل الإضافة الحديثة الأكثر أهمية في مجال سوسيولوجيا الثقافة الشعبية. ولعل هذه التحولات تبدو بمثابة النتيجة المترتبة عن تجديد الفكر الماركسي والنظريات التفسيرية الجديدة التي ظهرت في سنوات الستينيات، لكن هذه التحولات تدين أيضا بالشيء الكثير للتطورات المعاصرة للأنتربولوجيا والتاريخ(79)”.
لكن إذا كان المنهج الأنتربولوجي في مجال الثقافة الشعبية يميل بشكل قوي إلى الوصف والتصنيف، فإن المنهج السوسيولوجي –خاصة في أحد أهم معاقله الغربية، ونقصد بذلك فرنسا تحديدا- يميل بشكل معلن إلى اعتماد منظور تفسيري تتقاطع ضمنه الأبعاد الاجتماعية والإيديولوجية، وهو أمر يشير إليه دومينيك باسكيي قائلا: “في مجال السوسيولوجيا –كما كتب باسرون Passeron- (تتدخل الأخلاق). لا يمكن الحديث عما هو شعبي دون الاضطرار إلى اتخاذ موقف، فعالم السوسيولوجيا مطالب بأن يصرح بالمنظور الذي يصدر عنه: منظور السوسيولوجيا النقدية التي تنظر إلى الثقافة الشعبية بوصفها ثقافة مهيمنة يتحكم فيها الإكراه والنقص؟ أو منظور السوسيولوجيا المثالية angéliste sociologieالتي تهتم –على العكس من ذلك- بقدرات الثقافة الشعبية على المقاومة والاستقلالية؟ والواقع أن طرح القضية بهذا النوع من المصطلحات الجذرية يدعو إلى التساؤل: لماذا في فرنسا تحديدا..من المستحيل دراسة الثقافات المسماة شعبية دون الاضطرار إلى الدخول في سجالات إيديولوجية حول موضوع الدراسة؟(80)”.
لعل بعض عناصر الجواب عن هذا السؤال يتمثل في أن ما يسميه الأمريكيون “النظرية الفرنسية” French theory عبرت عن خصوصية فرنسية تحددت ملامحها من خلال أسماء فلسفية وازنة مثل ميشيل فوكو، وجيل دولوز، وكان بودريار، وجاك ديريدا، وجاك لاكان، وفيليكس غاطاري.ويرجع الفضل لهؤلاء الفلاسفة الفرنسيون في توفير الإبدالات النظرية والتحليلية التي تربط الخطاب عموما بمرجعياته ذات الصلة بالسلطة والإيديولوجيا والصراع وإرادة المعرفة.
أما المقاربة السيميوطيقية للثقافة الشعبية فقد تطورت في الدول الأنغلوساكسونية، واستفادت من أعمال رولان بارث الذي وظف السيميولوجيا في دراسة بعض الأساطير الشعبية خاصة في كتابه «ميثولوجيات» الذي يقول فيه:“نجد في هذا الكتاب محدِّدين: من جهة نقد إيديولوجي ينصب على لغة الثقاقة التي تسمى جماهيرية، ومن جهة أخرى تفكيك سيميولوجي لهذه اللغة. لقد انتهيت من قراءة كتاب دوسوسير، واستنتجت منه أن من خلال معالجة (التمثيلات الجماعية) بوصفها أنساقا للعلامات يمكن مراودة الأمل في الخروج من الشجب التقي وإعطاء فكرة تفصيلية عن الخداع الذي يُحَوِّلُ ثقافة البورجوازية الصغيرة إلى ثقافة ذات طبيعة كونية(81)”. ولا شك أن ما قام به رولان بارث في دراسة الأساطير الحديثة التي اصطنعتها الثقافة الجماهيرية (مواد التنظيف، أومو، سيارة سيكروين، الخ) هو الذي وفر الأساس النظري والإجرائي الذي أتاح تنـزيل التصور السيميوطيقي البارثي على دراسة الثقافة الشعبية. وفي هذا الإطار يقول مارسيل دانوزي: إن “السيميوطيقا التي تعني علم الدلالات أصبحت تقوم بدور مركزي في العديد من نظريات الثقافة الشعبية اليوم(82)”. ومن بين الذين طبقوا المقاربة السيميوطيقية في هذا المجال يمكن أن نذكر بيتر دونبار-هال (وهو أستاذ في جامعة سيدني في أستراليا)، ومن بين دراساته في هذا المجال مقال نشره سنة 1991م تحت عنوان “السيميوطيقا بوصفها منهجا في دراسة الموسيقى الشعبية”(83).
ومن المعروف أن دومينيك ستريناتي اهتم بالنظريات ذات الصلة بالثقافة الشعبية، ومن بين هذه النظريات أشار إلى النظرية السيميوطيقية، وتحدث في هذا الإطار عن السيميوطيقا بقوله: “ إنها علم العلامات الذي لا يملك فقط مفهوم الإيديولوجيا الذي يمكن أن تقاس به حقيقة العلم، بل يوفر طريقة علمية لفهم الثقافة الشعبية(84)”.
والحديث عن فهم الثقافة الشعبية بطريقة علمية يعني التعامل معها بوصفها نسقا من العلامات التي تملك أنظمتها الدلالية القابلة للقراءة والاستقراء والتأويل والفهم. وإذا كانت الغاية من فهم الظواهر والأشياء هي توظيفها أو إعادة توظيفها في ذلك النسق الهائل من الدلالات التي يصطنعها الإنسان لنفسه ولعالمه، فإن فهم الثقافة الشعبية يتيح تحريرها من الشك في قيمته والتحفظ بشأنها، “لأن كل تحفظ بصدد الثقافة يعتبر موقفا إرهابيا(85)” كما يقول رولان بارث، وهي صيغة بلاغية مفرطة ومتبجحة، وتستعمل ما يسميه الفرنسيون “الكلمات الكبيرة”، لكننا نأخذها على محمل الاستئناس فقط للإشارة إلى أن تفسيرات الثقافة ودراستها تنطوي بالضرورة على ما يفهمه الدارسون ويَتَأَوَّلُهُ المُؤَوِّلون.
إن غايتنا –كما هو واضح إلى حد الآن- هي الإشارة المركزة والعابرة إلى المنظورات المنهجية المختلفة التي نُظِر من خلالها إلى الثقافة الشعبية، وهدفنا من ذلك هو لفت الانتباه إلى أن الثقافة الشعبية تقع نظريا ومعرفيا عند تلك النقطة التي تتقاطع فيها الحقول المعرفية المختلفة، وخاصة تلك الحقول التي تتوفر على مناهج وأدوات تحليلية مشهود لها بالدقة والكفاءة، وعلى رأسها –كما رأينا- المنهج الأنتربولوجي والمنهج السوسيولوجي والسميوطيقي، مع العلم أن هناك مناهج أخرى مثل المنهج التاريخي والمنهج الجغرافي بل وحتى المنهج النفسي الذي يقارب الثقافة الشعبية من خلال بعض المفاهيم مثل “السيكولوجيا الشعبية” أو “السيكولوجيا الساذجة” التي تعتبر المكون الأكبر في ما يسمى “المعنى المشترك” الذي يعرفه جيروم برونر بأنه معطى مبني اجتماعيا ومُرَوَّجٌ من خلال الأشكال الحكائية الشعبية مثل الخرافة والأساطير. وهذا “المعنى المشترك” هو الذي حضر عند بيير بورديو باصطلاح مغاير هو “الدوكسا”.
إن السيكولوجيا الشعبية كما يعرفها جيروم برونر “مجموعة من التوصيفات التي تتميز بدرجة معينة من الترابط والمعيارية، والتي تقول لنا –من بين أشياء أخرى- كيف (يعمل) الناس وما هو عليه فكرنا وفكر الآخرين، وكيف ينبغي التصرف في وضعيات دقيقة، وما هي أنماط الحياة الممكنة وكيف يمكن الامتثال لها(86)”.
وإذا كانت كل هذه المناهج تتزاحم من أجل استجلاء مكونات الثقافة الشعبية وكشف نسق علاقاتها بالتاريخ والجغرافيا والمجتمع والإيديولوجيا والسلطة والعلامات والدلالة، فإن هناك منهجا آخر نود التوقف عنده لأهميته المتنامية في مجال الدراسات الإنسانية الحديثة، ونقصد به الدراسات الثقافية.
في تصور أحد مؤسسي الدراسات الثقافية، وهو رايموند ويليامز تعتبر الثقافة نمطا للحياة في شموليتها، وقد حضر هذا التصور بشكل قوي في كتابه “الثقافة والمجتمع(87)” (1983م). لقد “ ولدت الدراسات الثقافية في بريطانيا في الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك في سياق دمقرطة التعليم، وأعادت جوهريا تحديد تصورنا للثقافة، وبدل حصر الثقافة في أذواق الإنسان المثقف..توجهوا نحو فرض مقاربة ذات منحى أنتربولوجي للظواهر الثقافية المحدَّدة بوصفها مجموعة من الممارسات الرمزية والمادية للمجتمع. وكان ذلك بمثابة فتح الباب أمام الدراسة الجدية وغير الأبوية للثقافة الشعبية، وذلك رغم أن مفهومي الثقافة الشعبية والثقافة العمالية كانا –في البداية- متداخلين(88)” في هذا النوع من الدراسات.
لكن ما ميز التصور الذي طرحته الدراسات الثقافية هو أنها ربطتها بالمعطى الخطابي، وصدرت عن طرح نظري ونقدي يلح على أنه لا توجد الثقافة الشعبية إلا بوصفها خطابا مبنيا، وأن كل خطاب حول الثقافة الشعبية يستضمر قصدا ورهانا سياسيا يظلان في حاجة للقراءة والتأويل والكشف. وفي هذا الإطار يقول جان بيتنس: “إن الفائدة الكبرى للدراسات الثقافية لا تتمثل في الدفاع عن قضية الثقافة الشعبية (آخرون كثيرون قاموا بذلك من قبل)، بل تتمثل في إبراز أن الثقافة الشعبية لا توجد وأن الطرائق التي يتحدث بها الناس حولها ليست بريئة. والحال أنه بالنسبة للدراسات الثقافية لا يمكن معرفة الثقافة الشعبية إلا من خلال التمثلات التي تبنى حولها، والأكثر من ذلك أن هذه التمثلات ليسن مبنية من الداخل: أولئك الذين (يحيون) الثقافة الشعبية ليسوا أبدا من يبنون التمثلات حولها..بل يُتَحَدَّثُ حولها دوما من الخارج سواء من أجل تصويرها بصورة مثالية ورعوية أو من أجل التنديد بدناءاتها ومخاطرها(89)”.
الدراسات الثقافية إذن تتولى إعادة إدماج الثقافة الشعبية في منظومة الخطابات التي ينتجها الأفراد والجماعات والمؤسسات، وهي خطابات لا تقدم الثقافة الشعبية، بل تقدم تمثلات معينة حولها، وبذلك تقترح الدراسات الثقافية نفسها بوصفها استجلاء نقديا وتأويليا لتلك المسافة الحاصلة بين الثقافة الشعبية من حيث هي ظاهرة وبين الخطاب الذي يبنى حولها برهاناته السياسية والإيديولوجية. إن الثقافة الشعبية في منظور الدراسات الثقافية لا توجد إلا بوصفها ممارسة خطابية، بحيث يصبح الخطاب المهيمن حول الثقافة الشعبية هو شرط كل تمثل لحقيقتها أو لما ينبغي أن تكون عليه حقيقتها في الأذهان والعقول. وعلى هذا الأساس، فإن “تعريف الثقافة الشعبية ليس أبدا تعريفا (جوهريا)، بل هو دائما تعريف مبني، ومحدد تاريخيا، ويستجيب وظيفيا لمتغيرات عديدة، ومتأثر حتما بتعارضه مع قطب إيجابي هو قطب الثقافة البورجوازية أو ثقافة النخبة التي تقدم نفسها طبعا بأنها الثقافة بحصر المعنى(90)”.
بناء على هذه المعطيات يتبين أن مدار اشتغال الدراسات الثقافية في علاقتها بموضوع الثقافة الشعبية هو مساءلة أنظمة الخطاب التي ينتجها المجتمع حول الثقافة الشعبية، وهي خطابات خاضعة للاستبناء، وهي لا تعبر في نهاية المطاف إلا على التمثل الذي يملكه منتج الخطاب حول موضوعه. إن ارتباط الدراسات الثقافية بمفاهيم التمثل والخطاب والاستبناء يتيح مساءلة صيغ التوظيف التي تخضع لها الثقافة الشعبية أكثر من مساءلة وظيفتها. والدراسات الثقافية بهذا المعنى لا تطرح مشروعا وصفيا وتصنيفيا لتعريف الثقافة الشعبية، بل تطرح بدورها خطابا حول علاقة الثقافة الشعبية بمن يتولون إنتاج الخطاب حولها.إنها بكل بساطة مساءلة نقدية للتمثلات التي تُسْتَبْنَى خِطابيا حول الثقافة الشعبية.
خاتمة
حاولنا في المحاور التي توقفنا عندها أن نقدم صورة عامة ومبتسرة لهذه الظاهرة المركبة والمنفلتة التي تسمى ثقافة شعبية. ولعل أحد أهم المعطيات التي ينبغي تسجيلها هو أن الثقافة الشعبية ليست مجال التأملات المسالمة والعلمية الخالصة؛ كل مشروع تفكير في الثقافة الشعبية يصدر عن زاوية نظر معلنة أو كامنة، ونوع زاوية النظر المعتمدة هي التي تحدد جانبا كبيرا مما يقال حول الثقافة الشعبية. وتلك مسألة تحضر بدون شك في جميع الخطابات التي ينتجها الإنسان حول نفسه وحول أشياء وظواهر العالم التي يتخذها موضوعا للتأمل والتفكير، لكنها تحضر بدرجة أكبر في كل حديث يجريه الدارسون حول الثقافة الشعبية، لأنها مجال تقاطبات وتجاذبات بين الثقافة والسياسة، والوطن والعشيرة، والثابت والمتحول، والرمزي والمنفعي، والمادي والتمثيلي، والعامة والنخبة، والماهية والخطاب، الخ. ومن الطبيعي أن تكون الظواهر الواقعة عند حدود التقاطع والتماس بين المصالح المختلفة والتمثلات المتباينة مجالا للصراع والتدافع والاستقطاب، مع العلم بأن ما نقصده بالصراع ليس إحداث الشرخ، بل ملء الفراغ وتوفير ممكنات احتواء التناقض، إن ما نقصده بالصراع هو ما قالته عنه ميشيل لوبارون حين عرفته بأنه “اختلاف له جدواه” وهو أمر سبق أن أشرنا إليه ووثقناه.
ومن الطبيعي أن نقبل أن تكون الثقافة الشعبية واقعة تحت هذا الاختلاف المجدي شرط الوعي بأن أي حديث عن الثقافة الشعبية يعني جوهريا الحديث عن الإنسان، ذلك الإنسان الذي يعيش بها وينظر إلى نفسه ومغايره وعالمه من خلالها، لذلك فمصادرة الثقافة الشعبية مصادرة للإنسان، واعتداء عليه وتسفيه لمخزونه الرمزي ورأسماله الأكسيولوجي.