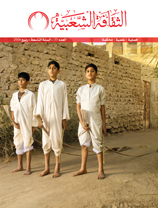التبوريدة المغربية بين التراث والرياضة
العدد 62 - عادات وتقاليد

مقدمة:
يكاد يجمع مختلف الدارسين1 في حقل العلوم الاجتماعية على اعتبار الرياضة أحد الأنشطة الإنسانية التي عرفها الإنسان عبر مختلف العصور والحضارات. فقد تعددت أهداف الرياضة وتنوعت لتشمل أبعادا وميادين اجتماعية مختلفة، فبالإضافة إلى اهتمام الرياضة بالترويح عن النفس وملء أوقات الفراغ والمساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية وبناء الشخصية المتوازنة للفرد على مستوى الصحة العقلية والنفسية والبدنية، فإنها تحمل الكثير من المعتقدات والقيم التي تؤثر في إدراك الناس للعالم وكيفية التصرف فيه.
تلعب الرياضة -اليوم أكثر من أي وقت مضى- دورا كبيرا على المستوى الاقتصادي بالنظر للأدوار والوظائف التي أصبحت تؤديها في مجال التنمية والمساهمة في نمو اقتصاد الدول، اعتبارا للميزانيات الضخمة التي تخصص لها ولمساهمتها في تشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة، عبر تنظيم الملتقيات والتظاهرات الدولية والوطنية. مما يجعلها «أحد المؤشرات العامة التي يحكم من خلالها على مستوى التقدم الاجتماعي والثقافي لمجتمع ما، فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية متداخلة بشكل عضوي في نظام الكيانات والبنى الاجتماعية، كما أن التقدم والرقي الرياضي يتوقف على المعطيات والعوامل الاجتماعية السائدة في المجتمع»2. ومن بين أدوار الرياضة أنها تساهم في تهذيب أخلاق الفرد، من خلال تجسيد الحماس والانسجام بين الأفراد الذين يمارسونها، خاصة وأنها غنية بالدلالات الاجتماعية والثقافية والفنية، و«عاملا مساعدا في عملية انتقال العادات والتقاليد والأعراف بين الأجيال»3. ولما كان للرياضة دور في عملية التنشئة الاجتماعية كرافعة للتربية على القيم، بفضل مساهمتها في إعداد الناشئة للاندماج الكامل في المجتمع وتأدية أدوارها الاجتماعية بنجاح ومسؤولية، على أساس قواعد ومعايير قوامها وأساسها التوازن على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي. فالرياضة تساهم في توحيد أفراد المجتمع نحو مشاعر جماعية من خلال تعزيز الانتماء الهوياتي المرتبط بالقيم المتعارف عليها اجتماعيا كالأخذ والعطاء والتضحية والشعور بالانتماء.
من هذا المنطلق سنتناول في هذه الورقة مكانة رياضة التبوريدة في المجتمع المغربي من المنظور السوسيوأنثروبولوجي كطقس اجتماعي وكتراث سوسيوثقافي لا مادي والمتميز بطابعه الفولكلوري الشعبي الذي ظل عبر التاريخ مجالا للتلاقح والتنافس بين القبائل في إطار المواسم والمهرجانات، واستطاع أن يجد له مكانا بين الرياضات الحديثة ويعلن هو الآخر تحوله نحو المأسسة عبر تحديثه وتقنينه، يحتاج إلى الوعي أكثر بترسيخ أهميته لما له من بعد إنساني وثقافي واقتصادي، بل وباعتباره مكونا من مكونات بناء الهوية المغربية ببعدها المحلي والوطني.
التبوريدة المغربية تراثا ثقافيا لا ماديا:
يكتسي الاهتمام بالتراث حيزا كبيرا من انشغال وتفكير المجتمعات المعاصرة، بحيث يعد عاملا من عوامل التطور والبناء ومصدرا لاستلهام الدروس قصد التغيير، لأن بقاء واستمرارية التراث بشقيه المادي وغير المادي يواجه المتخصصين في مجالي الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا بأسئلة جديدة من أبرزها العثور على المطابقة الصحيحة بين طبيعة «الكائن الموروث/ التراثي» والسياسة الترابية اللائقة للحفاظ عليه وصيانته. لكن قبل هذا وذاك لابد من الوقوف عند دلالة مفهوم التراث وتحديد معانيه.
يشير مفهوم التراث في معناه الاصطلاحي إلى «مجموع الآراء والأنماط والعادات الحضارية المتنقلة من جيل إلى الجيل الذي يليه، من الماضي إلى الحاضر»4. إنه «خلاصة ما ورّثته الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة من ثروات طبيعية وخبرات تاريخية وعادات وتقاليد شعبية وتنظيمات ويتكون من تجارب القدماء وأفكارهم ورغباتهم في شتى الميادين العلمية والفكرية واللغوية وغيرها من النواحي المادية وغير المادي، فهو تعبير عن العلاقة بين الانسان ومحيطه الطبيعي، وأسلوب للتملك الترابي إلى حد يسمح فيه بالقول بأن المكان الخالي من التراث أو الذي نسي تراثه يعتبر مكانا بلا لون ولا هوية، فالتراث يمثل جزءا من الصورة الكلية للمجتمع، سواء كان تاريخيا أو مجرد أساطير. وبناء على تفاعله العضوي مع عناصر المحيط، يتباين التراث بتباين الظروف الجغرافية والمرجعيات الثقافية التي يتغذى منها، الشيء الذي يمنح لكل مجتمع خصائص وعادات وتقاليد وصفات تميزه عن غيره»5. ومن بين أدوار التراث كذلك، أنه غني بالدلالات الاجتماعية والثقافية والفنية، وعامل مساعد في عملية انتقال العادات والتقاليد الشعبية والأعراف والخبرات بين الأجيال.
لا يقتصر التراث الثقافي على «المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية، والعادات وأشكال التعبير الحية الموروثة من الأسلاف والتي تداولتها الأجيال الواحد تلو الآخر وصولا إلينا، مثل التقاليد الشفهية والمعارف والمهارات في إنتاج الصناعات التقليدية»6 ولا ينحصر التراث الثقافي -حسب اليونيسكو- فقط في «التقاليد الموروثة من الماضي وإنما يشمل أيضا ممارسات ريفية وحضرية معاصرة تشارك فيها جماعات ثقافية متنوعة. كما أن كل أشكال التعبير التي يمارسونها هي أشكال للتعبير توارثتها الأجيال وتطورت استجابة لبيئاتهم، وهي تعطي إحساسا بالهوية والاستمرارية وتشكل حلقة وصل بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا»7 بل يشمل أيضا مختلف الممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية والفنون الاستعراضية.
وإذا كانت بعض الكائنات التراثية غير المادية تواجه خطر الموت أو الزوال أو الاختفاء ما لم يتم الإسراع بصونها وإنقاذها عبر نقل المعارف والمهارات والمعاني وإيصالها إلى الأجيال اللاحقة، وجعلها جزءا فعالا في حياتهم، فإن الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي يعد عاملا مهما لمواجهة العولمة المتزايدة والحفاظ على التنوع الثقافي. ويعد المغرب من الدول التي اعتمدت «اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عام 2003»8. وتعتبر هذه الاتفاقية وثيقة مرجعية من الناحية القانونية والإدارية والمالية للحفاظ على التراث الثقافي اللامادي.
وتحدد هذه الاتفاقية خمسة مجالات للتراث الثقافي غير المادي هي:
ومنذ سنة 2001 تم الإعلان عن ساحة جامع الفناء كتراث غير مادي للإنسانية، ثم مصادقة المغرب على الاتفاقية المذكورة سنة 2006 كانت بمتابة انطلاقة جديدة للجانب غير المادي من التراث الثقافي الوطني. ولعل ما يعكس أهمية التبوريدة المغربية كتراث غير مادي مغربي أصيل هو من جهة، الارتقاء بها وجعلها رياضة رسمية معترف بها وطنيا ضمن الجامعة الملكية المغربية للفروسية؛ حيث يحتضن المركب الملكي لرياضات الفروسية والتبوريدة دار السلام منافسات البطولة الوطنية للتبوريدة منذ سنة 2008؛ ومن جهة أخرى تتجلى أهمية «التبوريدة المغربية»، في تسجيلها من طرف «اليونيسكو» تراثاً إنسانيا، في دجنبر 2021، ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.
يلعب تراث التبوريدة -اليوم أكثر من أي وقت مضى- دورا كبيرا على المستوى الاقتصادي بالنظر للأدوار والوظائف التي أصبح يؤديها في مجال التنمية السياحية، حيث تلعب هذه الأخيرة «دورا كبيرا في الاقتصاديات الحديثة بما توفره من موارد مالية تساهم في تحريك الاقتصاديات المحلية وخلق فرص عمل وزيادة دخل الأسر وتصريف المنتجات المحلية مما يجعل منها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية ومن هنا يجب إعطاؤها الأهمية الكافية والدعم الكامل لتحقق الأهداف المرسومة لها»10. ولذلك ينبغي الاستفادة من تراث التبوريدة في إطار السياحة الرياضية التي يمكن بموجبها استثمار الأنشطة والتظاهرات الرياضية في تحقيق التنمية السياحية، من شأنه أن يعود بالنفع ويدرّ موارد مالية على الساكنة وعلى الاقتصادات المحلية، سيما وأن القطاع السياحي يعد من ركائز الاقتصاد المغربي. وذلك عبر تنظيم المهرجانات الثقافية والمواسم المحلية، باعتبارها -المواسم- فضاءات ووسيلة لدعم الوحدة والتلاحم بين مكونات المجتمع (قبائل، فرق، جهات...) وهو ما يعكسه تنامي الوعي الجمعي لدى المثقفين والفاعلين المدنيين بأهمية تراث التبوريدة والعناية به وتثمينه، والترافع من أجل حمايته وتحصينه كرمز للهوية المغربية الموسومة بالتنوع والتعدد الثقافي.
التبوريدة تراثا فنيا وطقسا احتفاليا:
يحظى الفرس عند المغاربة بأهمية خاصة سواء في حالة الحرب أو السلم باعتباره رمزًا تاريخيًّا وتراثيًّا تتوارثه الأجيال وهو ما تعكسه مكانته المتميزة في المتخيل الشعبي والاحترام والتقدير الذي يتمتع به. حيث تتلخص فيه معاني الشهامة والكبرياء والرفعة والهيبة، كما يرمز للمكانة الاجتماعية للأسرة، ويعزى ذلك أيضا، إلى قيمة الخيل في الإسلام حيث جاء في الحديث النبوي الشريف: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.» كما تغنى الشعراء العرب بالخيل فقال فيه المتنبي :
الخَيْـلُ وَاللّيْـلُ وَالبَيْـداءُ تَعرِفُنـي
وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَـمُ
وقال امرؤ القيس في وصفه لشجاعة الفرس:
مكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبـِرٍ مَعًا
كَجُلمـودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَـيلُ مِن عَلِ
وقد تغنى الشعراء المغاربة بالفرس والتبوريدة في العديد من القصائد الزجلية نذكر من بينها:
ريح السربة
الخيل والمكاحل والتبوريدة
مقدم وفرسان وصوت قدام خيل شديدة
دقة وتبات.... والرمية سديدة
دخان البارود..... نشم فيه ريحت لجدود
ايام العزة الله ايعيدة
سرج الخيل ممدود للخيالة والمقدم يقود11
وهو ما يعكس الحرص الشديد للأسر المغربية على امتلاك الخيل والعناية بها. علما أن فرس التبوريدة تربطه علاقة جد متميزة مع فارسه، الذي لا يسمح باستعماله إطلاقا في أعمال أخرى. كل ذلك بغية الظهور بشكل بارز ومميز في مكان الاستعراض الذي يسمى بالدارجة المغربية «المحرك». هذا الحضور هو الذي يخلع على الفارس وعلى عائلته المكانة والحظوة في سوق الرأسمال الرمزي بالرغم مما يكلفه امتلاك الفرس من تكاليف.
يرجع لفظ التبوريدة إلى كلمة البارود، لعب البارود، البّاردية أو أصحاب البارود، ويقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح الفانتازيا، ذي الأصل اليوناني، وهو اسم يطلق على عروض الفروسية التي تشبه الهجمات العسكرية، وتمارس في البلدان المغاربية في مختلف مناطقها؛ العربية والأمازيغية والصحراوية. ويتغنى التراث الشعبي المغربي بالتبوريدة؛ فهي تجلب الشرف والمجد والشجاعة والكبرياء والكرم إلى درجة أصبحت بعض قبائل المغرب (دكالة وعبدة) مشهورة بإتقانها لهذا الموروث الثقافي الفني بوصفه شكلا سلميا للصراع القبلي.
ليست التبوريدة عند المغاربة وليدة العصر، بل هي مرتبطة بتقاليدهم وعاداتهم التي يمتزج فيها المقدس بالدنيوي، فهي تمارس خلال الاحتفالات الجماعية والأعياد الكبرى، مثل الأعراس والعقيقة والختان والأعياد الدينية والمواسم والمهرجانات الثقافية. كما تحيل في بعدها العسكري -من حيث أنها تشكل أحد فنون الحرب والدفاع - على مواقف بطولية تمجد البارود والبندقية كمظهر لاستعراض القوة والشجاعة والفحولة والتأهب للحرب؛ وتبرز قوة الفرسان المتمرسين على قيادة خيولهم المنمقة بوسائل الزينة مثل «العصّابة» التي تحمي عيني الحصان من الغبار ودخان البارود، المصنوعة من قماش بأهداب مدلاّة تضفي على الحصان جمالية خاصة. أما «السّرج» فيكون مطرّزا أحيانا بخيوط الذهب ومنمّقا بشكل جمالي رفيع، كما تمتد الجمالية إلى لباس الفارس التقليدي، بالإضافة إلى المحفظة الجلدية الصغيرة والتي يحمل بداخلها إما مصحف أو أذكار، كما يحمل خنجرا فضيا يتحزم به. وتصاحب رقصات الخيول مجموعة من الأغاني والمواويل والصيحات وإيقاعات الطبول في جو احتفالي يستلهم الانتصار في المعارك التاريخية القديمة.
وما يزيد من حماسة عروض التبوريدة هو بعدها التنافسي، والرغبة التي تكون لدى السّربات القادمة من كل صوب وحدب لتمثيل مناطقها أحسن تمثيل، فأين يتجلى هذا البعد التنافسي؟ وهل استطاعت المرأة أن تجد لها موقعا ضمن هذه الممارسة؟
التبوريدة تراثا شعبيا تقليديا
وممارسة رياضية تنافسية:
يشير مفهوم الثقافة الشعبية إلى الثقافة السائدة والمهيمنة في بلد أو منطقة جغرافية معينة، والتي تتضمن الطقوس والاحتفالات وعادات اللباس، والأنشطة والممارسات الرياضية... ويمكن اعتبار الألعاب الشعبية ممارسة ضمن الأنشطة الرياضية القديمة التي تمثل جزءا من التراث الاجتماعي والثقافي المرتبط بالمقومات الحضارية للمجتمع الإنساني الذي تناقلته الأجيال ومارسته بغية الترفيه والمرح في أوقات الفراغ. كما أن لكل حقبة من التاريخ أشكال الفرجة المناسبة لها، ولكل زمن حضاري مباهجه ومتعه، فالألعاب اليونانية والرومانية متجذرة في النظام العبودي القديم، مثلما أن المسابقات مرتبطة بالنظام الفيودالي؛ في حين ولدت الرياضة مع ولادة نمط الإنتاج الرأسمالي وتطورت معه. وعلى عكس الرقص والسنيما والسيرك وغيرها من أشكال الفرجة الأخرى «تمتلك الفرجة الرياضية رهانا، أي نصرا يجب أن يتحقق هنا والآن. وهذا القرار يتعين أن يراه الجميع في الوقت نفسه وبشفافية مطلقة، دون كواليس أو خلفيات. هذه الشفافية في الفرجة تمنح الرياضة نمطا من الاستقلالية، فالرياضة منتوج يلغي إنتاجه ليقيم محله قيمه الخاصة»12. وعلى الرغم من أن الرياضة تتأسس على مبدأ اللعب «Play» الذي يمثل جوهر الأنشطة الرياضية التي يمارسها الأفراد، وهذا الفعل «اللعب» هو عمل يسعى من خلاله الفرد إلى تحقيق المنفعة الذاتية مثل المتعة والمرح وقضاء لحظات متميزة، وفي جميع بلدان العالم تعتبر ممارسة الأنشطة الرياضية في النوادي أو المؤسسات التربوية أو خارج المدرسة نشاطا شائعا في أوقات الفراغ عند معظم الأفراد، بل إنها تحتل حيزا كبيرا في المحادثات اليومية في المقاهي وفي كل المناسبات.
كما تعتبر الرياضة رافدا تراثيا لا يتجزأ من الموروث المشترك بين المجتمعات الإنسانية، فهي ظاهرة اجتماعية وثقافية يعود تاريخ نشأتها إلى آلاف السنين، فقد عرفت تغيرا اجتماعيا بفعل تقدم وتطور المجتمعات الإنسانية، وهو الشيء الذي سمح لها أن تكون في عصرنا الراهن أحد المكونات الأساسية للتراث الثقافي الإنساني، وتتميز بالتنوع والتعدد في طبيعة أشكالها وأنماطها وممارساتها، فهناك أنشطة رياضية فردية وجماعية وأخرى ترتكز على الذكاء مثل لعبة الشطرنج، وأنشطة رياضية تتميز بالمخاطرة مثل تسلق الجبال وبعضها يتسم بالاندفاعية والقتالية والخشونة، كما توجد رياضات تنمي الحس التأملي والرقي الوجداني.
تبقى الرياضة نظاما اجتماعيا على غرار باقي النظم الاجتماعية الكبرى وتربطها علاقة وطيدة بالعديد من المجالات مثل السياسة والاقتصاد والإعلام والدين، إنها «ظاهرة كليانية» بتعبير مارسيل موس Marcel Mauss. ويرجع الحديث عن التداخل بين الدين والرياضة إلى أن هذه الأخيرة تدين بشكل قوي -في إنتاجها وإعادة إنتاجها- إلى القيم التي تسهم في تطويرها بناء على أشكال الممارسات الثقافية والتاريخية السائدة في المجتمع. فالكثير من الرياضات تمارس فيها الأديان تأثيرها في كيفية تنشئة الأجيال عبر مجموعة من الطقوس. ذلك أن الأديان مثلا في مجتمعات الشرق الأقصى تؤمن بالتأمل méditation حيث يلاحظ من خلال تحية البداية والنهاية ومبادئ اللعبة هيمنة الطابع الديني. كما أن الدين الإسلامي يشجع على الرياضة والأنشطة البدنية كجزء من الطقوس اليومية، فطقس الصلاة الذي يتكرر خمس مرات في اليوم -إلى جانب كونه واجبا دينيا- هو عبارة عن تمارين رياضية، إضافة إلى أن الدين الإسلامي يشجع على ممارسة بعض الرياضات مثل السباحة والرماية وركوب الخيل.
1) التبوريدة ممارسة رياضية تنافسية:
إذا كانت التنشئة الاجتماعية الرياضية ملازمة للمجتمعات البشرية على مرّ التاريخ، فإن قسوة الحياة اليومية والبيئة الطبيعية تجبر الإنسان البدائي أن يمتاز بالكفاية البدنية للحفاظ على قدرته الجسمية للتصدي للأعداء المحيطين به، والقيام بتوفير غذاءه من خلال حملات الصيد. كما «أن بقاء العشيرة كان يعتمد على تمتع أعضائها بصفات بدنية ممتازة كالقوة والرشاقة والسرعة، وقد كانت العشيرة تشجع الأطفال على الاهتمام بالكفاية البدنية لأنهم كانوا يعتبرونها وسيلة لضمان فرص البقاء»13. وبالنظر الى التحولات المتسارعة والكبيرة التي عرفتها المجتمعات البشرية، سيما ما يرتبط بالعولمة والاقتصاد الاستهلاكي والتطور التكنولوجي الذي تغير معه نمط عيش الإنسان، وما صاحبه من قلة النشاط الحركي وسيادة الخمول والرتابة مما أثر على صحته النفسية والجسدية، وعرّض الكثيرين للأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وارتفاع الضغط والاكتئاب... ومن هنا كان رهان مختلف الفاعلين الاجتماعيين هو التصدي لهذه المخاطر عبر الترافع على مبدأ الرياضة للجميع عن طريق إتاحة الفرصة والإمكانيات الضرورية لكل مواطن أن يمارس بشكل حر وواع النشاط الحركي تبعا لرغبته ومتطلباته.
استرعت الطبيعة الاجتماعية للرياضة اهتمام الباحثين من مختلف التخصصات والمشارب في حقل العلوم الاجتماعية عموما، سيما منها علماء الاجتماع الذين اهتموا بالظاهرة الرياضية وبالتربية البدنية في إطار تخصصي ألا وهو سوسيولوجيا الرياضة. فمنذ نشر أول مقال باللغة الفرنسية لنوربيرت إلياس «Norbert Elias»-ضمن مجلة بيير بورديو عام 1976- أحدث تأثيرا كبيرا على المنظرين في مجال علم الاجتماع الرياضي. كما لقي كتابه المشترك مع تلميذه «ديونين»«Dunning» تنويها واستحسانا من لدن كبار علماء الاجتماع الرياضي في فرنسا أمــــثـال: «Georges Vigarello» و«Jacque Defrance» الذي عرف انتشارا واسعا بفضل كتابته باللغة الفرنسية، وأفرزت نظريته حول العنف المقنن «La violence maitrisée» منهجية تربوية جديدة تنبني على التربية البدنية والرياضة. ولم تعد الرياضة عنيفة لأن عنفها مقنن، «ومثلما هو معروف فالجماهير الرياضية تبقى خاضعة لقوانين الدولة، وهو ما يخفف الاحتدامات. فالرياضة أقل عنفا بكثير مقارنة مع ألعاب الفرجة التي عرفتها الأزمنة الماضية؛ ذلك أن الألعاب اليونانية كانت تنتهي بالموتى والمشوهين، وأشكال المصارعة الرومانية معروفة جدا، مثلما هي معروفة مباريات ومنافسات العصر الوسيط التي كانت تختتم بالموتى والعيون المفقوءة غالبا، وكذا منافسات القرية التي تكون مرعبة أحيانا»16.
تمثل التبوريدة أشهر ألعاب الفرجة في المغرب خلال المواسم الدينية والزراعية، واستطاعت أن تجد مكانها الخاص داخل المجال الرياضي منذ التسعينيات القرن الماضي، ضمن فنون الفروسية التقليدية تحت لواء الجامعة الملكية لرياضات الفروسية. فهي لم تعد مجرد ظاهرة صيفية أو طقسا احتفاليا بالمحاصيل الزراعية بالبوادي المغربية بعد انتهاء مواسم الحصاد. فقد لوحظ في السنوات الأخيرة، اهتمام متزايد بفن الفروسية التقليدية، سيما بعد تصنيفها كرياضة معترف بها رسميا، تخصص لها مسابقات وطنية كبطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية ويحصل خلالها الفائزون على جوائز مهمة تزيد صاحبها فخراً يضاف إلى الفخر الذي يشعر به وهو يمتلك فرسا بين أفراد القبيلة. وإلى جانب كون التبوريدة مناسبة لخلق أجواء من المتعة والفرجة، فهي أيضا مناسبة للتنافس على عدة مستويات سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي. يظهر التنافس هنا في جودة الحصان وفخامة الخيمة وكرامة الضيافة، ذلك أن الإكثار في الانفاق رمز للحظوة والمكانة الاجتماعية التي تتنافس حولها السربات والقبائل المشاركة. وبعد الارتقاء بألعاب الفروسية والتبوريدة إلى رياضة معتمدة تغيرت معها المعايير الفنية والتنافسية، لتحظى بتغطية إعلامية وبمتابعة جماهيرية وشعبية واسعة، مثل ما هو الشأن بخصوص معرض الفرس الذي ينظم سنويا بمدينة الجديدة بشراكة مع «الشركة الملكية لتشجيع الفرس، باعتبارها مؤسسة عمومية تعنى بتربية الخيول وسباقات وألعاب الفروسية، وتسهر على تنظيم كأس الحسن الثاني للتبوريدة، والدوري المغربي الملكي للقفز على الحواجز. علما أن المغرب يتوفر حاليا على أكثر من 300 فرقة لرياضة التبوريدة منضوية تحث لواء الجامعة الملكية للفروسية، وعلى 5900 فرس مخصصة لفنون الفروسية التقليدية»17.
2) التبوريدة بصيغة المؤنث:
ارتبطت التبوريدة في المجتمع المغربي عبر العصور بالرجال، غير أن الأمر لم يعد كذلك اليوم، فكما هو الحال بالنسبة لاقتحام النساء لمختلف مجالات الحياة التي ظلت إلى عهد قريب حكرا على الذكور، فإنهن اقتحمن هذا الموروث الفني وحاولن منافسة الرجال. وصرنا نشاهد «سربات» للإناث مكونة من شابات ينحدر أغلبيتهن من أسر مولعة بالخيل والتبوريدة. وباتت تخصص لهن مسابقات أسوة بالفرسان. ولابد من التأكيد على أن طقوس اللعبة لا تختلف في ممارستها بين الذكور والإناث؛ نستقي هنا كمثال حديث الشابة «بشرى» مقدمة سربة التبوريدة بنواحي الرباط:
«اقتحمت مجال التبوريدة، بفضل التشجيع الذي حضيت به من قبل والدي وأخي، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خاصة نظرات الاستهجان وتعليقات بعض الرجال الذين لا يستسيغون ركوب النساء للخيل. وأنا أهتم اليوم بتربية الخيل في منزلي القروي في إحدى ضواحي الرباط. وكافحت باستماته لتأسيس «سربتي» وعملت على استقطاب فتيات يعشقن ركوب الخيل، مع العلم أن لأغلبهن قريبا يمارس هذه الرياضة. بالرغم من الصعوبات التي واجهتني في الاحتفاظ بسربتي وتشجيع الفتيات على ممارسة هذ الفن؛ واجهت قلة الدعم المادي، وأيضا الأفكار النمطية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية سيما في المجال القروي».
كما نورد مثالا آخر للشابة «أميمة» التي استطاعت ركوب الخيل إلى جانب الرجال وهي في مقتبل العمر تحكي تجربتها:
«أنا فتاة قروية أنحدر من منطقة أولاد سعيد ضواحي مدينة سطات، درست شعبة الميكانيك بالمدينة، ولكنني ما زلت أقوم بالأعمال الفلاحية لمساعدة أسرتي القروية. اقتحمت التبوريدة بحكم أنني قريبة جدا من أبي الذي كان يصحبني معه باستمرار إلى المواسم والمهرجانات، مما ولد في حب هذا الفن والرغبة في ممارسته، وهي الرغبة التي حققتها والحمد لله. إنني صادفت صعوبات جمة لم تثنني عن رغبتي الجامحة في ركوب الخيل من قبيل الأفكار النمطية لذكورية التبوريدة والاستغراب الذي يبديه البعض من تواجدي بين الرجال، غير أنني في الوقت نفسه وجدت أناسا آخرين شجعوني وساندوني في تحقيق رغبتي، وبدأت في ركوب الخيل والتحقت بـ«سربة» عناصرها كلهم ذكور»18.
يبدو من خلال هاتين الشهادتين أن المرأة استطاعت بالفعل أن تضمن لها مكانا بين الرجال في ممارسة تقليدية ظلت حكرا عليهم، وهو ما يعكس تحولا جذريا في التمثلات الاجتماعية المغربية بما يتماشى مع القيم المعاصرة. غير أنه، على غرار مجموعة من الأنشطة والقطاعات التي تأثرت بتبعات الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا خلال العامين الماضيين، توقفت على إثره المهرجات والمواسم التقليدية، مما انعكس سلبا على ممارسي هذا التراث الفني سواء منهم النساء أو الرجال.
رياضة التبوريدة والتربية على قيمة المواطنة
لا شك أن الرياضة أصبحت ظاهرة عالمية، يمكن استخدامها كمنصة لتحقق العديد من الأهداف وحل عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية، نظرا لأنها حاملة لكثير من المعتقدات والاتجاهات الإيجابية التي لها علاقة بالقيم الاجتماعية والدينية. ويرجع الاهتمام المتزايد بالرياضة من طرف علماء الاجتماع - كموضوع للتفكير السوسيولوجي- إلى مساهمتها في إنتاج القيم التي تقوم على التعاون والعمل الجماعي والتفاني في العمل، وهي قيم تعزز شخصية الأفراد وتساهم في تحقيق الاندماج والنجاح والارتقاء الاجتماعي.
يمثل التعليم أول واجهة تربوية رياضية لنشر الوعي الرياضي والتكوين الصحي بين الأفراد والجماعات، عبر إدراج الرياضة المجتمعية ضمن سياسات تربوية منظمة وهادفة، ومن ثمة يصبح هذا النوع من التعليم أداة فعالة في بلوغ التنمية المنشودة. فالرياضة في جوهرها ممارسة تربوية، ذلك أنها لا تقتصر على تحقيق المتعة والفرجة فقط، بل إنها تعمل كذلك على تهذيب النفس وتربية النشء على قيم الاحترام والعمل الجماعي والتضحية التي يفترضها العمل في إطار الفريق. من هذا المنطلق لابد من تعليم قائم على المشاركة الفعلية والعملية للناشئة يخلصهم من أنانيتهم ويسهل عليهم عملية التكيف المرن مع بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي.
تظهرالرياضة للمجتمعات كمجال للتربية على القيم، فهي التي تعمل على غرس القيم الأخلاقية في النفوس، وعلى بناء الشخصية الإنسانية الناضجة المتمسكة بالأخلاق الحسنة، بل غالبا ما ينظر إليها كورش لصناعة النموذج المثالي -بتعبير ماكس فيبر- للإنسان المقبول اجتماعيا؛ ذلك أن الرياضي هو الذي يتملك الأخلاق والروح الرياضية كالتعاون والتفاهم والعمل الجماعي. وبما أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ القيم النبيلة ونبذ العنف والتمييز والإقصاء وربط الجسور بين الجماعات والثقافات، فإن التساؤل الذي قد يواجهنا هو عن ماهية القيم ذاتها؟
يقودنا الحديث عن القيم من المنظور السوسيولوجي إلى جملة من الثنائيات القائمة على التصنيف والتمييز بين أنماط من القيم تبعا لاختلاف المرجعيات والخلفيات النظرية والمعرفية والإيديولوجية ولسياقات اشتغالها وتستند عليها الدوافع الأساسية الكامنة وراء المواقف والسلوكات؛ ذلك «أن القيم هي أصل القوانين والقواعد والاتفاقات والأعراف التي تحكم الجماعات والعلاقات بين أفرادها، إنها تشكل مرجعياتنا الأساسية وتمكننا من إجراء اختياراتنا الحاسمة، وتعمل على توجيه أفعالنا وسلوكنا بشكل كبير. فهي العناصر الأكثر استقرارا في شخصيتنا، وبالتالي هي المحرك الذي يعطينا الطاقة، وهي أساس الثقة بالنفس. وهكذا تعتبر القيم في جزء مهم منها إرثا مكتسبا من تربيتنا ومن الوسط السوسيوثقافي ومن الدين، ومن جميع الأفراد أو المجموعات الاجتماعية التي أثرت علينا»19.
ففي المجال الرياضي هناك تفاعلات اجتماعية كبيرة أثناء الممارسة بحيث يتحدد تفاعل الفرد مع الآخرين عبر مجموع القيم التي ترتكز حول الالتزام والواجب والتضحية والمسؤولية إزاء الفريق الرياضي الذي ينتمي إليه. ولتحقيق الفوز والتفوق الرياضي فمن الضروري العمل على التوافق في القيم المتماثلة والسائدة داخل الفريق وحث الفرد على تقديم الأولوية لقيم الجماعة، لأن تقارب القيم بين أفراد الجماعة يسهل عملية ضبط سلوكهم ويعزز العلاقات بينهم، بينما يؤدي تصادم وتباين القيم بين الأفراد إلى زعزعة النظام والتماسك والانسجام داخل المجموعات الرياضية. يؤكد الحشحوشي في كتابه «علم الاجتماع الرياضي» أن التربية على المواطنة عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية هو سعي إلى تنمية المعارف والكفاءات التي تمكن الشباب من تطوير قدراته الاجتماعية مثل العمل ضمن الفريق والتضامن والتسامح والروح الرياضية، احترام الآخر، المشاركة في مكافحة العنف، تكوين الحس النقدي، تعلم واحترام القوانين، معرفة الحقوق والواجبات، روح الانتماء إلى النادي أو الجمعية في إطار متعدد الثقافات20.
ولا تقتصر الرياضة على حمولتها القيمية فقط، بل إنها تزخر بالعديد من العواطف القوية والمتنوعة، مثل الحب والكراهية، القوة والضعف، الفرح والحزن، القلق والطمأنينة، الأمر الذي يدل على أنها أكثر من مجرد ممارسة للألعاب الرياضية، فهي عبارة عن مجال محمل بالمشاعر والأحاسيس السلبية والإيجابية معا، والتي لها ارتباط وثيق بالظروف التي يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية.
تبقى التبوريدة إحدى الممارسات الثقافية والرياضية المكونة للهوية المغربية، التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ الحضاري، ولا شك أن العناية بالتراث الثقافي عموما، هو المدخل الأساس لتحقيق التنمية المحلية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن المحافظة على التراث وتثمينه هي دعامة أساسية، ليس فقط من أجل التنمية المنشودة، بل أيضا من أجل تحصين الهوية وترسيخ قيمة المواطنة، والشعور بالانتماء إلى الجماعة وإلى الإقليم الترابي، بناء على نظم وعلائق تربط بين الانسان وتراثه.
خاتمة:
إذا كان كل مجتمع يحيى بحياة تراثه، وأن العودة إلى التراث المحلي هي عودة إلى الهوية والذاكرة الجماعية وهي كذلك مساهمة في تحصين الشعور بالانتماء إلى وطن أو تقاليد أو نمط حياة. فإن الاستثمار في التراث، سواء المادي أو غير المادي، يعد بلا شك، مدخلا فيه تتحقق رؤية المجتمع وقيمه وتقاليده وفق مرجعية واضحة، تؤسس للهوية المغربية بتنوع وتعدد ثقافتها. فالرياضة تساهم بالتعريف بالثقافة بحيث أنها تمارس بطرق وأشكال مختلفة داخل مجموعات اجتماعية متعددة. ويمكن لرياضة التبوريدة أن تجد لها مكانا داخل مختلف الثقافات والمجتمعات الإنسانية في جميع بقاع العالم، كما يمكنها أن تتطور إلى حد التمايز كليا حسب ثقافة كل مجتمع وحسب الشرائح والفئات الاجتماعية.
وبما أن التبوريدة تحظى عند المغاربة بأهمية خاصة باعتبارها رمزًا تاريخيًّا وتراثيًّا تتوارثه الأجيال، فلابد من تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وباقي الفاعلين، من أجل العناية بهذا التراث وإعطائه المكانة التي يستحقها وجعله رافعة حقيقية للتنمية، عبر تحفيز المواطنين على العناية بها (التبوريدة) وتشجيع النساء على ممارستها والتعريف بها في الخارج والمرافعة من أجل جعلها رياضة عالمية.
ولتطوير وتجويد ممارسة فن ورياضة التبوريدة -كرمز للهوية المغربية يعزز لدى الأفراد الشعور بالانتماء ويرسخ لديهم قيم المواطنة ويساهم في تكوين شخصية الفرد وتوطيد علاقته بالمجال الترابي الذي ينتمي إليه- ولضمان تجددها باستمرار ونقلها من جيل إلى آخر، ينبغي تكثيف البحوث العلمية والأكاديمية بعقد الملتقيات والندوات حول التبوريدة وسبل المحافظة عليها والترويج لها. كما ينبغي أيضا العناية برياضة التبوريدة وإعطاؤها المكانة التي تستحقها ليس فقط عن طريق التركيز على طابعها الاحتفالي والفرجوي، بل بإعطاء الأهمية لترويج كل المنتجات والمعدات والحرف المرتبطة بهذه الرياضة (السروج، المكاحل، اللباس، الخنجر، اللجام...) والعمل على إنعاش تسويقها ضمن منظور اقتصادي سياحي تضامني.