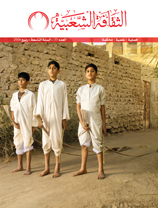الراوي الشفهيّ مبدع أيضاً
العدد 59 - التصدير

كلنا، على الأرجح، نذكر المشهد الساخر لعادل إمام (سرحان عبد البصير)، في مسرحية «شاهد مشفش حاجة»، وهو يكرر سؤال ممثل الادعاء العام، في المسرحية، عما إذا كان اسمه مكتوباً: (أنا اسمي مكتوب؟)، كلما همّ الأخير بتدوين شيء على الورقة أمامه بعد أن يستمع إلى إجاباته عن أسئلته، فيتبدد قلقه عندما يطمئنه المدعي العام أن اسمه ليس مكتوباً.
لنضع الفكاهة في هذا المشهد جانباً، ونطرح السؤال التالي: ما الذي كان يخشاه سرحان عبدالبصير من كتابة اسمه في المحضر الذي يُدونه المدعي العام، لتنتابه حال من الراحة، عندما يجيبه أن اسمه غير مكتوب؟
هذا السؤال، وبصورة من الصور، يحيلنا إلى قوة التدوين، أو الكتابة إن شئنا، إزاء ما يحسب بأنه ضعف للشفاهة، فبمجرد تدوين الاسم، أو أية معلومة من المعلومات، على الورق يكسبها صدقيّة، لا تتوفر الشفاهة عليها، كأن للشفاهة هنا مرتبة أدنى من الكتابة، أو كأن الواحد منا لا يخشى قولاً، قيل شفاهة، سواء كان ذلك على لسانه أو على لسان سواه في أمرٍ يعنيه، بالمقدار الذي يخشى فيه هذا القول بعد أن يصبح مكتوباً، فينتقل من الشفاهة إلى التدوين.
الجهد المطلوب للتحقق من صدقيّة كلام مكتوب أقل بكثير من الجهد المطلوب للتحقق من القول الشفاهي، وليس المقصود بالصدقيّة هنا صحة ما قيل في الوثيقة المكتوبة، أياً كانت هذه الوثيقة، وإنما صدقيّة نسبها إلى أشخاص أو جهات، ما يرتب عليهم مسؤوليات والتزامات، قد تؤدي إما إلى إدانتهم إن لزم الأمر، أو إلى تبرئتهم. وليست الغاية هنا إضفاء القداسة على التاريخ المكتوب، مقارنة بالتاريخ الشفاهي، ونحن من المؤمنين بأن التاريخ كتبه المنتصرون، وكيّفوا وقائعه وفق أهوائهم، وأن التاريخ الحقيقي قد يكون ذلك المحفوظ في الصدور، ولم يكتب، لأنه من غير المسموح له أن يكتب.
ومع ذلك تظلّ العلاقة بين المدّون وغير المدّون معقدة جداً، ولعلنا نجد في السجال حول الشعر الجاهليّ مثالاً نموذجياً لهذه العلاقة المعقدة، خاصة منذ أن قدّم طه حسين أطروحته حول انتحال هذا الشعر في كتابه «في الشعر الجاهليّ»، ونذكر أن الشاعر والباحث الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني أخذ على أطروحة طه حسين تلك تجاهل صاحبها للسّمات (الشّفاهيّة) التي ينطوي عليها عصر التّدوين كعصر مخطوطات، كأنّ ثاني يرغب في القول بأنّ بدء التّدوين لم يعنِ - بصورة تلقائيّة - انتهاء الشّفاهة في الأدب، فحجم ما دوّن حينها كان قليلًا قياسًا إلى حجم المنتوج الأدبيّ - والشّعريّ بخاصّة - أي أنّ الجزء الأكبر ظلّ شفاهيًّا تتوارثه الألسنة، ولم يندثر بالضّرورة - رغم كونه شفاهيًّا - ويضع ثاني أطروحة طه حسين في سياق الكثير من ما وصفها بـ(الأطروحات الحديثة عن التّاريخ الثّقافيّ العربيّ التي تحاول إقصاء البداوة والسّكوت عنها).
والمرجّح أنّ أحمد راشد ثاني صاغ ملاحظته هذه من وحي أطروحة الباحث السعودي سعد الصّويان حول العلاقة بين الشّعرين الجاهليّ والنّبطيّ التي لا يراها علاقة أدبيّة فحسب، وإنّما تاريخيّة/ حضاريّة/ أي بمعنى أنّها «علاقة طبيعيّة عضويّة أساسها النّسب اللغوي والفنيّ، وقوامها الاستمراريّة التّاريخيّة والحضاريّة بين مجتمعات الجزيرة العربيّة من العصور القديمة حتّى الآن»، بلْ إنّ الشّاعرين النّبطيّ والجاهليّ يلتقيان، حسب الصّويان «على صعيد واحد من الرّؤية الحضاريّة والحسّ الفنيّ وشعرهما ليس إلّا صدى لنفس الظّروف الطّبيعيّة والاجتماعيّة القاسية ومن هنا فإنّ التّشابه اللغويّ بين الشّعرين «تشابه تلقائيّ» لا شعوري يمليه تشابه الظروف والمعطيات التي تتكوّن منها مادة الشّعرين. والقصيدة النّبطيّة ليست مجرد تقليد ومحاكاة للقصيدة الجاهليّة، بل هي امتداد لها وهي عمليّة خلق وإبداع مستجدّة، تخضع لنفس الأساليب الفنيّة والظروف الحضاريّة التي كانت توجّه الشّعر الجاهليّ وتتحكّم في شكله ومضمونه. الشّاعر النّبطيّ لا يتجشّم معارضة قصيدة جاهليّة معيّنة، ولا يتكلّف تقليد بيت بعينه، ولكنّه يطرق نفس المهيع ويغترف من نفس المعين، ويصدر من نفس الموارد التي استقى منها الشّاعر الجاهليّ مادته وأغراضه»، ولذلك «لا تختلف القصيدة النّبطيّة عن القصيدة الجاهليّة في التّصوّر الفلسفيّ الذي تقدّمه تفسيرًا، لهذا الكون ولحياة الإنسان على هذه الأرض ولا تختلف عنها في المفاهيم والمثل التي تُكرّسها؛ لتعطي حياة الصّحراء القاسية معنى يعين على تحمّلها».
عند مسألة الشّفاهية في الشعر الجاهليّ وقف أيضًا النّاقد والأكاديميّ السّعوديّ عبدالله الغذامي، الذي وإنْ لم يقطع برأي حول الشّكوك التي أحيطت بظاهرة الشّعر الجّاهليّ، فأسباب هذا الشّك - كما رأى- كثيرة، وربّما تكون موضوعيّة أيضًا بالنّظر لكثرة الشّاكين، ممّن هم موضع ثقة علميًّا، لكنّ أسباب اليقين موجودة وكثيرة أيضًا، ملاحظًا أنّ الظّنون حول انتحال الشّعر الجاهليّ قادت - تاليًا - إلى الانتباه إلى شفاهية هذا الشّعر سواء أكان ذلك عند الباحثين العرب أم الأجانب المستعربين. فرواية الشّعر الجاهليّ كانت شفويّة حتّى بعد أنْ دوّنت فما جرى تدوينه «لم يكن نقلًا للشّفاهيّ إلى الكتابيّ ولكنّه تسجيل خطّيّ للرّواية الشّفاهية». وعليه فإنّ الشّعر الجاهليّ الذي نتداوله الآن هو الشّعر المرويّ وليس المدوّن، فالتّدوين ثبّت الرّواية الشّفويّة.
ولا يذهب الغذامي إلى حدّ اعتبار كلّ الشّعر الجاهليّ خالص الشّفاهية، فالشّفويّة - بتقديره - هي سمة رواية هذا الشّعر لا إبداعه، ليست في الإنشاء وإنّما في النّقل، فتسرّبت الشّفاهية إلى الشّعر الجاهليّ وسادت فيه بسبب الرّواة وليس بسبب الشّعراء أنفسهم الذين وضعوا تلك القصائد، وإنّ الإبداع الجاهليّ كان يتّسق مع شروط الكتابيّة أكثر من اتّساقه مع شروط الشّفاهية، فهو فرديّ يقوم على نص أصيل فرد وعلى آليّات الإنشاد الشّعريّ الغنائيّ حتّى لو كان الشّعراء الذين كتبوه لا يعرفون الكتابة.
قدّم الاستعراب الرّوسيّ إضافة مهمّة في هذا السّجال حول الشّعر الجاهليّ، مثّله خاصة رأي المستعرب الرّوسيّ الأشهر كراتشكوفسكي الذي قال إنّه «لا يكاد أحد من العلماء في الوقت الحاضر يشكّ في أنّ قسمًا من الشّعر الجاهليّ منحول»، ولكنّ هذا لا يجب أنْ يعني بأنّ كلّ هذا الشّعر منحول، وهو الرّأي الذي جاهر به المستعرب الإنجليزيّ مرجليوث الذي بلغ حدّ القول إنّ العرب لم يكن لديهم شعر كنوع أدبيّ قبل نشوء الإسلام، وهذا ما حمله على الزّعم بأنّ جميع نماذج الشّعر الجاهليّ الأقدم موضوعة ومنحولة في وقت متأخّر.
ويرى كراتشكوفسكي أنّ المنحول أيضًا ينبغي اعتباره أثرًا من آثار الماضي القديم؛ لأنّه من (صنع) شخص بلغ من القدرة على التّغلغل إلى كنه الماضي العربيّ بحيث لا يمكن أنْ يكون أي جزء تفصيليّ من عمله مناقضًا للصّدق التّاريخيّ والسّيكولوجيّ، وهو رأي جدير بالوقوف عنده، وبسبب سير النّقل الشّفهيّ من جيل لجيل كان لا بدّ أنْ تطرأ على المنقول من الشّعر تغيّرات، نظرًا لأنّ حفظة التّقاليد الشّفهيّة لم يحفظوها عن ظهر غيب، وإنّما كانوا كمن يخلقها من جديد بمساعدة التّكنيك الشّفويّ - الصّياغيّ؛ لأنّ القسم الذي حفظ من الشّعر الجاهليّ القديم ليس تدوينًا حرفيًّا للأبيات التي قالها في وقت ما شاعر عظيم، وإنّما هي الرّواية المقاربة أكثر أو أقلّ لتلك الأبيات، والمحرّفة بالأخطاء المرتكبة لدى نقلها الشّفويّ الذي جرى أثناءه الاستذكار.