الشفوي والكتابي
العدد 53 - التصدير
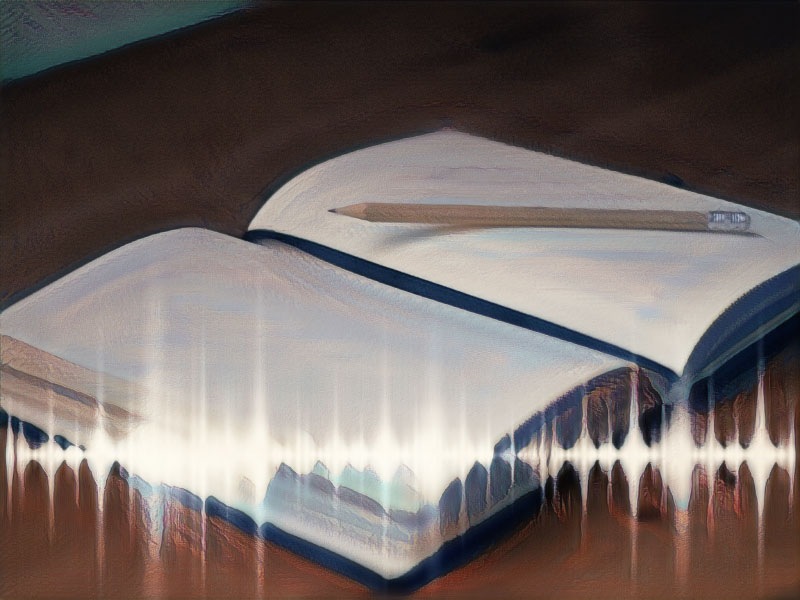
على كثرة ما كتب حول ثنائية الشفوي والكتابي، المحكي والمدّون، إلا أن هذا الموضوع يبقى حاضراً، خاصة عندما يتصل الأمر بصون الثقافة الشعبية، التي تعدّ خزاناً ثرياً للذاكرة الوطنية والقومية الخاصة بكل بلد أو أمة أو جماعة، أو بالذاكرة الإنسانية عامة.
الكتابة أو التدوين، كما نعلم جميعاً، هي مرحلة لاحقة للشفاهي أو المحكي، ومع أن الكثير من المحكي تمّ تدوينه في مراحل مختلفة من تواريخ الأمم والبلدان، إما بفضل الجهود المبذولة على صعيد كل بلد يولي ثقافته الشعبية ما هي جديرة به من اهتمام، أو بفضل الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، إلا أن الكثير أيضاً من التراث الشفوي ما زال خارج التدوين، ومهدداً بالضياع مع تقادم الزمن، ورحيل الكثير ممن يحفظون في صدورهم وعقولهم جوانب من هذا التراث.
في التراث الشفوي هناك ما يمكنّ ان نعده «كنوزاً مخبوءة تحتاج إلى البحث والاكتشاف»، وفق تعبير الباحث الدكتور نبيل جورج سلامة في الكتاب الذي كرّسه لـ«التراث الشفوي في الشرق الأدنى ومنهجية حمايته»، خاصة وأن اكتشاف الكتابة لم يؤد، بصورة تلقائية، إلى تعميمها على جميع الشعوب والأمم، وكذلك على كافة الفئات داخل كل شعب وأمة، حيث ظلّ التعليم، ولفترة طويلة، أقرب ما يكون إلى الإمتياز الذي لا يحظى به إلا أفراد الفئات المقتدرة، ورغم الشوط الكبير الذي قطعه العالم في محاربة الأمية، إلا أن هذه الأمية ما زالت تتناسل في الكثير من البلدان، إما بسبب ضعف الخدمات التعليمية أو الصعوبات المعيشية وما إلى ذلك من أسباب.
غاية القول إن التراث الشعبي الشفوي ما زال زاخراً بأوجه الإبداع والتعبير عن التجارب الإنسانية، التي ظلّت مجهولة أو منسية أو مقصاة عن دوائر البحث والاهتمام، ما يجعل معرفتنا بالتاريخ الإنساني عامة، والثقافي منه خاصة، ناقصة، ولنا أن نخال كيف كانت ستكون الذاكرة الإنسانية فقيرة لو لم تتوارث الأجيال الكثير من الفنون والعادات والطقوس التي تختلف باختلاف البيئات، لا الطبيعية وحدها، وإنما الاجتماعية والثقافية والمعتقدات الدينية على أنواعها، وقد سهّل هذا التوارث على الباحثين لا رصد معالم ذلك التراث، وإنما الغوص في البحث عن دلالاته الاجتماعية، وارتباطه بمستوى التطور في كل مرحلة من مراحل المعراج الإنساني الطويل نحو الحاضر، وتالياً نحو المستقبل.
وما زال متعيناً مواصلة البحث في هذا المجال، كي نغرف من هذا التراث ما يساعدنا لا على فهم الماضي وحده فحسب، وإنما أيضأ استلهام ما في هذا الماضي من أوجه إبداع لإثراء الحاضر الذي يجنح، وبوتائر سريعة، نحو فضاءات تتنكر للعالم الروحي للإنسان، ويغدو تقنياً، آلياً، خالياً من الدفء الإنساني الذي عرفته الأجيال السابقة، التي كانت أكثر تصالحاً وتوائماً وألفة مع محيطها.
هذا الأمر يعني كثيراً في مجتمعاتنا العربية الثرية بتراثها الشفوي بكافة صوره، المحكية والمغناة وغير ذلك، وهذا القول ينطبق على كافة هذه المجتمعات دون استثناء، وعلى صلة بذلك تستوقفنا مقالة مهمة للشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد عن الأدب الشعبي في فلسطين، حواها كتاب قديم له عنوانه «عن الأدب والأدب الشعبي الفلسطيني»، صدرت طبعة له عن دار العودة ببيروت في العام 1970، ومع إدراكنا للخصوصية الفلسطينية في هذا المجال، كون تراثها مهدداً بالتغييب والاقتلاع ، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمحو الذاكرة الوطنية الفلسطينية، إلا أن بعض ما تناوله توفيق زياد من أحكام، يصحّ، بدرجة كبيرة، على مجتمعاتنا العربية كلها.
وتهمّنا هنا ملاحظة أتى عليها زياد، حين لاحظ أنه مع ما للأدب الشعبي من ميزات إيجابية، لا تعدّ ولا تحصى، فإن له، بالمقابل، ميزات في غير صالحه، وتجعله مهدداً بخطر الضياع والتبدد، بينها حقيقة أن الكثير من هذا التراث هو محلي صرف، والمحلية هي دائما سابقة للوطنية، أو أنها في درجة أقلّ منها كما نعلم، دون أن يقلل ذلك من أهمية التراث المحلي المقتصر على منطقة بعينها في أي بلد من البلدان، أو فئة مهنية أو حرفية من فئاته، أو حتى على جماعة لها معتقدات دينية خاصة بها، في إطار البلد الواحد أو الأمة الواحدة.
على الصعيد الفلسطيني أعطى توفيق زياد أمثلة بالغناء الشعبي، «ففي كل منطقة وناحية ومجال مهني، ونحن هنا ننقل قوله، الأغاني «الخاصة» به، فأغاني الجليل والمثلث وصيادي الأسماك والمكارية والتهاليل والمرثيات (التناويح) والأعراس وقصص الكفاح ضد الحكم التركي والبريطاني وغيره عديدة ومتنوعة».
وهذه ليست نقيصة بحد ذاتها، ولكن إن لم تبذل جهود لصونها ودمجها في النسيج الوطني الأشمل للأدب الشعبي في البلد المعني، فإنها ستظلّ أكثر عرضة للاندثار والضياع، وإن كان هذا الأمر يصحّ أيضاً على «الأغاني والقصص والأساطير التي ارتفعت إلى مستوى أرقى وأصبحت عمومية»، بتعبيره.
هذه الحقيقة، أو فلنقل المحذور، ينبغي ألا يصرف الأنظار عن المشتركات والجوامع بين الثقافات المحلية أو الفرعية في المجتمع المعني، وفي المشهد البانورامي الخاص بالثقافة القومية لأي أمة من الأمم، وعلى سبيل المثال، فرغم وجود ما يمكن أن ندعوه بالخصوصية المحلية في الثقافة الشعبية في بلدان الخليج العربي، تبقى المرجعيات التاريخية والتعبيرات والرموز واحدة، من حيث الجوهر، إذا ما قيس الأمر بالإطار الجامع للثقافة العربية.
وحين نتحدث عن الثقافة في منطقة الخليج، إنما نتحدث عن ثقافة عربية، شأنها في ذلك شأن الثقافة في أية منطقة عربية أخرى، همومها هي من صميم الثقافة والمثقفين عبر الوطن العربي كله، حيث تأثرت وتفاعلت هذه المنطقة مع مكونات وتعبيرات الثقافة العربية العامة، بل ومع كثير من تفرعاتها خاصة، وهذا ما تشهد عليه مصادر تكوّن الرعيل الأول من المثقفين والأدباء في مختلف بلدان المنطقة.
وخلف بساطة الحياة في مجتمعات الخليج قبل اكتشاف النفط يكمن غنى طرائق العمل وأدواته ورموز الثقافة الشعبية، من حرف يدوية وموسيقا ورقصات متنوعة تبعاً لتنوع البيئات المختلفة، وكذا الأساطير والحكايات الشعبية والألعاب، ولو توغلنا أكثر في البحث لوجدنا ذلك الاتساق بين مستوى الحياة وطبيعتها وبين هذه الرموز الثقافية وصدقها في التعبير عن ظروف الحياة الصعبة وحالات الحرمان وشظف العيش، فأيّ باحث، لا تستوقفهُ، مثلاً، الشحنة الرمزية الهائلة من الأشواق والعواطف والشجن والشكوى في أغاني الغوص مثلاً، أو في المواويل الشعبية؟
كان أنطونيو غرامشي قد لفت النظر إلى وجود ما أسماه بـ «الفلسفة العفوية» في الحس الشعبي المشترك وفي الأمثال الشعبية والأساطير والفولكلور، رغم أنه نبه إلى أنه قد يحدث أن من ينتجون هذه «الفلسفات» أو يتداولونها لا يكونون واعين تماماً لذلك، ونحسب أن مهمة الباحثين في هذه «الفلسفة العفوية»، الشفوية في الغالب، استجلاء تلك المعاني.




































































