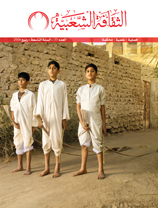الثقافة الشعبيّة بين الإقصاء والموضوعيّة
العدد 7 - آفاق

لا تخفى نزعة بعضهم إلى إقصاء الثقافة الشعبيّة من حركة الثقافة القوميّة والعالميّة. ولهذا الإقصاء مبرّرات ودوافع معروفة، كادت لتجذّرها التاريخيّ تكون عند أصحابها من المسلـّمات. فقد اختلفت المواقف بين مدافع مساند من جهة، ومهاجم معاد من جهة أخرى. إذ يرى الشقّ الأوّل أنّ الثقافة الشعبيّة تمثّل وجوه التفرّد والتميّز والأصالة المشكّلة للهويّة. وذلك باعتبار قدرتها على الصمود أمام المؤثّرات الزمانيّة وأمام الغزو الثقافي الأجنبي. بينما يرى الشّقّ الثاني أنّها تمثـّل صورة نابضة عن تخلـّف المجتمعات العربية، تشدّ الشعوب إلى الماضي وتجعلهم يعيشون حاضرهم بماضيهم، فيخسرون بذلك مستقبلهم. فيمثـّل القضاء على مظاهرها أولى الخطوات نحو التّقدم والتّطور واللـّحاق بركب الحضارة.
ولا شكّ أنّ واقع التخلّف الذي تعيشه الشعوب العربيّة اليوم يعمّق الهوّة بين الشقّين ويقوّي النزعة إلى تحميل الثقافة الشعبيّة العربيّة مسؤوليّة هامّة في ما آل إليه حال العرب باعتبارها ممثّلة لثقافة “الشعب”، أي لثقافة المجموعة الطاغية عددا، والمساهمة بطريقة مباشرة وفعّالة في تشكيل الصّورة الحضاريّة للأمّة.
وهذه الآراء المختلفة تنبّهنا إلى أنّ هذه المواقف لا تخلو من خلفيّة إيديولوجيّة تحاول أن تلبس لبوس الموضوعيّة والعلميّة. وهي خلفيّة تشرّع للباحث عن الحقائق مساءلة هذه المواقف والنظر في مدى شرعيّتها: هل تولـّدت من منهج علميّ؟ أم هي تكريس لسلوك عنصريّ؟
لا يخفي أنّ الأزمة التي تعيشها الثّقافة الشّعبيّة1 تعكس أزمة الثقافة العربيّة عامّة وأزمة المثقّف العربيّ خاصّة. فـ«الثقافة العربيّة اليوم في مأزق...وبين مفارق طرق2». وليست المواقف المختلفة من الثقافة الشعبيّة إلا انعكاسا لهذه الأزمة.
فالثقافة الشعبية كانت ولا تزال موضوعا مشكلا. وقد تجلّى ذلك من خلال ما تثيره من إشكاليّات في وجوه مختلفة من تناول الباحثين لها. سواء أكان ذلك من حيث تحديد مجالات البحث الخاصة بها أم من حيث موقعها من الثقافة العالمة أم من حيث موقف المؤسّسات الرّسمية منها أم من حيث المنهج الذي تستوجبه في الدراسة. وجميع هذه الأطروحات تعكس ما تثيره هذه الثقافة، لدى المثقفين المتعلّمين عامّة والأكاديميين خاصّة، من شعور بالإحراج والتّردد في التّعامل معها .
وإنّا نكاد نجزم بأنّ المثقّف العربيّ سواء أكان من المناصرين أم من المقصين، لم تبلغ نفسه طمأنينة القناعة والاقتناع التي يسعى إليها. فهو يعيش صراعا بين عقله ونفسه يجعله بالضرورة ذاتا غير متوازنة وغير قادرة على التمييز. فهذه الأشكال الثقافيّة موجودة بالقوّة شئنا ذلك أم أبينا. وهي جزء من مجتمعاتنا متجذّر،هي جزء من كياننا قد أثبت التاريخ أنّنا عاجزون عن التّخلّص منه مهما حاولنا، يتجدّد من زمن إلى آخر ويقاوم مؤثّرات المكان والزمان. وهذا الأمر يستلزم منّا أن نضع الموقفين موضع المساءلة: فموقف الإقصاء والتهميش يدعونا إلى مراجعة الأسباب المحرّكة له: لمَ هذا الإقصاء؟ وإلى أيّ حدّ يمكن أن يمثّل الحقيقة في زمن تلاشى فيه مبدأ الإطلاق وترسّخ مبدأ النسبيّة؟ و موقف المناصرة يدعونا إلى تحديد الموضوع: ماذا نناصر؟ وعمّا ندافع؟ علّ هذه الأسئلة تنتهي بنا إلى توحيد المنهج في التناول.
1) المقابلة بين الطبيعة والثقافة :
لئن كان هذا الإقصاء يقوم في الظاهر على محدّدات علميّة منهجيّة يفرضها تحديد المفاهيم وضبط المجالات، فإنّه مسيّر في الباطن بنزعة عنصريّة استعماريّة، يفرضها المنهج الإقصائي من جهة وعلاقة الثقافة بمراكز القوى من جهة أخرى. فتحديد مفهوم“الثقافة الشعبيّة” قد تولّد من اعتبار مقياسين متعالقين: العلم والزمن.أمّا المقياس الأوّل فقد ولّد المقابلة بين الثقافة العلميّة والثقافة العامّة3. وأمّا المقياس الثانيّ فقد ولّد المقابلة بين الحداثة والتراث. وليست المقابلة الأولى إلاّ وليدة اعتبار المقابلة بين الثقافة والطبيعة (Culture/Nature). فارتبطت الثقافة بـ“التكوين” و“التهذيب” و“التعليم” و“العناية” و“الصيانة” و“المعالجة”. “فما على الإنسان أن يثقّفه هو عقله قبل كلّ شيء. ومن هنا تعدّ الثقافة معرفة أو فنّا”4 . فتكون الثقافة بذلك مفارقة لكلّ ماهو طبيعيّ، فطريّ باعتبار أنّه “لا يحتاج إلى نظر ولا علم”5 . “ذلك أنّ النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيّئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير وشرّ”6 . وهو ما يجعلها محتاجة إلى “الفكر المائز بين ما يناسب ومالا يناسب وما يصحّ وما لا يصحّ”.7 وهو فكر لا يتاح إلاّ لمن أجهد نفسه في تحصيل المعرفة بالتعلّم والاكتساب.
وقد تحوّلت المقابلة بين الطبيعة والثقافة، مع كانت Kant، إلى مقابلة بين الطبيعة والعقل8 .Nature/Raison فالذات التي تترك نفسها للطــبيعــة، لأحكامها و قوانينها ذات ضعيفة، تابعة لأهوائها و حاجياتها الحيوانيّة. أمّا الذات المستقلّة فهي التي تخضع للعقل و تحتكم إليه.
فالثقافة سعي متواصل نحو التقدّم و التحضّر ممّا يجعلها متعلّقة بمفهوم التطوّر. وهذا ما يستدعي المقياس الثاني المتمثّل في العامل الزمني. فالظواهر الثقافيّة ظواهر متغيّرة أبدا، متأثرة بالضوابط المكانيّة والزمانيّة التي تظرفها. فتقاس الظواهر بمدى مواكبتها لهذه الصيرورة الزمانيّة. ذلك أنّ العامل الزمني يعدّ عاملا إيجابيّا في حركة تثقيف العقل البشريّ. إذ تقترن الطبيعة بالبدائيّة وتقترن الثقافة بالحضارة. فـ“الحضر...متأخّر عن البدو وثان عنه”9. و“التمدّن غاية للبدويّ يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها”10. فيكون سعي الإنسان إلى التمدّن والتحضّر أمرا طبيعيّا يكاد يكون فطريّا لديه باعتباره كائنا عاقلا مدنيّا بالطبع.
ولئن كانت الثقافة تنزع إلى مفارقة كلّ ما هو طبيعيّ باعتبارها اكتسابا وتهذيبا وتطويرا قائما على الجهد والإجهاد، فإنّ المبدع في الثقافة الشعبيّة، حسب هذه الأطروحة واعتبارا لهذه المقابلة، لا يعوّل إلاّ على موهبته الفطريّة الطبيعيّة. فلا يسعى إلى تهذيبها وتقنينها بالمعرفة والعلم. وقد ذهب حازم القرطاجنّي إلى “أنّ الطباع قد تداخلها من الاختلال والفساد أضعاف ما تداخل الألسنة من اللحن. فهي تستجيد الغثّ وتستغثّ الجيّد من الكلام ما لم تقمع بردّها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغيّة. فيعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن”11.
ومن هنا كانت حاجة الثقافة الشعبيّة إلى الثقافة العالمة، باعتبار حاجة الطبع إلى الفكر،“الفكر المائز بين ما يناسب ومالا يناسب وما يصحّ وما لا يصحّ”12. فالإبداع الحقّ هو الذي يجمع بين «الطبع الفائق والفكر النافذ الناقد الرائق»13. وهو أمر لا يحصل إلا بالمعرفة «المعرفة بجميع ما يحتاج إلى معرفته في هذه الصناعة من حفظ الكلام والقوانين البلاغيّة»14.
وهذا ما يجعل الناقدين اليوم يفاضلون في الشعر مثلا بين ما كان بلغة عربيّة فصيحة وما كان باللهجات الدارجة، باعتبار أنّ الفصحى تمثّل النموذج الأمثل والشكل الأرقى للعبارة عن الصورة والمحاكاة والتخييل، ولا يخفى الدور الذي تلعبه سمة القداسة المنوطة بها باعتبارها وجه الإعجاز وأداته، ولا سيطرة نموذج القصيدة التقليديّة وتحكّمه في الذائقة العربيّة وتحديده لمقاييس الجماليّة في الإبداع الشعريّ. فتعدّ جميع أشكال التحوّل التي تطرأ على لغة القرآن ولغة الشعر القديم، والمتجلّية في اللهجات المختلفة ضربا من الفساد والإخلال والانتهاك. فصارت العربيّة الفصحى هدفا وغاية، تكتسب بالتعلّم، ويتفاضل فيها المكتسبون فصاحة وبلاغة، ممّا يولّد التفاضل في تصنيف الشعر والشعراء .
غير أنّ التمييز بين ما هو طبيعيّ فطريّ وما هو ثقافيّ مكتسب بقي معوقا بما يشوب هذه المفاهيم من ضبابيّة و نسبيّة. فهذه المصطلحات، رغم ما بذل في تحديدها من جهد، مازالت حدودها غير صارمة، وما انفكّت الظواهر الإنسانيّة متنازعة بين ما هو فطريّ طبيعي وما هو ثقافي علميّ مثل اللغة والاجتماع والسلوك....و هذا ما يجعل الثقافة مصطلحا فضفاضا يتّسع ليشمل جميع الأنشطة الإنسانيّة اتّساعا يستلزم تحديد أصناف، ومستويات تتفاوت قوّة وضعفا حسب مدى استنادها إلى العقل ومواكبتها للعصر.
2) الثقافة وإيديولوجيا الهيمنة :
إنّ تعلّق الثقافة بالإنسان في جميع أبعاده تجعل هذا المجال مترامي الأطراف، متشابكا مع مجالات أخرى، لا يمكن أن يستقلّ بنفسه. ولا سبيل إلى أن يفلت من المؤثّرات السياسية والاقتصاديّة. فهو مجال،على اتّساعه، مكبّل بإيدلوجيا الهيمنة، وموجّه مسيّر حسب رغبات القوى المسيطرة، السياسية منها والاقتصاديّة. فلا يخرج صراع الثقافات عن إطار الصراعات الحضارية التي تعيشها الشعوب وعن الرغبة الملحّة في تصدّر أولى المراتب في السّباق الحضاريّ العالميّ. وليس الموقف من الثقافة الشّعبيّة إلّا عاكسا لرؤية في التّعامل مع الأوضاع الرّاهنة ومصوّرا للمسلك الذي يرتئيه المفكّر لتحقيق التّطوّر وكسب السّباق.
وليست أزمة الثقافة الشعبيّة بنابية عن أزمة الثقافة العربيّة عامّة. وليست أزمة الثقافة العربيّة إلا عاكسة لأزمة الحضارة العربيّة. وما أزمة الحضارة العربيّة إلا وليدة الأزمة السياسية. إذ«على قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة»15 . ومن المسلـّم به أنّ كلّ قوّة تسعى إلى السيطرة، إذ لا تستلذّ قوّتها إلاّ بضعف الآخر ولا تختبر قوّتها إلا بخضوعه.
ولم يسلم السّلوك الثقافيّ من هذه السياسة. فكما أنّه“من طبيعة الملك الانفراد بالمجد”16 ، فإنّ من طبيعة الثقافة “الانفراد بالمجد”. فالملك والحضارة والثقافة ثالوث متلازم يصعب إفلات أحدها من الآخر. و هذا ما يجعل الثقافة العربيّة في هذا العصر مستهدفة من الخارج أي من نزعة الثقافة الأجنبيّة إلى السيطرة، ومستهدفة من الداخل، من أبنائها الذين يرون في ثقافة الأمم العظيمة القويّة الثقافة المنشودة، الثقافة الهدف. فيسعون في مسيرة كفاحهم نحو التطوّر إلى القضاء على المظاهر الثقافيّة المخصوصة التي تفارق الثقافة الهدف وتوسّع الهوّة بين الراهن والمنشود.
فالاختلاف الثقافيّ يمثّل في الرؤية السياسية الاستعماريّة مظهرا من مظاهر الاستقلاليّة، والاعتزاز بالذات، والثقة بالنفس، والرفض للتبعيّة. وهي عوامل من شأنها أن تعيق مسيرة الهيمنة والنزعة الاستعماريّة. ولذلك فإنّها تسعى بطرق شتّى إلى تهميش الأشكال الثقافيّة التي تعكس الاختلاف والتميّز وانعدام المشابهة حتّى يسهل عليها بلع الثقافات المغايرة وهضمها. وقد أبدع شاعرنا أبو القاسم الشابيّ 17 في التعبير عن هذا النهج السياسيّ في قصيدته“فلسفة الثعبان المقدّس” فيقول الثعبان مخاطبا الشحرور:
أفلا يسرّك أن تكون ضحيّتــــي
فتحلّ في لحمي وفي أعصابــي
وتذوب في روحي التي لا تنتهي
وتصير بعض ألوهتي وشبابي..؟
فتتجلّى غطرسة الثقافة الغالبة وجبروتها وتعاليها ولؤمها في تجميل صورة التبعيّة والتلاشي.
وهذه النزعة نفسها هي التي جعلت الثقافة العالمة، التي تعالت على ما اعتبرته دونا لها، تقاس بالمقياس نفسه. فتمارس عليها العلوم الصحيحة السلوك المتعالي عينه. فالإشكال بدأ مذ بدأ تحديد مفهوم الثقافة باعتباره مفارقا ومقابلا لمفهوم الطبيعة. وتدعّم بالمقابلة الأكبر بين العلوم الصحيحة والانتروبولجيا التي ناضلت لتكون “علما” وانتزعت لقب علوم إنسانيّة بعد جهد جهيد. ورغم ذلك ظلّ نعت هذه العلوم بـ“الإنسانيّة” مفارقا لنعت العلوم الأخرى بأنّها “صحيحة”. ثمّ كان التمييز داخل العلوم الإنسانيّة بين “الفلسفة”وغيرها من العلوم الإنسانية، مثل علم النفس وعلم الاجتماع واللسانيّات. ثمّ كان التمييز في مجال الثقافة بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبيّة. وقد اتّخذت هذه الهرميّة شرعيّتها بترسيخها في عقل الإنسان مفهوم “ضرورة التضحية لتحسين الجنس البشريّ”18 بتسليط العقل على النفس، وبإنكار أشياء نحن نشعر بأنّ أنفسنا متعلّقة بها وبأنّه يصعب تجاهلها لأنّها جزء من ذاتنا ومن وجودنا ومن إنسانيّتنا.
فلم تسلم هذه التحديدات العلميّة من الممارسات العنصريّة ومن أساليب التسلّط. ولم تكن علاقة التقابل فيها علاقة لغاية التحديد والتمييز وضبط الخصائص. بل كانت علاقة قائمة على التراتبيّة والتفاضل. إذ قامت جميعا على علاقات هرميّة تتصدّر فيها العلوم الصّحيحة القمّة، ثمّ تتراتب بقيّة العلوم حسب معيار التّقارب والتّشابه بالعلوم الصحيحة في مدى القدرة على الاستدلال البرهاني القابل للإثبات أو الدحض بالتجربة والاختبار والحساب.
ولم تسلم الحضارة العربيّة من هذا التمييز التفاضليّ فنجد ابن خلدون19 يميّز بين «الفلاحة» باعتبارها«بسيطة وطبيعيّة فطريّة لا تحتاج إلى نظر ولا علم »و«الصنائع» باعتبارها «مركّبة وعلميّة تصرف فيها الأفكار والأنظار». ولا يتوانى عن نعت هذه الصنائع بأنّها «شريفة»، وهو شرف لا تستمدّه من ذاتها فحسب، باعتبارها صنائع فكريّة قائمة على العقل والتدبّر، بل من علاقتها بالملك باعتبار أنّها تمارس في رحاب القصور.
ونسي هؤلاء المفاضلون المتوسّلون بالآليّات العلميّة أنّ من الشروط العلميّة أن لا يكون الاختلاف مدعاة للمفاضلة، فيتحوّل معيار التقييم أخلاقيا قائما على التحقير و التعظيم.20
فلا سبيل للإنسان أن يتخلّص من ذاتيّته حتّى في أكثر المجالات علميّة، وفي أوج ادّعائه للموضوعيّة والتجرّد. وقد ولـّى العصر الذي كان فيه العلم فوق مستوى المساءلة باعتباره فوق مستوى التأثّر والخضوع. وقد كان المؤرّخون للحركات العلميّة أكثر الباحثين وعيا بهذه المسألة. فشرّعوا التساؤل حول علاقة العلم بالإيديولوجيا، وعلاقته بالأخلاق، وعلاقته بالسياسة. وطرحوا في مؤلّفاتهم التاريخيّة ما يحرّك العلوم من مصلحيّة ومنفعيّة من شأنهما أن يطمسا الحقائق العلميّة ويقضيا على صرامة علميّة المناهج المتّبعة21. وهو ما يؤكّد الوعي بأنّ العلوم لا تعدو أن تكون ممثّلة لزاوية في النظر خاضعة لمبدإ النسبيّة باعتبار أنّ الحقيقة في حدّ ذاتها ليست إلا ما نعتقد أنّه ممثّل للحقيقة. وهو اعتقاد قابل للتحوّل والتغيّر.
فوجود أنواع مختلفة من الثّقافات تتفاوت قوّة وضعفا، وتقييمها تقييما أخلاقيّا قائما على التّفاضل، إنّما يعكس المفارقة التّاريخية التي تعيشها الإنسانيّة بين الفكر والسلوك. فهي، فكريّا، في سعيها إلى التّطوّر والارتقاء تحمل شعار الحريّة والمساواة واحترام الآخر وقبول الاختلاف باعتبارها ممثّلة لمبادئ التنوير. غير أنّها سلوكيّا، قد أثبت التاريخ أنّ ما تعيشه من صراع بين الشعوب، ليس سوى صراع ثقافي تهيمن فيه ثقافة على ثقافة أخرى وتتوّج فيه ثقافة دون ثقافة أخرى.
3) مبدأ تجزئة العلوم :
إنّ قراءة تاريخ العلوم قد أثبتت أنّ مبدأ التفرّد والاستقلال في مجال العلوم عامّة والعلوم الإنسانيّة خاصّة، مبدأ جدواه محدود ولا بدّ أن يؤول إلى مبدإ التعالق والترابط. فتعالق هذه العلوم، على تنوّعها واختلافها، في شكل هرميّ قوامه المفاضلة ومقياسه تحديد مراتب العلوّ والتّدنّي من شأنه أن يضيّع الهدف الأوّل والأساسيّ الذي من أجله وجدت هذه العلوم أصلا ألا وهو معرفة الإنسان»تحت كلّ وجوهه»faces 22.sous toutes ses
وليست هذه الغاية إلا وسيلة لتحقيق غاية أسمى هي معرفة الذّات واستبطان النفس. فلم يكن مبدأ التجزئة والفصل في دراسة الإنسان إلا منهجا لإدراك الكلّ في أدقّ جزئيّاته. و مآل هذه الأجزاء التجمّع من جديد. وهذا ما جعل الانتروبولوجيين، القدامى منهم والمحدثين، ( Saint-Simon,Cabanis,Chavannes)يؤكّدون أنّ “العلوم الإنسانيّة” ليست إلاّ “علم الإنسان” فيعيدون هذا الجمع إلى أصله المفرد ويجمّعون بذلك بين أجزاء لا تتّخذ قيمتها إلا بتجمّعها.“فالموضوع المشترك للعلوم الإنسانيّة هو الإنسان. ولا يمكن للإنسان أن يقطـّع قطعا مستقلة بعضها عن بعض”23.
وهي أجزاء لا تقوم في تكتّلها على شكل هرميّ يجذّر التفاضل، بل تمثّل في شكل شجرة لا تقوم إلا بجذورها و أغصانها وفروعها، فيفضي بعضها إلى بعض، ويولّد بعضها بعضا، ويستقيم بعضها ببعض. ولم يقص هذا المشجّر أيّ ظاهرة إنسانيّة حتّى ما كان منها من مجال الروحانيّات وما لم يكن للعقل والعلم قدرة على تفسيره. بل لكلّ ظاهرة موضعها من هذه الشجرة. وعلى العقل المدبّر أن يطوّر وسائله ليتمكّن من تفسيرها لا أن يؤدّي به عجزه وقصوره إلى إقصائها وتهميشها.
فهذا التنوّع ضروريّ في بناء المعرفة ونحتها. وقد أحسن ميشال فوكو Foucault Michel التعبير عن ذلك بحديثه في كتابه Les mots et Les choses عمّا سمّاه بـ “ Archéologie du savoir ”. فتكون وسيلة العالم الحفر والتنقيب وجمع الشتات. ويكون لكلّ ما نغنم به من هذه الحفريّات قيمة وأهمّية ودور في تحديد الشكل النهائيّ، مهما كانت هيأته ومهما كان حجمه. فعالم الآثار الحقيقي هو الذي يعتني بكلّ التفاصيل وشعاره لا للإقصاء ولا للتهميش.
وأن يستقيم السعي إلى بناء حضارة وتشكيل ثقافة على شيء من التقليد يعدّ أمرا طبيعيّا باعتبار أنّ “أهل الدّول أبدا يقلّدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم”24. وأن تندثر بعض الظواهر بشكل طبيعيّ لاستغناء الشعوب عنها بفعل حركة التطوّر والمثاقفة لا يمثّل إشكالا في حدّ ذاته. فهذا يعدّ أيضا انتقاء طبيعيّا يساعد سيرورة هذه الحركة. و لكن أن نتعسّف على بعض الظواهر الصامدة والموجودة بالقوّة فنحاول القضاء عليها، هو الخطأ بعينه. إذ أنّنا نكون بذلك غير مسايرين للتيّار الطبيعي الذي تسير فيه هذه الحركة.
فعدم اندثارهذه الظواهر دليل على أنّ لها موضعها فـي هـذه الحضارة ولهـا دورهــا الــذي لا يمـكن أن يضطلع به غيرها. وليس صمودها إلاّ دليلا على أنّ الحاضر لا يمكن أن يبنى على فراغ. فلهذا القديم دور في إنشاء الحديث سواء أ أدركنا ذلك أم لم ندركه. ولهذا الشعبيّ دور في تشكيل ذواتنا سواء أكان إيجابيّا أم سلبيّا في اعتبارنا. فهو يساهم بشكل من الأشكال في تحديد صورة الحاضر وتشكيل صورة المستقبل. ويصير من مهامّ الفكر المائز أن يساهم في الحفاظ على ما يراه مهمّا ومميّزا له حتّى يسلم من الشعور بالانبتات والاغتراب في عصر تقوّى فيه الصراع وتضخّمت الهيمنة الثقافيّة ورفض فيه التعدّد والاختلاف.
فنحن أمام ظواهر إنسانيّة موجودة بالقوّة ولا يملك الباحث العالم إلا أن يصفها ويحدّدها ويتعامل معها، بقدر من الموضوعيّة والتجرّد، وباعتبار خصائصها المميّزة وسماتها المحدّدة لكينونتها.
4) ضرورة المصالحة :
من يعتقد من المثقفين العرب أنّ معالجة قضيّة الثقافة الشعبيّة تتمّ بمجرّد عزلها وإقصائها عبر التهميش والتجاهل والإنكار فهو مخطئ لا محالة .إذ يكون غير واع بحقيقة هذه العلاقات التي تشكّل ملامح المجتمع باعتباره كلّا لا يتجزّأ. فـ«على قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة»25. و«الحضارة إنّما هي تفنّن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله»26. وبما أنّ الإنسان «ابن عوائده»27، فلا يمكن أن نتصوّر أنّه بمقدورنا التخلّص من هذه العادات بالسهولة التي يعتقدها البعض. فهي جزء من ماهيتنا وشيء من كينونتنا. ولا نعتقد أنّ الأزمة التي يعيشها المثقّف العربيّ إلا ناجمة عن الصراع الذي يعيشه في الجهد الذي يبذله في سعيه إلى تنقية الثقافة العربيّة من شائبات الثقافة الشعبيّة، دون أن يعي بأنّه يكون بذلك ساعيا إلى قطع جزء منه هو غير قابل للعزل. فمثله في ذلك مثل من يرى في دمه تلوّثا فيحاول تنقيته عبر التخلّص من بعضه، فينتهي به الأمر إلى استنزاف دمه كلّه، فيستحيل جثّة لا روح فيها.
فهذا الصراع ليس إلاّ صراعا مغلوطا، قد أخطأ وجهته، وجعل صاحبه يخبط خبط عشواء، فلا تزيده محاولاته للنجاة إلا انغماسا في وحل الحيرة والمعاناة. ولذلك فإنّ المثقّف العربيّ مدعوّ إلى أن يتصالح مع ذاته كي يجمّع شتاته ويوجّه صراعه الوجهة الصائبة. ونحن نعتقد أنّ المصالحة مع الثقافة الشعبيّة تمثّل وجها من وجوه المصالحة مع الذات. ولعلّ أوّل خطوة نحو تحقيق هذه المصالحة تبدأ بالقضاء على المعنى التّحقيريّ المضمّن في نعت هذه الثقافة بـ«الشعبيّة»باعتبارها محيلة على «الرعاع». فلا تأخذ الثقافة الشعبيّة مكانتها بتخلّص الثقافة العالمة من تعاليها بل بتخلّصها هي من دونيّتها.
فحالة «الاضطهاد» التي تعيشها الثقافة الشعبية، اضطهاد داخليّ يساهم فيه أبناء هذه الثقافة، واضطهاد خارجي تغذّيّه الثقافات الأجنبيّة بصور مباشرة وغير مباشرة، لها أبعاد تاريخيّة وأبعاد إيديولوجيّة وأبعاد نفسية وأبعاد سياسيّة اقتصاديّة، هذا لا شكّ فيه . ولكن يجب أن نقرّ بأنّ جميع هذه العوامل وجدت ما يدعمها ويقوّيها من الثقافة الشعبية ذاتها، بما تحمله في ذاتها من نقاط ضعف تساهم في تدميرها تدميرا ذاتيّا. وهي نقاط ناشئة حسب رأينا من انعدام التمييز وانعدام الرقابة الاجتماعيّة بسبب نزعة الإقصاء. فاختلط الحابل بالنابل والغثّ بالسمين. وفتح الباب على مصراعيه لكلّ من هبّ ودبّ ليولّد مخلوقات هجينة، مشوّهة لا شكل لها ولا لون، يسمّيها البعض فنّا وتحمل على الثّقافة الشعبيّة، وتجد لها، من بين العامّة خاصّة، المعجبين والمشجّعين. وهو ما يتسبّب في اشتباه الأمر على الناس. إذ أنّ «المعرّة لا شكّ منسحبة على الرّفيع في هذه الصنعة بسبب الوضيع.»28 فلذلك يهجرها الناس. فالنظرة الدونيّة التي تحفّ بالثقافة الشعبيّة تنبع منها لما يشوبها من اختلاط الرذيل بالرفيع فيها. ولذا فإنّها أكثر المظاهر الثقافية حاجة للفكر المائز حتّى لا يؤخذ البعض منها بذنب بعض. وهذا لا يكون إلاّ دور أصحاب الثقافة العالمة الذين يمتلكون الوسائل النقديّة الناجعة. فتكون وظيفتهم حماية الثقافة الشعبيّة من نفسها أوّلا، ثمّ من نظرة الاحتقار والازدراء التي ولّدت نزعة الإقصاء ثانيا. ولا بدّ أن يكون الفكر المائز هو ما نقيس به الظواهر الثقافيّة عامّة فنميّز فيها بين ماهو مفيد وما هو غير مفيد مع مراعاة العقل والنفس. وهو مقياس لا يمكن أن يكون موضوعيّا إلاّ إذا نظرنا إلى الظواهر الثقافية، على اختلافها، نظرة تجعلها في علاقة أفقيّة، يفضي بعضها إلى بعض ويأخذ بعضها برقاب بعض فتقوم العلاقة على الاسترسال لا على القطيعة. ونتخلّص من النظرة التي تجعلها في علاقة عموديّة قائمة على التفاضل وعلى التراتبيّة.
فالظواهر الثقافيّة هي في مجملها ظواهر مفيدة وصحيّة ترقى بالإنسان. وما هو ليس كذلك لا يمكن أن يكون ثقافة بأيّ شكل من الأشكال. وما على الناقد المتمحّص مصارعته هو الرداءة والسوقيّة والابتذال في جميع مظاهرها واستخلاص الإبداع الفنّي وإبرازه في جميع أشكاله دون أن يكون مستندا إلى التمييز بين ما هو شعبيّ وما هو غير شعبيّ.
فالأزمة التي تعيشها الثقافة العربيّة ليست أزمة إبداع إنشائي، بل هي أزمة إبداع نقديّ. فالنقد علم له أسسه وقواعده وقوانينه المضبوطة. وله سند في العقل قويّ يجعل الناقد يسعى أبدا إلى أن يقيّد نفسه بهذه القيود العقلانيّة الموضوعيّة حتّى يحقق غايته. قيود تجعله بالضرورة متّسما بالتعالي ومحددا قواعد انتقائيّة تجعل مادّة درسه قائمة على التفاضل.
وليس وضع الثقافة الشعبيّة في بلادنا العربيّة إلا نتاج خلل منهجيّ في استغلال المنهج النقدي العلمي، خلل يتمثّل في انعدام التمييز لدى الناقدين بين الموضوعيّة والذاتيّة. ويتجلّى ذلك بوضوح في الحكم على النّتاج الإبداعيّ من خلال الحكم على من أنتج هذا الإبداع. وينعكس ذلك في تسمية “الثقافة الشعبيّة” في حدّ ذاتها. فهو نعت يبرز سمة اجتماعيّة اقتصاديّة لفئة بشريّة، تضطلع الرؤية العنصريّة في إطار هيمنة الرأسماليّة، بتهميشها وتحقيرها. وهي رؤية ضروريّة في النظام الرأسمالي كي تشرّع الفئة الصغيرة لنفسها السيطرة على فئة تفوقها عددا. فتوهم نفسها وتقنع الشعب كلّه بحاجته الماسّة إليها باعتبارها القدوة والمثل والعقل. ونظرا لاستحالة الفصل والتمييز بين الثقافة والإيديولوجيا، يصعب التمييز بين الشيء ونظرتنا للشيء. فنحن لا ندرك الأشياء إلا من خلال قدراتنا العرفانيّة .
ولكن يبقى السؤال الجوهريّ: هل نتمكّن من تحقيق هذا الأمر ونحن كائنات تؤمن أنّ الطبقيّة والتفاضل وانعدام المساواة من قوانين الخلق والطبيعة، كائنات تسعى إلى التفوّق على من تعتبرهم دونا لها وتطمح إلى الإنسان الإله؟...
يبدو لنا أنّ هذا التساؤل يفقد كلّ شرعيّة إن كانت «الثقافة العالمة» هي،حقّا،«عالمة»كما تدّعي. إذ أنّ العلم لا يكون علما إلاّ إذا تعالى عن الأحكام الأخلاقيّة وتخلّص من الذاتيّة، ولم يخضع للسلوك العنصريّ. فالمنهج العلميّ يعتني بدراسة الأنظمة التي تقوم عليها الظواهر حتى نتمكّن من تفسيرها وتعليلها واكتشاف حقيقتها، ومن ثمّ نتمكّن من السيطرة عليها والتحكّم فيها.
ومن خصائص كلّ نظام أن يقوم على علاقات بين عناصر مختلفة متباينة متقابلة. وأن يستغلّ بعضهم هذه الاختلافات والتقابلات المؤسّسة للنظام لغايات تراتبيّة قوامها التحقير و التعظيم سلوك لا يمكن أن يمتّ إلى العلميّة بأيّ صلة. فالاختلاف يعدّ من السمات المميّزة للعناصر، المثبتة لقيمتها داخل ذلك النظام. ولا يكون للعنصر أيّ قيمة خارج البنية التي ينتمي إليها. فللعنصر قيمة علائقيّة تثبت أنّ الكلّ مجموع أجزاء وأنّ الجزء لبنة من اللبنات المكوّنة للكلّ. فلا مجال مع المنهج العلميّ للتهميش أو للإقصاء. إذ لكلّ عنصر دور يضطلع به فلا يمكن الاستغناء عنه.
وهي ثنائيات وتقابلات لا تحول مطلقا دون اعتبارها ممثّلة لاسترسالContinium تقوم عناصره على علاقات اتّصال وتسلسل. ومثل هذا التصوّر من شأنه أن يغيّر رؤيتنا لثنائيّة“الطبيعة” و“الثقافة”وما أقرّ فيها من تقابل. وقد بيّن سورل29 أنّه زوج تقوم علاقته على الاتّصال Continuité. فلا يمكن أن نسلّم بأنّ الثقافة مقابل مفارق للطبيعة، ولا سبيل إلى الإقرار بأنّ ما هو طبيعيّ فطري هو غير عقلانيّ. “فالإنسان عالم تلقائيّ، حدسيّ”30.
ولابدّ أن يطال هذا التغيّر في رؤية العلاقات بقيّة الثنائيات التي أدّت إلى عزل الثقافة الشعبيّة وتنزيلها المنزلة التي هي عليها. فلا يخفي ما تشهده الساحة العلميّة والمعرفيّة اليوم من انفتاح العلوم بعضها على بعض وتوسّل بعضها ببعض،باعتبارها جميعا علوما عرفانيّة. وهو ما يؤكّد التعالق والاسترسال بين العلوم على اختلافها. وليس ما تشهده اللسانيّات اليوم من تطوّر إلاّ نتاج هذا الانفتاح وهذا التلاقح والتعالق. فنراها تنهل من علم الأعصاب وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة نهلا تجلّى في ما يسمّى باللسانيّات العرفانيّة.
فلا يمكن لأيّ دراسة تخصّ الإنسان أن لا تكون في علاقة مباشرة بالذهن وأن لا يكون للذاكرة دور أساسيّ في تشكّل مادّتها. وليست الذاكرة إلاّ خزينة لتجارب اجتماعيّة قبل أن تكون فرديّة، تؤكّد أنّ الإنسان لا يمكن أن يكون إلاّ كائنا تاريخيّا. وليست الثقافة الشعبيّة إلاّ شكلا من أشكال تجسيد ذاكرة الشعوب على المستوى الفردي والاجتماعيّ، متولّدا من ثالوث القوى المتفاعلة في الذاكرة: “القوّة الحافظة” و“القوّة المائزة” و“القوّة الصّانعة”.ولم يكن هذا التصنيف الذي وضعه القرطاجنّيّ31 في القرن السابع إلاّ حدوسا عرفانيّة تأكّدت في هذا القرن بما بلغته هذه العلوم من دقّة في تحديد المفاهيم وصرامة في التنظير.
جميع هذه المعطيات تجعلنا نحمّل الثقافة العالمة، باسم العلميّة، مسؤوليّة المحافظة على الثقافة الشعبيّة، وتنزيلها المنزلة الضروريّة في سيرورة بناء كيان المجتمع وكيان الفرد “الإنسان”، وتصحيح وضع حان وقت تصحيحه، علّنا نحقّق التوازن المنشود. ونحن نعتقد أنّ هذا الهدف يبقى بعيد المنال إذا ما ظلّت العناية بالثقافة الشعبيّة مقتصرة على التظاهرات الاحتفاليّة والمهرجانات السنويّة واللقاءات الاستعراضيّة، وإذا ما كان أغلب من يهتمّ بها تعوزهم إمكانات المباشرة العلميّة .وهو ما جعلنا نعتبر المصالحة الثقافيّة ضرورة لابدّ منها حتّى تكون الأسّ الذي عليه نعتمد لتحقيق غايتنا.
الهوامش
1 - هي أزمة تقوم محاولات الانعاش والإحياء التي يضطلع بها مناصرو هذه الثقافة بين الفينة والأخرى بدعوتهم الملحّة إلى المحافظة عليها وحمايتها وتنزيلها المنزلة التي تستحقّ دليلا عليها.
2 - عبد الرحمان منيف:»بين الثقافة والسياسة «ص 5:الطبعة الثانية 2000 ،المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر والمركز الثقافي العربي
3 - انظر ديدييه جيل:»باشلار والثقافة العلميّة»ترجمة د. محمد عرب صاصيلا الطبعة الأولى،1996 المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع.بيروت، لبنان.
4 - نفسه ص 89 - 90
5 - ابن خلدون :»المقدّمة»دار الجيل،بيروت،ص 424
6 - نفسه ص 135
7 - حازم القرطاجنّي:»منهاج البلغاء وسراج الأدباء»،دار الغرب الإسلاميّ ،1986،الطبعة الثالثة ص 35
8 - انظر :
François Cavallier.1996 : Nature et Culture .p 16/Collection Philobac .ellipses/éd :marketing S.A
9 - ابن خلدون «المقدمة» ص 425
10 - نفسه ص135
11 - القرطاجنّي:«منهاج البلغاء»،ص 26
12 - نفسه :ص 35
13 - نفسه :ص 36
14 - نفسه :ص 36
15 - ابن خلدون:المقدمة ص192
16 - نفسه ص183
17 - ديوان «أغاني الحياة»الأعمال الكاملة 1984 الدار التونسية للنشر ص 272
18 - انظر «فيدال» :
Vidal1999 ص73 :La « Science de L’Homme » :désirs d’unité et juxtapositions encyclopédiquesمقال منشور في كتاب L’Histoire Des Sciences De L’Homme/1999 L’Harmattan .France
19 - ابن خلدون :المقدمة ص 424-425
20 - انظر «شاف»:
Schaff 1969 Langage et connaissance .éd. Anthropos :ص 83-84
21 - انظر:
L’Histoire des sciences de l’homme . éd.L’Harmattan /France .1999
22 - انظر «فيدال» Vidal1999 ص 64
23 - انظر:
Gusdorf George 1960 :Introduction aux sciences humaines.Essai critique sur leurs origines et leurs développement ;Paris ,Les Belles Lettres ;Pub.de la faculté des letters de l’Université de Strasbourg/p487.
24 - ابن خلدون :المقدمة:ص 190
25 - ابن خلدون المقدمة ص192
26 - نفسه ص190
27 - نفسه ص425
28 - القرطاجني :المنهاج ص 125
29 - انظر:
Searle .John: 1998:La construction de la réalité sociale.Paris.Gallimard. p :287
30 - J .P.Leyens&J.L.Beauvois :1997 :L’ère de la cognition .Presses Universitaires de Grenoble.P.8.
31 - القرطاجنّي ّالمنهاج ص42-43