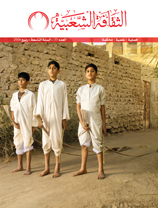تاريخ اللهجات العربية: قراءة في كتاب «تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرافعي
العدد 51 - فضاء النشر

اهتمّ الرافعي في الباب الأول من كتابه «تاريخ آداب العرب» بتاريخ اللغات عامة، وبتاريخ اللغة العربية خاصة. ومهّد لذلك بفصل تحدّث فيه عن الظاهرة اللغوية وتاريخ نشأتها. وقد ركّز في هذا الفصل على مسألة أساسية وهي قضية اللغة بين التوقيف والتواضع، فذكر أنّ من أشهر من أخذ بالتوقيف أفلاطون(Platon) وابنُ فارس والأشعريُّ، وأنّ من أشهر من قال بالتّواضع «ديودورس» (Diodôros)، و«شيشرون» (Cicéron)، وأبو علي الفارسي، وابن جنّي، وطائفة من المعتزلة1.
ويمكننا أن نقول من البداية إنّ الرافعي كان من أنصار التواضع والاصطلاح في اللغة. فهو يَعتبر أنّ من «أصول الاستدلال» على صحّة هذا المذهب دراسة لغة الحيوانات والأمم المتوحشّة، لأنها تشترك في الاقتراب من صورة الإنسان البدائي. وأمّا الاستدلال بمنطق الحيوان فينطلق فيه الرافعي من دراسة علاقة التخاطب بين الحيوانات ومروّضيها، فهي تُفهم عنهم بأنواع من الأصوات والحركات والإشارات التي تؤدّي أنواعا من الدلالات، وهم يفهمون عنها ويدركون رغباتها وحالاتها باختلاف أصواتها وهيآتها وحركاتها2.
ويستنتج الرافعي من ذلك أنّ أول لغة للتخاطب عند الإنسان البدائي كانت عن طريق الإشارة، سواء كانت هذه الإشارة صوتية أو عضوية، كما يصنع الخُرس. وما يزال جزء هام من هذه اللغة مستعملا في التعبير عن بعض المعاني الطبيعية في الإنسان، من ذلك ما يرتسم على الوجه من علامات تختلف باختلاف الحالات النفسية، كالعبوس والتقطيب وتقليب البصر عند الغضب، وكانبساط الأسارير واستقرار النظر في حالة الفرح، ونحو ذلك ممّا هو «لغة طبيعية في الخليقة الإنسانية»3.
ونخلص من هذا إلى أنّ الرافعي يرى أنّ هذا الضرب من اللغة كان قاسما مشتركا بين الحيوان والإنسان في طوره الحيواني.
وقد نشأت عن هذه المرحلة البدائية من لغة الإنسان مرحلةٌ أخرى هي مرحلة النطق. ويفسّر الرافعي هذا التطور بأمرين، هما: طبيعة حياة الإنسان، وطبيعة جهازه الصوتي . فلمّا كانت حياة الإنسان متطوّرة بتطوّر حاجاته وتجدّدها، احتاج إلى تطوير وسائل تعبيره. وساعده على ذلك ما في أوتاره الصوتية من مرونة، فابتدع مخارج صوتية جديدة. وبذلك ارتقى الإنسان عن الحيوان الذي بقيت حاجاته واحدة لا تتجاوز مطالب الغريزة، ومن ثمّ لم يحتجْ إلى تطوير وسائل تعبيره، إضافة إلى قصور جهازه الصوتي عن صنع مخارج صوتية جديدة4. وهكذا نرى أنّ الرافعي قد أوْلى دورَ الحاجة في تطوير لغة الإنسان وتفجير الطاقة النطقية التي يكتنزها جهازُه الصوتي الأهميةَ البالغةَ.
ولتأييد وجهة نظره هذه، اعتمد الرافعي دراسة اللغة عند القبائل المتوحّشة أيضا، وهي تلك التي مازال بعضها يعيش في أستراليا وفي أواسط إفريقيا الجنوبية. فهذه القبائل تستعمل أصواتا مبهمة، لا تدل في ذاتها على معنى إلاّ إذا كانت مصحوبة بالإشارة. ويستنتج الرافعي من ذلك أن الإنسان قد استعمل الصوت للدلالة بعد أن استعمل الإشارة5.
وإضافة إلى دراسة منطق الحيوان ولغات الأمم المتوحشة، اعتمد الرافعي في الاستدلال على صحة القول بالتواضع على دراسة طبيعة الاجتماع الإنساني نفسه. إن اللّغة في نظره هي «بنت الاجتماع»، لأن الاجتماع يقوم على الحاجة، وهذه الحاجة ملحّة متجدّدة، بحيث لا تستقيم حياة الإنسان بدونها. فمن ثمّ نشأت عن هذه الحاجة الحياتية حاجةٌ للتعبير عنها. ولمّا كان الاجتماع الإنساني قائما على التعدّد والاشتراك في المصالح، لجأ الإنسان إلى الاصطلاح اللغوي تيسيرا لحياته. فالتّواضع إذن «عمل اجتماعِ محضٌ، لا يتهيّأ لفرد فيما بينه وبين ذات نفسه». والألفاظ التي ينشئها الاصطلاح ليست ملكا للمتكلّم فحسب، بل هي ملك للمتلقي أيضا، لأنها إنّما أُنشئت لدلالة خاصة يعيّنها الاصطلاح بينهما. ومن هنا تصبح اللغة عَقدا عرفيا بين الباثّ والمتقبّل، وتصبح بذلك ضرورة من ضرورات الاجتماع6. ويخلص الرافعي من ذلك إلى هذه النتيجة: «إذا كان من أصول الحياة الاجتماع، فإنّ من أصول الاجتماع اللغة، وهذه من أوصولها المُواضعة»7.
ويذهب الرافعي إلى أنّ اختلاف اللغات لا يتعلّق بسرّ الوضع اللغوي في ذاته، بل هو ناتج عن اختلاف حالات الاجتماع من أمة إلى أخرى، باختلاف عاداتها وطرق عيشها. ولهذا كانت حقيقة معنى اللغة – عند الرافعي- أنها «مجموع العادات الخاصة بطائفة من طوائف الاجتماع»8.
وأمّا عن حقيقة التواضع وكيف كانت بدايته، وكيف تمّت نشأته، فإنّ الرافعي يُرجع ذلك إلى المحاكاة، فيرى أنّ الإنسان كان في اجتماعه الأول مضطرا إلى مغالبة الحيوان، وأنه عن هذه المغالبة تدبّر أصوات الحيوان، وما تؤديه من معاني الغضب والخوف والجوع والألم ونحوها، فنسج على منوالها9.
ويُمعن الرافعي في تأكيد هذه الفكرة، فيذهب إلى حدّ القول بأن الحيوانات المنقرضة التي كانت تعيش في عهد الإنسان الأول قد يكون في أصواتها مقاطع متنوعة ألّف الإنسانُ الأوّل منها أبجديّته وركّب منها أصول لغته10. ولا يخفى ما في هذا الرأي من تناقض مع الرأي الذي ذهب فيه إلى قصورِ الجهاز الصوتي عند الحيوان وعجزِه عن صنع مخارج صوتية متنوّعة11.
ويعتقد الرافعي أنّ المحاكاة غريزة في الإنسان، والدليل على ذلك أنّ لغة الأطفال تقوم عليها، فهُمْ يسمّون الحيوانات مثلا بما تصدره من أصوات يحاكونها، فيعبّرون عن الدّجاجة بـ«كاكا» وعن الشاّة بـ«ماما» وعن القطّ بـ «نَوْنَوْ» إلخ12...
ويذهب الرافعي إلى أنّ أوّل ما تواضع عليه الإنسان من اللغة عن طريق المحاكاة هي الألفاظ التي تعبّر عن الإحساس والوجدان، لأنها تشبه في مقاطعها الصوتية أصوات الحيوان، ولذلك كثرت فيها الحروف الهاوية وهي حروف اللين بأنواعها مثل الألف والواو والياء، وبعضُ الحروف الحلقية كالعين والغين والهاء والحاء، من ذلك مثلا «آه» و«أخ» وما شابههما من المقاطع الصوتية التي يعبّر بها الإنسان عن مشاعره، والتي ما يزال أكثرُها ميراثا في الجنس البشري كلّه على تباين اللغات واختلافها.
ويذهب الرافعي كذلك إلى أنّ الإنسان الأول حاول محاكاة الطبيعة أيضا، فتيسّرت له منها مخارجُ حروف أخرى غيرُ تلك التي تهيّأت له من أصوات الحيوانات، وهي قد تتجاوز المائة عددا13. وهو يعتقد من جهة أخرى أنّ محاكاة الطبيعة هي سبب نشوء المقاطع الثنائية في اللغة، فالمقاطع الثنائية تعبّر عن أمّهات المعاني الطبيعية كنزول المطر وانفلاق الحجر وانكسار الأشجار وما شابه ذلك. وهذه المعاني هي التي تجسّد حاجات الاجتماع الأساسية في حياة الإنسان الأوّل. وعن المقاطع الثنائية نشأت المقاطع الثلاثية بحسب تطوّر الحاجات الاجتماعية وتعقّدهاّ، وهذا هو الطّور الثاني من أطوار التواضع اللغوي14. وأمّا الطور الثالث الأخير فهو ما سمّاه الرافعي بـ «الطور الصناعي»، وهو الذي تتطوّر فيه طرق الاصطلاح وتتنوّع كالاشتقاق والنحت والقلب والإبدال. ويعكس هذا الطورُ أعلى مراتب الرقيّ الاجتماعي الذي بلغه الإنسان15.
ويحاول الرافعي أن يعقد صلة بين مراحل التواضع اللغوي الثلاث وما يماثلها من عصور التاريخ الإنساني، فيرى أنّ عصر الإنسان البدائي يماثله في اللغة صدور الأصوات الوجدانية مع الاستعانة بالإشارات. ويماثل العصرَ الحجرّي شروعُ الإنسان في نحت المقاطع الصوتية بمحاكاة أصوات الطبيعة والحيوانات. ويماثل العصرَ البرنزي الذي ظهرت فيه الصناعة اهتداءُ الإنسان إلى تأليف الألفاظ بإضافة بعض الأصوات إلى المقاطع الثنائية. ويضيف الرافعي العصر الحديديّ الذي ابتدأ معه التاريخُ الإنسانيّ، ويماثله تماسك اللغة وتمكّن الإنسان منها16.
ومهما يكن من طرافة هذه المقارنة بين مراحل التواضع اللغوي ومراحل التاريخ البشري، فإنها لا تخلو من تكلّف وتعسّف ينمّان عمّا أراد الرافعي أن يُضفيَه عليها من روح نظرية علمية صحيحة، لأننا نعتقد أن الظاهرة اللغوية أكبر من أن تخضع لهذا التقسيم الصارم، لما تتميّز به من طابع المرونة والتعقيد في آن واحد.
وبعد أن بسط الرافعي القول في الاحتجاج للمذهب القائل بالتواضع في اللغة انتهي إلى نقد القائلين بالتوقيف، وخاصة منهم ابن فارس، ويرميهم بالتناقض، لأن منهم من يقول بأن الإنسان أُلْهِمَ اللغةَ نفسها، وهؤلاء يعتقدون أصالةَ اللغة ويعتبرونها اعتبارا دينيا17. وإنّ منهم من يقول بأنّ الإنسان لم يُلهم اللغة وإنما أُلهم أصول المواضعة. وينتهي الرافعي إلى اعتبار أن القول بأنّ اللغة وحيٌ وتوقيفٌ إنما هو ضرب من «التقوى التاريخية» ، لأن الإنسان «خُلق مستعدا منفردا ليصير بعد ذلك عالما مجتمعا»18.
وهكذا نرى أنّ الرافعي قد رفض القول بالتوقيف في اللغة واعتبره موقفا محافظا، ودافع عن القول بالتواضع والاصطلاح، واحتجّ له خاصة بما انتهت إليه الدراسات اللغوية الغربية في عصره من نتائج قامت على أسس من البحث الميداني العلمي. لذلك نراه قد كثّف من الأمثلة المستقاة من بعض الدراسات التي تخصّصت في لغة الحيوان ولغات القبائل البدائية19. وحاول أن يُضفيَ على بعض آرائه الصبغة العلمية، رغبة منه في مواكبة الحداثة وإعطاء اللغة العربية نفسا جديدا حتى تتمكن بدورها من النهوض بتكاليف المعاصرة ومواكبة تقدّمها.
وفي ضوء هذه المعطيات كيف نظر الرافعي إلى تاريخ اللغات عموما، وإلى تاريخ اللغة العربية خصوصا؟
تاريخ اللغات:
لم يقتصر اهتمام الرافعي على التأريخ لنشأة اللغة، بل اهتمّ أيضا بتأريخ اللغات عموما، وبتأريخ اللغة العربية خصوصا. وقد خصّص لهاتين المسألتين تسعة فصول وهي: تفرّع اللغات، علوم اللغات، اللغة العامة، اللغات السامية، أصل العربية، مجانسة العربية لأخواتها، تهذيب العربية الأول، انتشار القبائل العربية والتهذيب الثاني، الدّور الثالث في تهذيب اللغة20.
والعجيب أنّ هذه الفصول لم تحْضَ بعناية الدارسين لكتاب «تاريخ آداب العرب» رغم أهمّيتها، وتتّضح أهمية هذه الفصول – رغم روح الاختصار فيها- في كونها من النصوص العربية الأولى في العصر الحديث التي أولت الدراسات اللسانيةَ عنايةً بالغة في التأريخ الأدبي، وفيها يتّضح اطلاع الرافعي المبكّر على الدراسات اللسانية الغربية، خاصة الألمانية منها، وطموحَه إلى توظيفها في التأريخ للآداب العربية.
وإذا قمنا بمقارنة بسيطة بين الرافعي وأحد معاصريه من مؤرّخي الأدب العربي في هذه النقطة تحديدا، تبيّن لنا ما كان للرافعي من فضل السّبق إلى الاستفادة من الدراسات اللسانية الغربية ومحاولةِ توظيفها في التأريخ الأدبي، بصرف النظر عن مقدار النجاح الذي حققه في هذا التوظيف. فجرجي زيدان مثلا لم يُولِ في كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» المباحث اللسانية الأهمية التي تستحقّ رغم حذقه الجيّد للّغات الفرنسية والانكليزية والألمانية21، فهو لم يُفرد اللغات مثلا إلاّ ببعض صفحات لا تفي بالحاجة22. ولخّص تاريخ اللغات السامية في بعض الجمل المقتضبة، فاكتفى بالقول: «واللغات السامية أخوات لا يُعْرَفُ لهنّ أُمٌّ. وظنّ بعضهم أنّ اللغة البابليّة أو الأشورية القديمة أمُّهُنّ.. والمُعَوَّلُ عليه أنّ هذه اللغات السامية أخوات انقرضت أمّهن قبل زمن التاريخ»23.
ونجد الرافعي في «تاريخ آداب العرب» يستشهد بكثير من الألسنيين الغربيين، ويحتجّ بهم لتأييد بعض آرائه، نذكر منهم «قريم» (Jacob Grimm) و«بوب» (Franz Bopp) و«شليير» (Johan Martin Schleyer) (؟) و«زامنهوف» (Lazarus Zamenhof) و«هاليفي» (Joseph Halevy) و«غلازر» (Edward Glaser) و«همبولدت» (Wilhelm Humboldt) ، وهو ألسني ألمانيّ اعتمد أبحاثَه الألسنيّ الأمريكي «شومسكي»(Noam Chomsky) في كتابه «مظاهر النظرية التركيبية»25. والعجيب بعد ذلك أن يَعتبر عبد السّلام الشاذلي أنّ استفادة الرافعي من الدراسات اللسانية الغربية كانت «محدودة للغاية»، بسبب قلّة إلمامه باللغات الأجنبية26.
ويذهب الرافعي إلى أنّ الأوروبيين هم أوّل الذين اهتمّوا بدراسة تاريخ اللغات وتحديد أصولها التي تفرّعت عنها. وهو يعتبر أنّ مذهب «داروين»(Darwin) في النشوء والارتقاء هو أصل هذا الاهتمام، لأنّ اللغويين الأوروبيين حاولوا أن يطبّقوه على تاريخ اللغات، وأن يستخلصوا منه منطق نشوئها وتطوّرها. فقد درسوا نظام التّحوّل والتطوّر في كل لغة، وقارنوا بين اللغات، محاولين أن يستخلصوا من الصور اللغوية المتشابهة الصورةَ الأمّ التي نشأت عنها، وكانت غايتهم من ذلك أن يردّوا اللغات البشرية إلى أصول معدودة27.
ويذكر الرافعي أنّ من أسباب ظهور الدراسات اللسانية في أوربّا اهتمام العلماء الأوربيين بدراسة مظاهر العقل الإنساني دراسة تطمح إلى أن تقوم على أصول وقواعد علمية صحيحة. فبحثوا في الديانات والعادات الاجتماعية، وقارنوا بعضها ببعض، بحثا عن مواضع التداخل بينها. فاضطرّهم ذلك إلى دراسة اللغات، ممّا كان سببا في نشوء علمين اثنين: أحدهما يسمّى «علم اللغات» (La Philologie)، والثاني يسمّى «علم الأساطير المقارن»(La Mythologie comparée). ولمّا تمّ للألسنيين دراسة اللغات الصينية ولغات الشعوب البدائية، وضع «همبولدت» علما عامّا سمّاه «دراسة اللغات» (Linguistique). ويلاحظ الرافعي أن الألمان هم أول من اشتغل بالعلوم اللسانية، وإن كان الفرنسيون أسبق منهم تفكيرا فيها29.
ويكاد الرافعي يجزم بخلوّ التراث اللغوي العربي من ذلك النوع من الدراسات اللسانية التي أحدثها الغربيون، فيشير باحتشام إلى محاولات بعض اللغويين العرب كالزمخشري(ت 538 هـ)، وأبي عليّ الفارسي (ت377 هـ)، وابن جِنّي (ت 393 هـ) الذي كان «أسبقهم إلى الغاية»، لأنه بحث في وضع اللغة وتطوّرها ومعاني اشتقاقها، وقابل بعض موادّها ببعض. ويعجب الرافعي من قلة الدراسات اللسانية العربية التي تهتم بتاريخ اللغة، رغم أن اللهجات العربية - بما اتسمت به من تعدّد وتنوّع - تمثل حقلا عمليا ثريا في مادته. ويعلّل ذلك بانعدام النظرة الزمنية التاريخية إلى اللغة عند القدامى، فقد أخذوا اللغة «على المعنى الديني الثابت الذي لا يتغيّر»، فأرجعوا أصل الفصاحة العربية إلى إسماعيل، ثم تجدّدت هذه الفصاحة بالقرآن والبلاغة النبوية. ويعتقد الرافعي أن علم الكلام قد ساهم في ترسيخ هذه النزعة التوفيقية للّغة عند القدامى، لما فيه من «المعنى الديني الثابت»، وأنّ القليل من هذه الدراسات اللسانية إنما جاء بعد تراجع الدراسات الكلامية30.
واهتمّ الرافعي في تاريخ اللغات بالبحث في أصولها، فاعتبر أنه لا يمكن القطع بأن للّغات كلِّها أصلا واحدا تفرّعت عنه إلا إذا أثبتنا أحد أمرين: إما أنّ النّوع الإنساني انحدر من جماعة واحدة، أو أنه انحدر من جماعات مختلفة، ولكنها تتفق جميعا في حالة واحدة من أحوال الاجتماع. ويرى الرافعي أن الاستدلال على هذين الأمرين لا يمكن أن يبلغ درجة «الظنّ العلمي» بَلْهَ أن يبلغ درجة اليقين. ومن هنا رفض الحكم بأصالة لغة دون أخرى، كالقول بأن لغة آدم كانت سريانية أو عبرانية، وانتهى إلى أنه لا يمكن أن نقف على أمهات اللغات التي ينتهي إليها التسلسل اللفظي، معتبرا أن الإنسان الأوّل أمرٌ من أمور الغيب31.
ويتعرّض الرافعي إلى الرأي القائل بإمكانية الاستدلال على التسلسل اللفظي بتشابه الأسماء الإنسانية الخالدة كاسمي الأم والأب، لأنهما يحملان مفهوما ثابتا يدل على حالة واحدة منذ بداية تاريخ النوع البشري إلى الآن. ثمّ إنّ لفظ الأمّ يحمل في جميع لغات العالم حرفا أصليا هو الميم، ولفظ الأب يحمل أيضا حرفا أصليا هو الباء. ويعتبر الرافعي أن هذا لا يمكن أن يقوم دليلا على توحّد اللغات البشرية، فهو لا يعدو أن يكون رأيا مما يُستأنس به لا غير32.
ويذهب الرافعي إلى أن ما اتّفق عليه العلماء من أمهات اللغات لا يتجاوز تاريخُه ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف سنة. وهذه الأمهات هي: الآرية والسامية والطورانية. وقد تفرّعت عن هذه الأصول لغاتٌ أخرى تدّل المشابهةُ بينها على وَحدة أصلها التاريخي33.
إنّ التفكيرَ في تعدّد اللغات ودراسةَ أوجه اختلافها أو تشابهها والبحثَ عن أصل واحد لها، يؤدّي – في نظر الرافعي- إلى التفكير في إمكان اجتماع الناس على لغة عامة وتوحيدهم عليها، ويتأكد هذا بأمرين: أحدهما أن «هذا هو الأصل في حكمة النطق»، أي إنّ المقصد الأساسي من وضع اللغة هو توحيد الناس في الاصطلاح على الأشياء، لتحقيق التفاهم من أقرب السبل وأيسرها، وهذا عين ما تَنشُده اللغةُ العامة. وثانيهما أنّ العصور الحديثة قد شهدت اختصارا للمسافات ساهم في توثيق العلاقات بين الأمم، وفي تلاقح الحضارات وامتزاج المجتمعات بعضها ببعض. ومن هنا فإنّ الإنسان في حاجة إلى اختصار المسافات بين الألسن، فلا يكون بين لسانين اثنين لسان ثالث يترجم، وبما أنّ الحاجة هي أمّ الاختراع فقد تولّدت عن تلك الحاجة ما يُعرف بـ «اللغة العامة»34.
وقد ذكر الرافعي أنّ أوّل من حاول ذلك من العرب هو محيي الدين بن عربي (ت 638 هـ)، فقد وضع لغة خاصة بالتصوف جمع ألفاظها من العربية والفارسية والعبرية، وأطلق عليها اسم «بليبلان»، وهذا الاسم نفسه من أوضاع هذه اللغة، ومعناه « لغة المُحيي». وقد قام القائد المغولي «تيمورلنك» بمحاولة شبيهة بهذه حين رأى أنّ جيشه يتكوّن من طوائف مختلفة الأجناس والألسن، فخشي أن يكون ذلك سبب تفرقة، فجمعهم على لغة واحدة اقتبسها من لهجاتهم جميعا. وتُعرف هذه اللغة باسم «أوردو» ومعناها الجيش35.
كما حاول الفيلسوف الإنكليزي «باكون»(Bacon) في القرن السادس عشر وضع لغة عامة. ثمّ تتابعت المحاولات بعده، حتى انتهت إلى وضع لغة تعرف بـ «الإسبرانتو» (Esperanto). ويعتبر «بشر»(؟) أوّل من وضع كتابات في لغة عامة، فقام باستقراء المعاني، ووضع لكل منها ما يقابله من اللفظ، وضبط قواعد الصيغ الصرفية والتركيبية، وقد تابعه في ذلك كثيرون بعده.
وألّف اللغوي الألماني «شليير» (Schleyer) سنة 1879 كتابا وضع فيه لغة سماها «الفولابوك» (Volapuk) أي «اللغة الجامعة»36 وأمضى في إنشائها عشرين سنة، لكنها لم تحْظَ بالرواج والانتشار. ثمّ وضع «زامنهوف» (Zamenhof) اللغة المعروفة بـ دكتورو إسبرانتو» (Doktoro Esperanto) أي «الأستاذ المؤمّل»37، مشيرا بذلك إلى إخفاق اللغويين قبله في تحيقيق هذه الغاية. وتتكون «الإسبرانتو» من مائتين وثلاثة آلاف مادة لغوية مقتبسة من جميع لغات أروبا. وقد أضاف إليها واضعُها ثلاثين لفظة تُركَّب مع سائر ألفاظها للدلالة على المعاني الوصفية، وسبعَ عشرة زيادة صيغيّة للدلالة على المعاني التصريفية، وبذلك انتهى بها إلى ثروة معجمية عظيمة تقدّر بعشرة ملايين كلمة38.
تاريخ اللغة العربية:
تُعتبر اللغة العربية من اللغات السامية التي لم يبق منها إلاّ ثلاث، وهي: العربية والعبرية والسريانية. والمرجّح أنّ اللغات السامية قد تفرّعت عن أصل واحد وهو اللغة البابلية القديمة التي ما يزال رسم كتابتها منقوشا على آثار دولة حمورابي. وتعتبر العربية أكثر اللغات السامية مشابهة للغة البابلية لاشتراكهما في حركات الإعراب التي تخلو منها سائر اللغات السامية39.
وممّا يدّل على أنّ اللغة البابلية هي أمّ اللغات السامية، بما فيها العربية، هو احتواؤها على اثنتي عشرة صيغة فعلية يوجد أكثرها في العربية والعبرية والسريانية. ويوجد تشابه كبير بين اللغات السامية في «الألفاظ الخالدة» التي لا تتغيّر بتغيّر أوضاع الاجتماع، مثل الألفاظ التي تعيّن بعض عناصر الطبيعة أو بعض أعضاء الإنسان، فإن الاختلاف بينها لا يكاد يظهر إلاّ في بعض الأوزان والمقاطع القليلة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الضمائر المستعملة فيها، فهي تكاد تكون واحدة40. ورغم تأكيد الرافعي نسبةَ العربية إلى البابلية، فإنّه ينكر أصلها الوحيد، فيضيف إليها اللغة الحبشية واللغة الحِمْيريّة. ويعلّل ذلك بطبيعة التاريخ الحضاري للعرب الذي قام على التّرحال لا على الاستقرار41.
وعلى هذا الأساس يسفّه الرافعي الرأي القائل بأصالة اللغات السامية، ويرمي أصحابها بالمغالاة، لأنّ كلّ فريق منهم يزعم أنّ لغته هي لغة آدم التي تلقّاها في الجنّة ثمّ نزل بها على الأرض42. ولا يستثني الرافعي اللغويين العرب من هذه المغالاة حتى في نسبتهم اللغة العربية إلى إسماعيل، فهو يعتبر أنّ هذا الرأي لا يقبله المنطق العقلي، وإنما سوّغه عند اللغويين القدامى «ما يريدونه من إعطاء هذه اللغة صفةً إلهية لمنزلة القرآن منها، وما كان إليها فهو كذلك إلى الأبد، غير أن التاريخ لا دين له في نسقه الزمني، وإنّما التّحوّل والتنوّع من سنن الله»43.
ويشككّ الرافعي في صحّة الحديث النبوي الذي يذكر أنّ إسماعيل هو أوّل من نطق باللسان العربي. وهو يؤوّله على افتراض صحّته، فيبيّن أن المراد منه أن إسماعيل هو أول من أضاف لغة جُرْهم إلى لغة قومه، فمن ثَمّ نُسبت إليه «نسبةً تاريخية» لأنه يمثل أوّل تاريخ العرب، فكأنّ كلّ ما كان قبله منقطع عن التاريخ. ويذهب الرافعي إلى أبعد من ذلك، فينفي نسبة اللسان العربي إلى يعرب بن قحطان، مبيّنا أن القائلين بهذا الرأي إنّما كان استدلالهم استدلالا لغويا للمجانسة اللفظية بين «العرب ويعرب»، وهذا في نظره لا يمكن أن يقوم دليلا وحده على صحة هذا الرأي44.
ويذهب الرافعي إلى أنّ اللغة العربية مرّت بعدة أدوار تهذيبية قبل أن تستقرّ على صورتها التي نزل بها القرآن الكريم. وقد كان أوّل هذه الأدوار على عهد إسماعيل حين أضاف لغة جُرهم إلى لغة قومه كما تقدّم. ثم كان الدور الثاني حين تفرّقت القبائل وتنوعت اللهجات، فتعددت طرق الوضع في اللغة، واتسع الاستعمال. وأمّا الدور الثالث والأخير فهو من عمل قريش وحدها. وسمّى الرافعي هذا الدور بـ«الدور العكاظي»، لأنّ العرب كانوا يحتكمون في سوق عكاظ إلى قريش، وكانت قريش تبالغ في انتقاد لهجاتهم وانتقاء الفصيح منها. وقد ضاعف نزولُ القرآن في قريش دورَها التهذيبي، فقد نزل بلغتها، وبـــه تّمت الوَحدة اللغوية عند العرب45.
ويضيف الرافعي إلى هذه الأدوار العامة أسبابا أخرى ساهمت في تهذيب العربية وتفوّقها على أخواتها من اللغات السامية، منها أنّ العربية لم تدوَّن، وهذا ما جعلها أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتهذيب، في حين أنّ العبرية مثلا كانت مدّونة منذ أقدم عصورها، وهذا ما جعلها مقيّدة فظلّت ثابتة كما هي46.
ويعلّل الرافعي تفوّق العربية أيضا بخصوصية الصفات الوراثية عند العرب وتميّزها عن الصّفات الوراثية للأجناس الأخرى47. ولكنه يتراجع عن هذه الفكرة في سياق آخر، فيقول: «وقد كان سَبَق إلى ظنّنا أنّ هذه الجارحة اللسانية في العرب قد تكون ممتازة في أصل تركيب الخلقة كما امتازت أدمغتهم عن أدمغة السلائل الأخرى. وكنّا نعلّل بذلك ما في منطقهم من الفخامة، وما في حروفهم من لطيف الحسّ، وسَريّ المخرج، وعجيب التركيب والترتيب. بيد أنّنا لمّا تتبّعنا لغات القبائل، واستقرينا لهجاتها الباقية في كتب العربية، رأينا أنهم ليسوا سواء في هذه الميزة، فإنّ لبعضهم لهجاتٍ رديئةً وطُرقاً شاذةً في سياسة المنطق. فرجح عندنا أنّ ذلك من عمل التنقيح، وأنه صنعة وراثية في الألسنة، جرت بها اللغة مجرى الكمال، وهي في بعض القبائل أظهر منها في البعض الآخر»48.
وهكذا نرى أنّ الرافعي لم ينظر إلى تاريخ اللغة العربية نظرة قوامها التقديس والتمجيد، رغم ما عُرف عنه من دفاع عنها وتعصّب لها في معركة الشعر الجاهلي خاصة، بل نظر إليها نظرة موضوعية أساسها الاستقراء. فحاول أن يبيّن أنّ جمال العربية لا يرجع إلى كونها لغةً توقيفية أُوحيت إلى آدم أو إلى إسماعيل ، بل يرجع إلى أسباب تاريخية موضوعية ساهمت في صقلها وتهذيبها. ولا شكّ أن هذه النظرة كانت نتيجة طبيعية لتصوّر الرافعي العام لنشأة اللغة ولتاريخ اللغات عموما، وهو تصوّر يقوم أساسا على اعتبار أنّ اللغة تواضع تُمليه طبيعة الاجتماع كما بيّنا آنفا49. ومن هذا المنطلق أيضا كان الرافعي ينظر إلى تاريخ اللهجات العربية وما داخلها من اللحن. وهو ما سنحاول أن نتناوله في العنصر الموالي.
تاريخ اللهجات العربية:
يَعتبر الرافعي أنّ تاريخ اللهجات العربية من القضايا التي أُهملت إهمالا كاملا في التراث اللغوي العربي. وقد ذكر أنه لم يعثر على كتاب واحد اعتنى بـ«تدوين اللهجات على أنّها أصل من أصول الدلالة التاريخية في اللغة»50. وكلّ ما عَثر عليه هو ما أُلّف في بعض وجوه الاختلاف بين اللهجات العربية ممّا يستدلّ به المتناظرون اللغويون من البصريين والكوفيين. ونتيجةً لهذا الإهمال ضاع كثير من مسائل الاشتقاق في اللغة العربية، وضاع كثير من أنسابها، إلاّ ما دلّت عليه «مشابهات الخِلقة اللفظية»51.
ويذكر الرافعي جملة من الأسباب يعلّل بها إهمال اللغويين القدامى لتاريخ اللهجات العربية، من أهمّها اعتقادهم «أصالة العربية» واعتبارهم إيّاها لغة توقيفية بالوحي، ومن ثمّ فإنهم لم يعتبروها اعتبارا تاريخيا. ويرجع ذلك إلى أمرين: أوّلهما أنّهم عاصروا اللغة العربية وعاصروا أهلها، فلم يحتاجوا إلى نقل تاريخها إلى من بعدهم52، وثانيهما أنّهم أرادوا بجمع اللغة وتدوينها تفسير القرآن الذي نزل باللهجة القرشية، واللهجة القرشيةُ قليلة الاختلاف لأنّها حضرية، وميزة التحضّر الثبوت، فكأنها صارت في حكم المدوّنة.
من أجل ذلك لم تحظ اللهجات العربية بالتأريخ، وكانت سببا في صرف النظر عن التأريخ لسائر اللهجات الأخرى، فلم يكن الاهتمام بهذه اللهجات من أجل التأريخ، بل من أجل الاستدلال بها على فضل اللهجة القرشية53. ويرى الرافعي أنّه لولا خلطُ القدامى الأبحاث اللغوية بالقداسة الدينية وتعريفُ اللهجات بـ«الوصف الديني الثابت» لعاملوها معاملة غيرها من آثار التاريخ 54.
ولتأريخ اللهجات العربية وجمع اختلافاتها وتمييز أنواعها أهمية بالغة عند الرافعي في التأريخ للأدب العربي، إذ لو تحقّق ذلك لأمكن أن يخرج منه «علم صحيح» يُرْجَعُ إليه في التأريخ للّغة ومراحل نشوئها الاجتماعي، ولأمكن أن يُعتمد أصلا من أصول البحث في تأريخ الأدب العربي يُنسج على منواله في دراسة الشعر وغيره من الأجناس الأدبية55. ولكنّ الرافعي يعتبر هذا العمل محاولة قاصرة، لأنها جاءت متأخرة، فهي تشبه عملية بحث عن هيكل عظمي قديم، أقصى ما يمكن أن تبلغ منه هو جمع بعض بقاياه وترتيبها ووصفها56.
ويصرّ الرافعي على استعمال مصطلح «لغات» بمعنى لهجات، ويذكر أنّه هو المصطلح المتواتر في كتب اللغويين القدامى. وهو يعرّف اللغات بأنها الشّواذ والنوادر واختلاف معاني الكلمة الواحدة باختلاف المتكلّمين بها، وما يطرأ على الأبنية من الاختلاف الصرفي والنحوي57. غير أنّنا نجد الرافعي قد يخلط بين مصطلح «لغات» ومصطلح «لهجات» في غير موضع من كتابه، فيستعمل الأول حينا58. ويستعمل الثانيَ أحيانا أخرى59. بل إنّه خلط بين المصطلحيْن في تعريف آخر غيرِ الذي تقدّم، فقال: «وقد نبّهْنا فيما سبق إلى أنّ العلماء يريدون بلغات العرب ما كان باقيا لعهدهم في ألسنة من أخذوا عنهم من القبائل، ولهم أقوام يمكن حصرهم والإحاطة بلهجاتهم»60.
ويحدّد الرافعي اختلاف اللهجات في أنواع ثلاثة هي:
1. ما يكون من اختلاف بين اللهجات في إبدال الحروف وحركات الإعراب والبناء، وفي بنية الكلمة، وفي الزيادة والحذف والتقديم والتأخير وغير ذلك ممّا يتعلّق بصيغة الكلمة وكيفية النطق بها61.
2. ما يكون من اختلاف دلالة اللفظة الواحدة باختلاف كيفية النطق بها من لهجة إلى أخرى، ومن هذا النوع المترادفُ والأضدادُ ونحوها62.
3. ما يكون قد شذّ في نطقه أحدُ العرب رغم الاجتماع على النطق بخلافه، وهو قليل63.
ويعلّل الرافعي اختلاف اللهجات عند العرب بقيام لغتهم على المشافهة وعدم تقييدها بالكتابة لأنهم قوم أمّيون . فلّما كانت لغتهم متعلّقة بألسنتهم، يصرّفها الطبع، وتوجّهها السليقة حسب قانون المجهود الأدنى في النطق، تنوعت لهجاتهم واختلفت64. وقد ساعد على ذلك اختلافُ المناخ الطبيعي بين القبائل العربية وتفاوت الخصائص الوراثية بينها، فكلّما ابتعدنا عن وسط الجزيرة العربية إلى أطرافها كالعراق والشام واليمن، ضعفت الخصائص الوراثية، وضعفت الفصاحة وشابها الابتذال والتنّاقر. فحقيقة الفصاحة عند الرافعي إذن أنّها عمل مشترك بين الطبيعة والوراثة ، وعلى قدر ما يقع من الاختلال في أحدهما يقع مثلُه في الفصاحة65.
ويبدو أنّ الرافعي قد تأثّر في هذا بنظرية النشوء والارتقاء، فهو يرى أنّ لهجات العرب قد جرت من بداية تاريخها على «اندماج النوع الأدنى منها في النوع الأرقى»66، وأننا يمكن أن نضبط مراحل التاريخ اللغوي وأن نتابع سير تطوّره من طبقة إلى أخرى، انطلاقا من دراسة اختلافات اللهجات العربية.
والظاهر أنّ الرافعي قد تأثّر في أخذه بنظرية النشوء والارتقاء ببعض المفكرين الشوام الذين هاجروا إلى مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونخصّ بالذكر منهم يعقوب صروف في دراساته اللغوية، فقد نوّه الرافعي بطريقته في تأريخ اللغة العربية فقال: «وكانت للدكتور طريقة جريئة في ردّ الألفاظ العربية إلى أصولها والرجوع بها إلى أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريفها من لغة إلى لغة. وأعانه على ذلك ثقوب فكره، وسعة علمه، ودقّة تمييزه، وميله الغالب عليه في تحقيق ناموس النشوء وتبيّنِ آثاره في هذه المخلوقات المعنوية المسمّاة بالألفاظ»67.
ويعقد الرافعي في نهاية حديثه عن تاريخ اللهجات العربية وأهمّ القضايا التي تدور حوله فصلا بعنوان «أمثلة اختلاف اللغات»68، يستدرك فيه ما فات اللغويين القدامى من تاريخ اللغة العربية وتاريخ لهجاتها. ويحتوي هذا الفصل على إحدى وعشرين صفحة، أشار فيها الرافعي إلى كثير من وجوه الاختلاف بين اللهجات.
والحقّ أنّ هذا الفصل على طرافته وجدّته وما بَذل فيه صاحبه من جهد من أجل إحياء «علم مات في رؤوس علمائنا» –على حدّ تعبيره-69 يبقى غير مفيد – من وجهة نظرنا- في تأريخ الأدب العربي خلافا لما أكّده غير مرّة، فنحن لم نتمكّن من تبيّن علاقة ما مباشرة بين هذا المبحث وبين التاريخ الأدبي.
والذي نراه أنّ هذا الفصل يمكن أن يفيد المختصين في دراسة المعجم التاريخي، لما فيه من دقائق وتفاصيل لغوية معجمية يبدو أنّ الرافعي قد بذل جهدا كبيرا في استخراجها من أمّهات كتب العربية ثمّ في ترتيبها وتنسيقها. غير أنّنا لا يمكن أن نستوفيَ تاريخ اللهجات حظه من الدرس ونصيبه من التعمق، حسب ، ما لم نعقد الصلة بين تاريخ العربية وتاريخ الحضارة، وما كان لأحدهما على الآخر من التأثير. وهو ما سنحاول أن نتلمّسه في هذا العنصر الأخير من المقال.
تاريخ الوضع اللغوي في العربية:
يعقد الرافعي علاقة جدلية متينة بين اللغة والحضارة، فيرى أنّ اللغة يجب أن تواكب بأوضاعها ما يستجدّ من مستحدثات الحضارة، حتى يصحّ أن تُنعت بأنّها لغة حيّة. وأمّا إذا غلب نسقُ التطوّر الحضاري في أمّة ما نسقَ الوضع اللغوي فيها احتاج أهلُها إلى أن يأخذوا من مواضعات لغات أخرى، سدّا للحاجة، فما يزال التّواضع في لغة تلك الأمة إلى تراجعٍ ونقصان حتى تصير إلى الاضمحلال70.
ويرى الرافعي أن العربية أقلّ اللغات أوضاعا، لأن المستعمل منها لا يتجاوز ستة آلاف تركيب وثمانين ألف مادة، إلاّ أنّها أكثر اللغات مرونة في الاشتقاق وقدرة عليه، حتى إنها تستطيع أن تستغرق بذلك اللغاتِ بجُملتها71.
وتحتوي العربية على ثلاث طرق في الوضع، وهي الارتجال والاشتقاق والمجاز. وكلّ طريق من هذه الطرق متولّدة عن الأخرى باعتبار «المناسبة» بين الدّال والمدلول، «فكأنّهم في الوضع الأوّل راعَوا المناسبة الثابتة التي لا زيادة فيها، ثمّ توسّعوا في هذه المناسبة بنوع من التصرف في الوضع الثاني وهو الاشتقاق، ثمّ بلغوا آخر حدودها في المجاز، وهذا ممّا يؤكّد أن اللغة حكاية للطبيعة»72.
و المناسبة بين الدّال ومدلوله في الارتجال مناسبة طبيعية، كأنّها تحمل الواضع على الوضع حملا، حتى إننا يمكن أن ندرك هذه المناسبة في لغة نجهلها. ويضرب الرافعي على ذلك مثلا من التراث مفاده أنّ رجلا سُئل عن معنى «إذغاغ» في الفارسية، فأجاب بأنّه الحجر لأنّه وجد في الكلمة يُبسا شديدا73.
ويطبق الرافعي مذهب النشوء والارتقاء على الاشتقاق، فيرى أنّ لكلّ مقطع من المقاطع الثنائية أصلا في الدّلالة، ثمّ تتفرّع عنه معانيه الجزئيةُ عن طريق الاشتقاق، فتصبح الحقائق عبارة عن سلائل كلّ طائفة منها ضمن جنس معيّن74. ويرى الرافعي أنّ المعنى الأصليّ المشترك بين المقاطع الثنائية هو مفهوم القطع، لأنها كانت تمثّل «الألفاظ الطبيعية الأولى» التي كان يعبّر بها الإنسان الأوّل عن حاجاته الأساسية كالقطع والكسر والخرق والهدم. ويعتبر الرافعي أنّ هذه المعانيَ وما شاكلها هي «المعاني الوحشية» في لغة الإنسان البدائي. ولذلك قلّما تجد في العربية مادّة لغوية خالية من هذا المفهوم أي مفهوم القطع، ولو تأويلا من طريق المجاز75.
وأمّا المجاز فيعرّفه الرافعي بقوله: «والمراد من المجاز ه»76. وهو يعتبر الوضع بالمجاز امتدادا للوضع بالاشتقاق، فما لم يتيسّر وضعه عن طريق الاشتقاق يدرك بالتوسع في الحقيقة، لأنّ الألفاظ الحقيقية تمضي لسَنَنِها المعروف فلا يبقى ثَمّ وجه لتقوية الحقيقة المرادة منها بالاتساع أو التوكيد أو التشقيق وُضع عن طريق المجاز بتشقيق المعنى لا بتشقيق اللفظ، فكأنّ المجاز بهذا الاعتبار ضرب من «الاشتقاق المعنوي»77.
وكما أنّ للّغة طرقا في الوضع فإنّ لها وسائلَ نموٍّ عقد لها الرافعي فصلا بعنوان: «أنواع النموّ في اللغة»78، وهي:
1. الإبدال: «هو إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، كما يقولون: مدح ومده، واستعدى عليه واستأدى»79.
2. القلب: «هو تقديم وتأخير في بعض حروف اللفظة الواحدة فتُنطق على صورتين بمعنى واحد كقولهم: جذب وجبذ»80.
3. النّحت: «هو جنس من الاختصار، فينحتون من الكلمتين كلمة واحدة كعَبْشميّ وعَبْقسيّ»81.
4. المترادف: «هو ترادف لفظتين فأكثر على معنى واحد، كما تقول السيّف والعضب والأسد والليث»82.
5. المشترك: «هو عكس المترادف لأنّه مجيء اللّفظ الواحد لمعنيين فأكثر كالأرض لهذا البسيط ولأسفل قوائم الدّابة وللنفضة والرّعدة والزّكام»83.
6. التضادّ: «هو نوع من الاشتراك، وهو من أعجب ما في أمر هذه اللغة لأنّه إيقاع اللفظ الواحد على معنييْن متناقضيْن»84. وينفي الرافعي أن يكون التضادّ من أصول الوضع في العربية إذ لا تمسّ الحاجة الطبيعيّة إليه. والدّليل على ذلك قلّة الألفاظ التي تجسّد معنى التضادّ الطبيعي مثل السّدفة للضوء والظّلام، والصريم للّيل والنّهار. ويرجّح الرافعي أنّ بداية ظهور التضادّ في العربية كان في زمن النهضة الأدبية الجاهلية التي سبقت الإسلام، فانصرفت القبائل إلى التفنّن في الكلام والتوسّع في أساليبه في مناسبات معيّنة، حتّى أصبح من تقاليدها اللغوية. ثمّ كثرت الأضداد خاصة في العصر الإسلامي على أنّها لون من ألوان البديع أو الصّناعات اللفظية85.
7. الدّخيل: «هو ألفاظ داخلت لغات العرب من كلام الأمم التي خالطتها، فتفوّهت بها العرب على مناهجها لتدلّ في العبارة بها على ما ليس من مألوفها»86. وقد نفذ الدّخيل إلى العربية بواسطة الشّعراء والتّجار والرّحالة، وهو على نوعين: دخيل ديني، وأكثره من الهيروغليفية والحبشية والعبرية، كألفاظ المنبر والحجّ والكاهن؛ ودخيل حضاري كالمصطلحات الطبيّة وأكثرها هنديّ، وكأسماء الأثاث وأدوات الزينة وأكثرها فارسي. ويُعتبر الدّخيل الفارسي من أكثر الدّخيل ورودا في العربية، وينفي الرافعي أن يكون ذلك بسبب شيوع الفارسية في أيّام العباّسيين، بل لأنّ كثيرا من علماء اللغة كانوا من الموالي الفرس، فكانوا يتمحّلون لذك، رغبةً منهم في تكثيف المعرّبات الفارسية في اللغة العربية تعصبّا لحضارتهم87.
8. المولّد: «يُسمّى المحدث أيضا، ويراد به في الاصطلاح اللّغوي ما أحدثه المولّدون الذين لا يُحتجّ بألفاظهم، وهم الطبقة التي وَلِيَتْ العربَ في القيام على لغتهم من المتحضرين»88. وقد مرّ الدخيل في العربية بمراحل ثلاث: كانت أولاها في عصر الفتوحات الإسلامية، فتفشّت كثير من الألفاظ الدخيلة في كلام المتحضرين من العرب. إلاّ أنّ هذا النوع الأوّل من الدّخيل قد أهمله الرّواة، فلم يدخل في الرصيد اللغوي العربي. واستمرّت هذه المرحلة إلى آخر العصر الأموي الذي يمثّل بقية العهد العربي. ثمّ بدأت مرحلة ثانية من العصر العباسي شهدت سيطرة العنصر الفارسي. وتدعمّت هذه المرحلة بازدهار حركة الترجمة ممثّلةً في «بيت الحكمة» التي تمّ فيها ترجمة المصطلحات الفلسفية والطبية والفلكية والهندسية وغيرها. وقد نحا المترجمون في ذلك منحى العرب في التّصرف في الأسماء بالتّغيير أو الإبدال أو الحذف89. وفي مرحلة ثالثة ضعفت حركة الترجمة، وأصبح التعريب لا يتولاّه أهله من الكتّاب والمؤلّفين، بل أصبح يتولاّه أصحاب الصّنائع والحرفيون، وبذلك صار الدّخيل «لغة في التاريخ» بعد أن كان «تاريخا في اللغة»90.
ويذكر الرافعي نوعا آخر من المولّد وضعه العرب أنفسهم في صدر الإسلام، وهو ما يُعرف بالألفاظ الإسلامية مثل المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. ويشرح الرافعي علاقة مدلولات هذه الألفاظ في الإسلام بما كان لها من دلالات في الجاهلية فيقول: «إنّ العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثمّ زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سُمّي المؤمن بالإطلاق مؤمنا. وكذلك الإسلام والمسلم، إنّما عُرفت من إسلام الشيء، ثمّ جاء الشّرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تَعرف من الكفر إلاّ الغطاءَ والسّتر. فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء اليربوع»91. وعن هذا النوع من المولّد نشأت المصطلحات العلمية في الفقه والنحو العروض والكلام والتصوّف وغيرها من العلوم92.
الهوامش:
1. مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، بيروت 1974، ج1 ص 57.
2. م.ن: ج1 ص 58.
3. م.ن: ص.ن.
4. م.ن: ج1 ص 59.
5. م.ن: ج1 ص 58.
6. م.ن: ص.ن.
7. م.ن:ج1 ص 65.
8. م.ن: ص.ن.
9. م.ن: ج1 ص ص 59-60.
10. م.ن: ج1 ص 62.
11. م.ن: ج1 ص 59.
12. م.ن: ج1 ص 60.
13. م.ن: ص.ن.
14. م.ن: ج1 ص 63.
15. م.ن: ج1 ص 64.
16. م.ن: ج1 ص ص 61-62.
17. م.ن:ج1 ص ص 59-236.
18. م.ن: ج1 ص 59
19. م.ن: ج1 ص 60.
20. م.ن: ج1 ص ص 61-93.
21. من النزاهة العلمية أن نشير إلى أن زيدان قد اهتمّ ببعض هذه القضايا في كتابه "الفلسفة اللغوية": (طبعة دار الحداثة – القاهرة 1987)، إلا أنه لم يوظّفها في تأريخه للأدب العربي، وهذا هو المهمّ عندنا في هذه المسألة.
22. الرافعي: المرجع السابق، ج1 ص ص 42-50.
23. م.ن: ج1 ص 42.
24. م.ن: ج1 ص ص 68-72-81.
25. حسين الواد: في تأريخ الأدب مفاهيم ومناهج، طبعة دار المعرفة للنشر، تونس 1980، ص 25.
26. انظر كتابه: الأسس النظرية في مناهج البحث الأدبي العربي الحديث، دار الحداثة، الطبعة الأولى، بيروت 1989، ص 205.
27. الرافعي: المرجع السابق، ج1 ص 68.
28. يبدو أن هذا التسمية غير دقيقة، فقد جاء في المعجم الفرنسي "روبير" (Le Robert) ما هذه ترجمته " هي دراسة تاريخية للُغةٍ ما عن طريق التحليل النقدي للنصوص ". انظر مادة " Philologie" في المعجم المذكور.
29. الرافعي: المرجع السابق، ج1 ص 68.
30. م.ن: ج1 ص 69.
31. م.ن: ج1 ص ص 65-66.
32. م.ن: ص.ن.
33. م.ن: ص ص 66-67.
34. م.ن: ج1 ص 71.
35. م.ن: ج1 ص 72.
36. تُعرف في الانكليزية باسم " World’s Speech"، راجع : M.J Clark : English Studies Series 2, p 119
37. Ibid : pp 120-121
38. الرافعي: المرجع السابق، ج1 ص ص 72-73.
39. م.ن: ج1 ص ص 75-76.
40. م.ن: ج1 ص ص 81-82.
41. م.ن: ج1 ص 80.
42. م.ن: ج1 ص ص 74-79.
43. م.ن: ج1 ص 89.
44. م.ن: ج1 ص ص 89-90.
45. م.ن: ج1 ص ص 89-90، 93-97.
46. م.ن: ج1 ص ص 83-91.
47. م.ن: ج1 ص ص 44-91.
48. م.ن: ج1 ص 98.
49. الغريب أن الرافعي قد ناقض هذا التصوّرَ في سياق آخر فقال: "وهذه اللغة يوشك أن يكون أمرها معجزا على ما رأيت بحيث لا يغلو في رأينا من يقول إنها بسبيل من الأوضاع الإلهية في التوفيق والإلهام لأن أثر ذلك قد ظهر في القرآن": تاريخ آداب العرب ج1 ص ص 178 - 179.
50. م.ن: ج1 ص 138.
51. م.ن: ج1 ص ص 129-177.
52. م.ن: ج1 ص ص 137-138.
53. م.ن: ج1 ص ص 129-137.
54. م.ن: ج1 ص 138.
55. م.ن: ج1 ص 137.
56. م.ن: ج1 ص 140.
57. م.ن: ج1 ص ص 138-139.
58. م.ن: ج1 ص ص 97-128.
59. م.ن: ج1 ص ص 92-93-97-129.
60. م.ن: ج1 ص 135.
61. م.ن: ج1 ص 134.
62. م.ن: ج1 ص 134.
63. م.ن: ج1 ص 135.
64. م.ن: ج1 ص 128.
65. م.ن: ج1 ص ص 98-131.
66. م.ن: ج1 ص 135.
67. وحي القلم، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت)، ج3 ص 339.
68. تاريخ آداب العرب ج1 ص ص 140-162.
69. م.ن: ج1 ص 140.
70. م.ن:ج1 ص 172.
71. م.ن: ج1 ص 171.
72. م.ن: ج1 ص 179.
73. م.ن: ج1 ص 175.
74. م.ن: ص.ن.
75. م.ن: ج1 ص ص 184-185.
76. م.ن: ج1 ص 179.
77. م.ن: ج1 ص 180.
78. م.ن: ج1 ص 184. نعتقد أن "الدخيل" هو من أهم وسائل تنمية اللغة من جهة، ومن أهم العناصر المساهمة في تقوية اللهجات وانتشارها من جهة أخرى، وهو من أبرز وجوه التلاقح بين اللغات والحضارات، كما سيأتي بيانه لاحقا.
79. م.ن: ص.ن.
80. م.ن: ج1 ص 186.
81. م.ن: ج1 ص 187.
82. م.ن: ج1 ص 189.
83. م.ن: ج1 ص 193.
84. م.ن: ج1 ص 196.
85. م.ن: ج1 ص ص 197-198.
86. م.ن: ج1 ص 200.
87. م.ن: ج1 ص 203. وراجع ملاحظتنا في الهامش 78.
88. م.ن: ج1 ص 207.
89. م.ن: ج1 ص ص 204-206.
90. م.ن: ج1 ص 207. إن هذه العبارة الأخيرة التي اقتبسناها من الرافعي تختزل ما نهضت به العلاقة بين تاريخ اللغة وتاريخ الحضارة من دور في توسع اللهجات العربية.
91. م.ن: ج1 ص ص 208-209.
92. م.ن: ج1 ص ص 209-210.
• الصور
- من الكاتب.