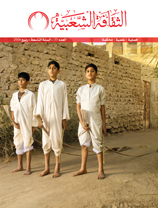«القربان البديل » طقوس المصالحات الثأرية في جنوب مصر
العدد 56 - فضاء النشر
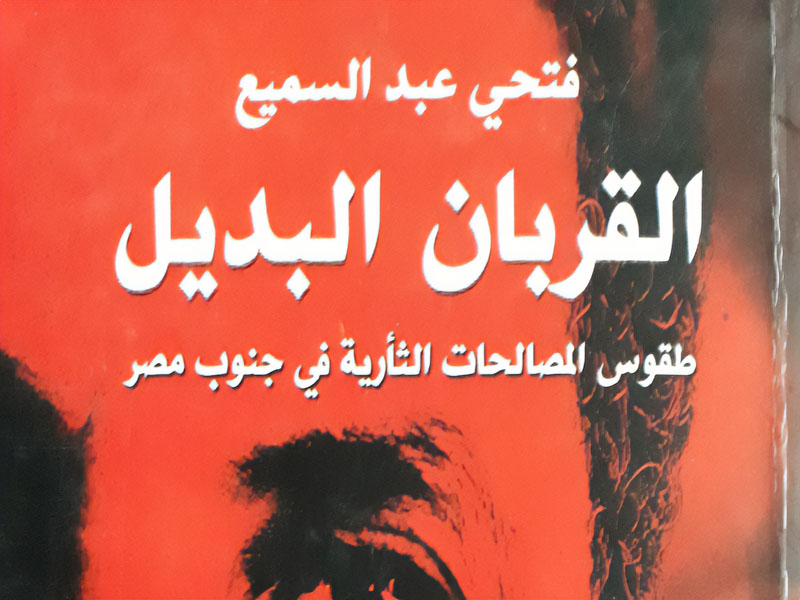
قراءة وتحليل: د. عباس عبد الحليم عباس - مصر
كثيراً ما لجأ الإنسان إلى العنف المضاد كوسيلة لردع العدوان، وقمع العنف، وكثيراً ما كان العنف المضاد وسيلة لمضاعفة المشكلة بدلاً من حلها . بجوار ذلك، قدَّم الإنسان منهجًا آخر لمواجهة العنف باللاعنف، وهذا المنهج راسخ في الثقافة الإنسانية لكنه بحاجة لمزيد من الاهتمام والترسيخ، خاصة أن مشكلة العنف تتفاقم بمنتهى الغرابة في عصرنا الحالي، الذي يقوم على العقلانية ويدَّعي انفصاله الهائل عن العصور الوحشية والبربرية .
في هذا الإطار، تأتي هذه الدراسة التي تحاول رصد وتحليل منهج اللاعنف في الثقافة الشعبية، كما يتجلَّى في فض الخصومات الثأرية، وقد اتخذت من الممارسات الثأرية في جنوب مصر ميداناً لها، الذي يَشتهر باتخاذ العنف المضاد وسيلة وحيدة للتصدي لمشكلة العنف، وتلك الشهرة تتجاهل منهجاً آخر يقوم على التصدي للعنف مِن خلال اللاعنف، وهو منهج فعَّال، يعبِّر عن الحِكمة والعقلانية، وقد تحققتْ مِن خلاله إنجازاتٌ اعتبرها مؤلف البحث الحالي ضخمة جدًّا، فَضَّتْ خصوماتٍ وتناحرات كثيرة، وحافظتْ على أرواح، وأوقفتْ سيلانَ دماء غزيرة .
ويُطلَق على ذلك المنهج اسم « ردم حفرة الدم» وهو يقوم على مجموعة كثيرة ومركَّبة مِن العناصر الطقسية تُعرَف باسم القودة .ويَكشِف طقس القودة عن أهم ملمح في منهج اللاعنف، وهو الصبر، وعدم اليأس، مهما كانت المُحبطات، وغالباً ما تكون تلك المُحبطات شديدة القسوة، خاصة في البداية، وبشكل يدعو لليأس فعلاً، لكن النهاية غالبًا ما تكون سعيدة جدًّا؛ فالعمل الهادئ والصبور والمتواصل، مهما كان بسيطًا، يؤدي إلى معجزات، وهذا درس مِن دروس القودة، ما أحوجَنا إليه في حياتنا الحالية !
يقول المؤلف : ربما أبدو مبالِغًا وأنا أصِف هذا النموذجَ الشعبي بالفذ، لكن هذا الوصف – في اعتقادي – أقل مِن المناسب لأكثر مِن سبب؛ فهو أولاً يواجه طبيعته الراسخة ويتمرد على نفسه؛ فالثبات أهم خصائص الطقوس بشكل عام، ووظيفته الأساسية هي تثبيت ممارسة معينة، والإبقاء على استمراريتها عبْرَ القرون؛ فالطقوس تَمنح الفعل الأول، والموغل في القِدَم، شبابًا متجدداً، وهي بخلاف الأساطير التي تعتمد على الجهد النظري؛ فتنتشر انتشاراً واسعًا، لكنها تَخفُت وتتحول مِن حكاية مقدسة إلى مجرد حكاية نقابلها بقدر من الاستخفاف أو حتى الاحترام، لكننا لا نستطيع تقديسها، أما الطقوس فلا تعتمد على الجهد النظري، بل على ممارسة دائمة، ويتسلمها الابن مِن الأب، والحفيد مِن الجد بشكل آلي لا انقطاع فيه، وهذا الثبات في تقديرنا عقبة هائلة، لا شك أن الحوار معها يُعد عملاً رائعًا على المستوى الفكري .
لكل ذلك وغيره، يوضح المؤلف كيف يبدو العكوف على دراسة طقس القودة أمراً مطلوبًا؛ لأنه يتعلق بممارسة شعبية حية، ومع ذلك نجد قصوراً شديداً في دراسته، وحسبنا قراءة عمل موسوعي عن العادات والتقاليد الشعبية دون أن نجد إشارة لهذا الطقس المهم، الأمر الذي شجع على المُضي قُدُمًا في تلك الدراسة .
والحقيقة أن طقس القودة يتسم ببناء معقَّد، ويحتوي على عناصرَ طقسية كثيرة، ويتداخل مع طقوس أخرى، كالطقوس التكفيرية، وطقوس الموت، والميلاد، والزواج، ورفع المكانة أو خفضها، أي أنه على المستوى الفني طقس ثري جدًّا، ونحن نتعجب من عدم دراسته حتى الآن .
بدأ الباحث في الفصل الأول بتعريف القربان وذِكْر أنواعه، مرورا بالقرابين الإنسانية في ثقافات مختلفة بهدف تقديم خلفية تساعدنا على استيعاب موضوع الدراسة بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بعمق الوجود القرباني في المسيرة البشرية وما تحويه الرموز من سلطة، والطقوس مِن فاعلية قوية، ثم انتقلت الدراسة إلى فحص علاقة القرابين بمفهومي الطهارة والنجاسة، وكذلك فكرة القربان الحيواني البديل، وعلاقة القرابين بمشكلة العنف وصلة الدم، ثم توقف المؤلف في النهاية أمام الأفكار القربانية التي تقف وراء الممارسات الثأرية .
وفي الفصل الثاني، بدأ بتعريف طقس القودة وتحديد السمات القربانية فيه، وتحديد العناصر الطقسية التي تقوم بدور القربان، وهي عناصرُ كثيرة، عمل على فصلها لتمييزها، وقام بتسميتها، وتناول تلك العناصر في ضوء ثنائية الثابت والمتغير، مع العبور على المؤثرات التي لعبت دوراً في التغيير، وما تكشف عنه من سمات العقلية الجنوبية، ولم يكن وصفه للعناصر الطقسية هو الهدف الوحيد، بل انصبَّ اهتمامُه على الرسالة الرمزية التي يحويها الخطاب الطقسي، ولمَّا كان الوصول إلى تلك الرسالة يتطلب الخلفية الثقافية المرتبطة بتلك العناصر؛ فقد حاول المؤلف إلقاء الضوء على تلك الخلفية، على أمل استيعاب الطقس بأكبر قدر ممكن، خاصة أن الخطاب الطقسي يعتمد على التلقي الحسي الذي يخاطب المشاعر، لا الأفكار النظرية المجردة .
أمـا الفصل الثـالث فقد خصصه لعلاقة الطقس بالهوية؛ فالطقوس ليست مجرد حاملٍ للهوية، بل هي تبني الهوية كما تغذيها باستمرار، وبدأ بتحديد هوية الطقس في إطار منظومة الطقوس الإنسانية، وجَــدارتـه كبناء طقس فريد في أن يحتل موقعاً متميزاً بين تلك الطقوس، لكنه للأسف لا يوجد في تلك المنظـومة بسـبب قصـورٍ مـن باحثينا أو مؤسساتنا البحثية، وكـأنه يجسـد – بشكل غير مباشر – إهمـال الجنوب، بل يدل وجوده بشكل مباشر على قصور شديد في دمج الجنوب في منظومة الدولة بشكل حقيقي أو سليم .
واستكمـل رحلة الـدراسة مع هوية الطقس بالبحث عن هويته الثقافية؛ حيث بدأ بهويته الإسلامية؛ نظراً لاحتوائه على مظاهرَ إسلامية كثيرة، رغم وجود حالات القودة عند المسيحيين، لكنها نادرة، وحاول توضيح طبيعة العلاقة بين الطقس والثقافة الإسلامية لبيان مظاهر اتفاقه واختلافه معها، وقد أفضى ذلك إلى وجود إشكاليات ثقافية ترتبط بحياتنا عموماً وتؤثر فيها، وكان تحليل الطقس مِرآة لها، كما تناول علاقة الطقس بثقافة العرب قبل الإسلام، انطلاقاً من شعور قوي في مجتمع القودة بانتمائه العربي، كما تناول علاقة الطقس بثقافة مصر القديمة، واكتشف أن جذوره الحقيقية ترجع إليها، وأن هويته مصرية، لدرجة القول، بشجاعة : إن القودة طقس مصري أصيل .
ثم نظر المؤلف فتحي عبد السميع بعد ذلك في الطقس بوصفه مرآة كاشفة، ووقف باختصار شديد عند الهوية العامة التي تظهر في صورة منظومة متناغمة، تندمج فيها الدوائر الإسلامية، والعربية، والمصرية، بشكل عجيب، ووقف بشكل خاص مع الهوية الخاصة، وهي الهوية الجنوبية، وكيف تظهر في الطقس حاملة خصوصية معينة، يظهر فيها الجنوبي كحارس لمجموعة معينة من القِيَم، مثل : الوفاء، والشهامة، والنخوة، وغيرها .. صحيح أن تلك القيم ليست خاصة بدائرة الجنوب، لكنها تَظهر من حيث الكيفية والدرجة كقِيَم خاصة جداًّ، والطقس يقدم لنا دليلاً دامغاً على تميُّز الجنوبي في التمسك بتلك الصفات، والحرص على ما تحمله مِن قيم معنوية سامية، ويكفي أنه يرفض الدية في مقابل العفو عن القاتل، رغم أن دينه يحللها، ورغم أنه في حالات كثيرة يبلغ من الفقر درجة تكون فيها قيمة الدية المادية حُلماً من الأحلام المستحيلة، لكنه يرفضها، ويقبَل أفعالاً رمزية يقوم بها القاتل في مقابل العفو عنه . وتلك الأفعال تعد بسيطة جداًّ في حساباتنا المنطقية، لكنها بالنسبة للجنوبي تعد مسألة حياة أو موت بالمعنى الصريح للعبارة .
كما يكشف طقس القودة عن علاقة الجنوبي بالدولة، وهي علاقة مأزومة للأسف، بل تعبِّر عن رفض صريح للسلطة؛ فالقانون نفسه مهمَّش، والسلطة المعنوية للشخصيات الجنوبية العامة أقوى من السلطة القضائية، ورفض دورِ الدولة في حل مشكلة القتل لا يعبِّر عن قصور هذا الدور فقط، بل يعد أيضاً وسيلة احتجاج ورفض، وهذا الرفض – كما سيذكر المؤلف في نهاية الكتاب – لا يتعارض مع الطبع الصبور والمتوارَث عبْر عصور القهر المتوالية، بل هو رفض فطري وماكر؛ فطري لأنه يرتبط بغريزة الحياة التي يهددها القتل، وماكر لأنه يتخذ من حدث القتل عصا يستند عليها وهو يعلن عدم اعترافه بالدولة .
وفي الفصل الرابع، حاول الكاتب أن يسهم في دعم فن المصالحات الثأرية، من خلال مناقشة ثنائية الثأر والتسامح، وتفنيد ما سماه «أسطورة التسامح المستحيل»؛ لأنها واسعة الانتشار، وهي تقوم على اعتقاد أن التسامح مستحيل، وتذكر كلمة الاعتقاد هنا لأن الشخص الذي يقول عبارة «التسامح مستحيل» يكون صادقًا مع نفسه عندما يقول تلك العبارة، ويعبر عن شعور داخلي حقيقي، ورغم حقيقة ذلك الشعور باستحالة التسامح، خاصة مع وقائع العدوان الكبيرة، وإن كان البعض يشعرون به في وقائع صغيرة أيضاً، فإن الحكم باستحالة التسامح ينتج عن خطأ في تحديد ذلك الشعور الذي يتركه العدوان، كما ينتج عن خطأ في ربط علاقة ذلك الشعور بالتسامح، ومن هذا الخطأ تنتج الأسطورة أو الفكرة السحرية التي تقول باستحالة التسامح، وهي فكرة سحرية لأنها تعتمد على منطق السحر، لا على المنطق العقلاني أو الموضوعي؛ فالسحر – كما هو معروف – علم كاذب، أما العلم الحقيقي فيقوم على الموضوعية والتمييز بين الأمور، والعدوان علينا بشكل عام يترك أثراً في نفوسنا، ويبلغ هذا الأثر حد المرض في بعض الحالات، كما هو الحال في المرض المعروف باسم «مشاعر ما بعد الصدمة»، وتلك المشاعر التي تتركها الصدمات معقَّدة، وقد تستمر حتى بعد زوال السبب؛ فشعورنا بآلام نتيجة قتل أحد أقربائنا، مثلاً، لا ينتهي حتى لو قتلنا القاتل، أو أسرفنا في القتل؛ فالمشكلة تظل قائمة في نفوسنا، خــاصــة أننــا نخلـص كثـيراً للمـوتـى، وتـلك المشـاعر معقــدة وتتطلــب قــدراً مــن الــوعــي والفن في التعامل معها .
وقد قام المؤلف بمحاولة للتمييز بين عدد من الأمور التي نخلط بينها فتظهر أسطورة التسامح المستحيل، كفكرة مهيمنة، وغير قابلة للنقاش في كثير من الأحيان، وقد اعتمد في ذلك التمييز على القرآن الكريم؛ حيث لاحظ المؤلف وجود عدد من الكلمات التي تاتي بعد عدوانٍ ما على محارم الله، عز وجل، وكل عدوان على إنسان عدوان على محارم الله، وتلك الكلمات هي : كظم الغيظ والغضب، والعفو، والصفح، والصفح الجميل، والغفران، والرحمة، والمحو، أي محو أثر العدوان نهائيًّا . وقد لاحظت أن تلك الكلمات ترد في القرآن الكريم بترتيب ثابت في كل الآيات؛ فالعفو يسبق الصفح، ويسبق الغفران، ويسبق الرحمة، وكأننا أمام محطات تفصل بينها مسافات بعيدة، وتظهر أسطورة التسامح من خلال وضع تلك المحطات البعيدة كلها في مكان واحد، وهنا يصيح المرء قائلاً: «التسامح مستحيل» بينما الشعور الذي يجعله ينطق بتلك العبارة لا علاقة له بالتسامح، بل بمحطة أخرى لاحقة قد تأتي بعد فترة طويلة، وقد تكون مستحيلة بالفعل؛ فمحو أثر العدوان نهائيًّا مستحيل، بل الغفران مستحيل، كما سيتضح، والصفح الجميل غاية في الصعوبة، والصفح صعب ويحتاج إلى زمن، أما العفو فهو سهل للغاية، وواقعي تمامًا؛ بدليل وجود حالات لا حصر لها لاُّناسٍ قاموا بالعفو عن القاتل، وهو من أكبر الأمور التي يعز فيها التسامح، وفي النهاية قمنا بوقفة سريعة مع حكاية قتل حمزة بن عبد المطلب وتحليلها وفق تلك الرؤية .
أمــا الفصـل الخـامس والأخـير فقــد وقــف المـؤلف فيه أمام عـلاقـة المـصـالـحـات الـثـأريـة بالفن، بـوصـفه مـن الـوسـائـل المـهمـة الـتي تـصنـع رقـي الأفراد والمجتمعات، وقد اعتبر المصالحات الثأرية فنًّا؛ فهي بوصفها تقوم على عناصر طقسية متعددة؛ فإنها تتضمن الفن بالضرورة، وكل الفنون خرجت من رحم الطقوس، كما أن قضاة الدم والأجاويد يتعاملون مع الخصومات الثأرية تعاملاً فنيًّا، وقد ينظر إلــى قــاضي الدم باعتباره فناناً بالــدرجة الأولــى، وكــذلك الأجــاويــد الــذيــن يعملــون معــه، بل هم أكــثر وعيـًا والــتزامًــا بطبيعة الفــن ورســالــته من هؤلاء الذين نطلق عليهم اسم الفنانين، ونقصد بهم الـذين يعملون فـي صناعة الأفلام والمسلسلات.
وأحد أهم أهداف الكتاب هو لفت انتباه الفنانين لحكمة الصعيدي وفنِّه، ويكفيه أنه يواجه القتل الثأري بالمصالحات الثأرية والتعامل مع موتورين يشعرون بالعار ويعانون مشاعر أليمة يُطالبون بتجاهلها، ولولا مهارة قضاة الدم والأجاويد الفنية لما تمكَّنوا من التعامل مع تلك المشكلة الصعبة والمعقدة، لكنهم يتجاوزون الصعاب بحيل فنية ، بينما نجد الأفلام والمسلسلات تهتم فقط بالقتل الثأري، ولا تهتم بالمصالحات الثأرية، رغم حاجتنا لها لدعم ثقافة التسامح في المجتمع العربي ككل، ومن هنا تطرق الكتاب لتناول الأعمال الفنية لظاهرة القتل الثأري، وكشف عن قصورها الفكري والفني معاً، واتخذ من فيلم «دماء على النيل»، للمخرج نيازي مصطفى، نموذجاً، وقام بتحليله تحليلاً ثقافيًّا، ونأمل أن يكون ذلك الكتاب قد نجح في لفت انتباه صناع الأفلام والمسلسلات لضرورة مواجهة القتل الثأري، عن طريق التركيز على المصالحات الثأرية، خاصة أنها تقدم مجالاً دراميًّا واسعًا، يمكن توظيفه في عدد كبير من الأعمال، التي يمكن أن تسهم في التكريس لثقافة التسامح، والتي تتعرض إلى تآكل أليم ينذر بعواقب وخيمة جدًّا؛ فوطن بلا تسامح وطن مفتت وقابل للضياع؛ فالتسامح يصنع الوحدة بين أفراد المجتمع، ووحدة الوطن لا تقوم إلا على وحدة أفراده، ومناخ التسامح وحده هو ما يشجع المجتمعات ويدفعها للرقي، وارتقاء المجتمع، والإنسانية عمومًا، يعتبر من غايات الفن الكبرى .